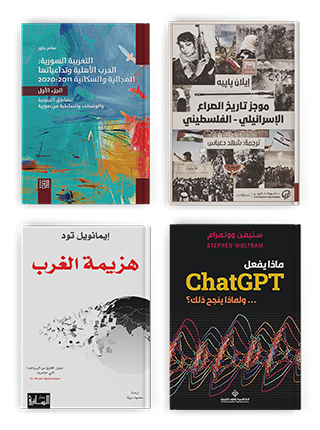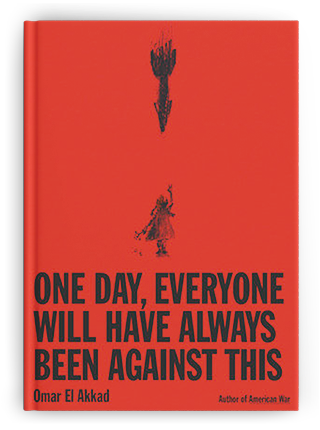يتناول كتاب "الحروب بالوكالة: التحوّل في ظاهرة الحرب في القرن الحادي والعشرين" الصعود المتسارع لنمط صراعي تُنقَل فيه أعباء الحرب، على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، إلى وكلاء بشريين أو تقنيين، كليًا أو جزئيًا، بدل الانخراط العسكري المباشر. كما يستعرض أشكال هذا التحوّل، من تسليح الجماعات المتمردة والاستعانة بالمرتزقة، إلى توظيف الطائرات المسيّرة والدعاية السيبرانية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في إدارة الصراع.
زين العابدين محمد[1]
تشهد الحروب في المنطقة العربية نموًّا مطّردًا في القدرات العسكرية والأدوار السياسية للتنظيمات المسلحة غير النظامية، بما يتحدّى احتكار الدولة التقليدي للعنف. ويتزامن ذلك مع تزايد توظيف القوى الإقليمية والدولية للتقانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. من هنا تبرز أهمية كتاب "الحروب بالوكالة: التحوّل في ظاهرة الحرب في القرن الحادي والعشرين"[2]، الصادر عام 2019 عن جامعة جورجتاون، بتحرير أندرياس كريغ وجان مارك ريكلي، في تفكيك وقراءة هذا المشهد المعقّد بالاستناد إلى مفهوم الوكالة (surrogacy) بوصفه مفهومًا أساسيًا جامعًا للمقاربات التي تناولت أشكال تفويض الراعي أعباء الحرب إلى قوى بديلة أو تكميلية، مثل الحرب بالوكالة (proxy warfare)، أو الحرب المركّبة (compound warfare)، أو الحرب عن بُعد (remote warfare).
يناقش الكتاب، على امتداد 243 صفحة موزعة على مقدمة وسبعة فصول وخاتمة، قضايا مهمّة ترسم صورة شاملة لطبيعة الحروب بالوكالة في العصر الحالي؛ مثل دوافع الدول إلى تبنّي هذا النمط من الحروب بكثافة في السنوات الأخيرة، وإشكاليات السيطرة والاستقلالية بين الراعي والوكيل وما يترتّب عليها من مسؤوليات أخلاقية، فضلاً عن بروز المنصّات التكنولوجية بوصفها فاعل وكيل في ساحات الحروب الحديثة.
العودة إلى الوراء: حروب حديثة بطابع قديم
كيف يمكن فهم التحوّلات التي تشهدها الحروب في العصر الحالي؟ قد يبدو الجواب بسيطًا للوهلة الأولى، إذ يعزو البعض هذه التغيّرات إلى التطوّرات التكنولوجية، غير أن أبسط الظواهر كثيرًا ما تكون أعقدها. في هذا السياق، يقدّم الكتاب إجابته مستندًا إلى مقولة كلاوزفيتز: "إن قلّة قليلة من المظاهر الجديدة في الحرب يمكن إرجاعها إلى اختراعات أو أفكار حديثة؛ فهي تنجم أساسًا عن تحوّلات المجتمع والظروف الاجتماعية المستجدّة."[3]
انطلاقًا من هذا التصوّر، يتبنّى الكتاب منظور "الثورة العسكرية–الاجتماعية" للبحث في الأسباب لا في الأعراض، ومحاولة رؤية الغابة كاملة بدل الاكتفاء بأشجارها المتفرّقة؛ إذ ينظر إلى الحرب بوصفها ظاهرة اجتماعية–سياسية معقّدة، وأيّ تحوّل جذري في طبيعتها إنما يعكس تفاعلها مع التحوّلات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على المجتمعات.[4]
يُعدّ كلاوزفيتز من أبرز المفكرين العسكريين الذين صاغوا نموذج "الثالوث"، الذي جمع بين الدولة والمجتمع والجندي–المواطن، ليعكس طبيعة الحرب في القرن التاسع عشر بوصفها تعبيرًا عن الواقع الاجتماعي والسياسي في ذلك الوقت. وقد شكّلت مفاهيم مثل سيادة الشعب، التي أقرتها الثورة الفرنسية، وسيادة الدولة، ومبادئ العقد الاجتماعي، أساس هذا النموذج؛ فالدولة وفق تصورات العقد الاجتماعي ملزمة بتوفير الأمن للمجتمع، ولتحقيق ذلك تُفوَّض مهمة الأمن لوكيل من النسيج الاجتماعي للدولة، وهو قطاع الأمن النظامي. وبذلك، كانت إدارة العنف وممارسته محصورة في يد الدولة للدفاع عن أراضيها ومصالحها الوطنية، وهو ما أشار إليه ماكس فيبر في تعريفه للدولة.
يتتبع المؤلفان خُطى كلاوزفيتز لتفسير ظاهرة الحروب بالوكالة في القرن الحادي والعشرين، ويؤكدان أنها ليست أمرًا ثوريًا بحد ذاته؛ إذ استخدمتها الإمبراطوريات والدول عبر التاريخ لتحقيق أهدافها. غير أن ما يميّزها في العصر الحالي هو طابعها الهجين، إذ تلجأ الدول إلى تفويض عبء الحرب لوكلاء بشريين أو تكنولوجيين عابري الحدود، يزاحمونها في توفير الأمن. ومن هذا المنظور، يُجادل الكتاب بأن ثالوث كلاوزفيتز لم يفقد صلاحيته، كما حاجج فان كريفليد في أطروحته "التحول في الحرب"،[5] بل إن عناصره الأساسية ما زالت موجودة بشكل أو بآخر. وما تغيّر هو الفاعلون، مما أدى إلى تشكّل ثالوث جديد يعكس طبيعة المشهد الاجتماعي–السياسي المتفكك في مطلع القرن الحادي والعشرين، الذي وصفه هيدلي بول بأنه "عصر إقطاعي جديد"[6].
بناءً على ما سبق، يطرح الكتاب حُجّة مفادها أن السياق المعولم المضطرب والفوضوي هو ما يدفع الدول العظمى والصغرى على حد سواء إلى خوض الحروب بالوكالة؛ إذ تتيح لها الانخراط في الحروب طويلة الأمد ضد تهديدات ومخاطر غير ملموسة، غالبًا على الحدود، بكلفة أقل وبعيدًا عن رقابة الرأي العام والانفعالات الشعبية. ويُعدّ هذا النهج بمثابة إحياء لنموذج الحروب المحدودة الذي ساد قبل حروب الثورة الفرنسية، والتي فصلت بين المجتمع والمجهود الحربي[7].
وتتجلى أهمية الأفكار المطروحة في استقراء واقع الحروب في المنطقة العربية؛ فعلى سبيل المثال، اعتمدت الولايات المتحدة على مزيج من الوكلاء المحليين البشريين في العراق وسوريا، إضافةً إلى الوكلاء التقنيين مثل الطائرات المسيرة، في حربها ضد داعش عام 2014، مما قلّل من الكلفة البشرية والمالية عليها. وهو نهج اتبعته إسرائيل في حرب غزة الحالية، حيث استعانت بميليشيات محلية من غزة، أبرزها "القوات الشعبية" التي يقودها ياسر أبو شباب، إلى جانب استخدام الروبوتات لتخفيف العبء عن قوات الاحتلال.
كما استخدمت الدول الصغرى الحروب بالوكالة كأداة من أدوات القوة. فعلى سبيل المثال، اعتمدت الإمارات على المرتزقة والمتعاقدين العسكريين في عملياتها في القرن الإفريقي واليمن. ويكشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن كيفية تورط الإمارات في توظيف مرتزقة وميليشيات للقيام باغتيالات سياسية في اليمن، وهو ذات النهج الذي اتبعته في دعم ميليشيات "الدعم السريع" في حرب السودان، وكذلك ميليشيات حفتر في ليبيا.
للعنف أوجه عديدة: التكنولوجيا كوكيل في الحروب الحديثة
بالارتباط مع ما ذُكر سابقًا حول التغيرات في السياق الاجتماعي–السياسي لحروب القرن الحالي، يُسلط الكتاب الضوء على التحوّلات التي طرأت على مفهوم "العنف" في الحروب نتيجة توظيف السلاح السيبراني والذكاء الاصطناعي كوكلاء في الحروب الحديثة. إذ يوسع الكتاب مفهوم كلاوزفيتز عن الحروب بوصفها "عملًا من أعمال العنف يهدف لإجبار الخصم على تنفيذ إرادتنا" ليشمل، بجانب القوة المسلحة التقليدية، أي قوة ذات تأثير استراتيجي تعطيلِيّ أو تدميري على الخصم.[8]
يمنح السلاح السيبراني قدرة هائلة على إحداث اضطرابات في الشبكات الحيوية للبنى التحتية العسكرية والمدنية من خلال البرمجيات الخبيثة، مع تحقيق قابلية الإنكار المعقول. فعلى سبيل المثال، في عام 2009، استخدمت إسرائيل برنامج (Stuxnet) لتعطيل أكثر من 10% من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية. كما برزت قوته بوضوح في سياق استخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات التحريض والتلاعب بالجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا في سياقات التمرد ومكافحته. فقد وفّرت هذه الأدوات للمتمردين وسيلة لنشر سردياتهم إلى قاعدة جماهيرية عالمية بسرعة أكبر وتكاليف أقل، فضلًا عن كونها أداة لتجنيد الأفراد عبر الحدود. ويُجسّد تنظيم داعش مثالًا بارزًا لذلك، حيث نقل أنشطته إلى الفضاء السيبراني، معتمدًا على تطبيقات مشفرة مثل "تيلغرام" ووسائل التواصل الاجتماعي بوصفها بديلًا لنشر سردياته وتوسيع صداها.
يُوضح الكتاب كذلك الجانب المادي للعنف الذي تجسّده التكنولوجيا، والمتمثل في استخدام الطائرات المسيرة، التي تُعد أول وكيل حقيقي في مجال الأسلحة بعيدة المدى. إذ تُطلق هذه الطائرات من مسافات آمنة، مما يسمح بالإفلات من النيران المضادة، وتجمع بين مزايا البعد والوقاية والدقة والمرونة، ما يجعلها فعّالة في مواجهة أعداء غير تقليديين.
استخدمت إسرائيل والولايات المتحدة الطائرات المسيّرة على نطاق واسع في إطار استراتيجية "قطع الرأس"، أي استهداف قادة التنظيمات للقضاء عليهم. ومن ذلك اغتيال إسرائيل للأمين العام الأسبق لحزب الله، عباس الموسوي، عام 1992، إذ تعقّبت طائرة مسيّرة حركة سيارته، مما سهّل استهدافه بواسطة طائرة مروحية، وكذلك اغتيال الولايات المتحدة كلاًّ من محمد عاطف عام 2001، وأيمن الظواهري عام 2022. كما كثّف فاعلون من غير الدول، مثل حزب الله والحوثيين، استخدام هذه المسيّرات في مجالات الاستطلاع والهجوم، وهو ما برز خلال حرب غزة الحالية؛ حيث نجح حزب الله في تنفيذ العديد من الخروقات للمجال الجوي الإسرائيلي لجمع المعلومات الاستخبارية وتوجيه ضربات في العمق، ولعل أبرزها محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في منزله في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بواسطة طائرة مسيّرة.
انقلاب السحر على الساحر: كيف تُشكل الحرب بالوكالة عبئًا على الراعي؟
بالرغم من أن الحروب بالوكالة تُطرح أحيانًا بوصفها حلًا سحريًا للدول لمواجهة المخاطر، إلا أنها ليست دائمًا كذلك؛ فتفويض عبء الحرب لا يعني فقط تنازل الدولة عن احتكارها للعنف، بل يشمل أيضًا السيطرة على الوكيل ومنحه درجة من الاستقلالية، وهي سمة ضرورية تميّزه عن علاقة الجندي النظامي بالدولة، التي تخضع لنظام قيادة وسيطرة هرمي صارم.
يشير الكتاب إلى أن معضلة السيطرة والاستقلالية تنشأ من طبيعة العلاقة الصفرية بين الراعي والوكيل؛ إذ يسعى الراعي لتعظيم سيطرته، بينما يسعى الوكيل، خاصة البشري، إلى الاستقلالية. ويعزز من ذلك غياب الروابط والقيم المشتركة بينهما وغياب آليات السيطرة الفعّالة على الوكيل، ما ينتج عنه عبء أكبر على الراعي، مثل عدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، أو تحقيقها بوسائل غير فعالة أو غير أخلاقية أو غير قانونية، أو حتى إساءة استخدام الموارد أو السلطة الممنوحة للوكيل لتحقيق أهداف خاصة منفصلة عن أهداف الراعي.
وتُعدّ سياسية "العصا والجزرة" الآلية الوحيدة التي يستطيع من خلالها الراعي التأثير في سلوك الوكيل، لكنها ليست فعّالة طوال الوقت، نظرًا للطبيعة الديناميكية للعلاقة بينهما. ومثال على ذلك، بعد أن نجحت الولايات المتحدة في إسقاط حكم طالبان عام 2001، ابتعد الكثير من زعماء القبائل الذين اشترت أمريكا ولائهم بملايين الدولارات عن الاستمرار في خوض حرب ضد تنظيم القاعدة، لكونه لم يكن تهديدًا مباشرًا للكثير منهم، ما مكّن أسامة بن لادن من الفرار إلى جبال أفغانستان الشمالية.
عطفًا على ما سبق، تضع الحروب بالوكالة عبئًا أخلاقيًا على الراعي، لا سيما من ناحية شرعية هذا النمط من الحروب المتميزة بالسرية وانتهاك سيادة الدول. فضلاً عن ذلك، فإن دعم وتسيلح الوكلاء المحليين يترتب عليه زعزعة الاستقرار والوقوع في دائرة مفرغة من العنف، وارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب ضد المدنيين، مما يُحمّل الراعي مسؤولية تلك الانتهاكات وفق قوانين النزاعات المسلحة. ولعل ارتكاب وكلاء إيران لجرائم حرب في سوريا والعراق خير دليل على ذلك.
تشمل المناقشة السابقة أيضًا الوكلاء التكنولوجيين، لا سيما في ظل صعود أنظمة الأسلحة الذاتية، ومدى استقلاليتها عن المشغل البشري، وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وأخلاقية وفقًا لقوانين النزاعات المسلحة. وفي حالة الأسلحة المُستخدمة حاليًا، هناك إشراف بشري صارم على تلك الأسلحة، مثل الطائرات المسيرة والروبوتات، وبالتالي يتحمّل المشغّل المسؤولية عن القتل البشري الناجم عن استخدامها، ولا يُعفي البعد الجغرافي للمشغّل وقيادته عن ساحة العمليات من هذه المسؤولية القانونية والأخلاقية.
النموذج الإيراني في الحروب بالوكالة
يتطرق الكتاب إلى النموذج الإيراني في الحروب بالوكالة بوصفه فريدًا مقارنة بنظيره الغربي؛ فمن حيث العلاقة بين الراعي والوكيل، تمكنت إيران من إدارة معضلة السيطرة والاستقلالية بكفاءة من خلال نهج مغاير عن العلاقات التقليدية القائمة على المكافآت والعقوبات. فقد اعتمدت على الوسائل التحويلية المتمثلة في الإلهام الفكري والأيديولوجي القائم على مبادئ الثورة الإسلامية، مثل نصرة المظلومين وحكم ولاية الفقيه، مع مراعاة هوية وكلائها المحليين ودمجها في سردية الثورة. وعلى سبيل المثال، فإن أعضاء حزب الله لا يرون أنفسهم مجرد عملاء لإيران، بل يؤكدون على الهوية اللبنانية والعربية للتنظيم، الأمر الذي منح إيران نفوذاً واسعًا على هذه التنظيمات.
تتمثل الميزة الثانية في أن إيران تعتمد الحروب بالوكالة بوصفها جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها في الردع والدفاع، ويُعزى ذلك إلى الظروف المضطربة التي أحاطت بالثورة منذ بدايتها، والتي كانت أمنية بالأساس، إذ ساد الخوف من اندلاع ثورة مضادّة أو حدوث تدخل خارجي، لا سيما في أعقاب أزمة الرهائن ومحاولات الإنقاذ، ما رسّخ لدى القادة قناعة متزايدة بضرورة تصدير الثورة إلى الخارج.
ولتحقيق هذا الهدف، عملت إيران على بناء شبكات من الوكلاء تُحاكي في هيكلها القيادي وتكتيكاتها الحرس الثوري الإيراني، الذي يتمتع بدرجة من اللامركزية والاستقلالية، وله قاعدة اجتماعية وثقافية واسعة في البلاد، ويعتمد على ما يُعرف بـ"الدفاع الفسيفسائي"، أي خوض الحرب عبر شبكات من الوحدات العسكرية الصغيرة والمرنة التي تعمل باستقلالية عن القيادة الاستراتيجية. وقد برزت هذه الميزة بوضوح في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله؛ فبالرغم من اغتيال معظم قيادات الحزب، أشارت تقارير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى أن قواته ما تزال منضبطة وتعمل بقدر كبير من الاستقلالية في مواجهة القوات الإسرائيلية، من دون الحاجة إلى اتصال دائم بسلسلة القيادة.
أنشأ الحرس الثوري أيضًا ميليشيات على نموذج "الباسيج"، الذي يقوم على قيادة لامركزية وتدريب أساسي على القتال الحضري. ففي سوريا، تحوّل "الجيش الشعبي" إلى العمود الفقري لقوات نظام الأسد، إذ ضمّ أكثر من 42 جماعة و128 وحدة محلية، معظم أفرادها من المتطوعين الشيعة والعلويين والمسيحيين. ومع هجوم تنظيم داعش في العراق عام 2014، نقل فيلق القدس هذا النموذج إلى العراق من خلال إنشاء "الحشد الشعبي"، الذي تلقّى التدريب والتسليح والتمويل مباشرة من إيران.
خاتمة
تبرز قوة الكتاب في تقاطعه مع أطروحات أولريش بيك[9] وكرستوفر كوكر[10] حول "مجتمعات المخاطر"، وفهمه العميق لمقولة كلاوزفيتز: "لكل عصر نوعه الخاص من الحروب"، إذ أعاد توظيف أفكاره ضمن هذه الأطر بما أتاح رؤية معرفية جديدة تتجاوز النموذج التقليدي للحروب بالوكالة الذي ظل أسير تصوّرات أدبيات الحرب الباردة، ولا سيما في سياق المنطقة العربية المُعقّد.
يمكن القول إن أبرز أوجه القصور في الكتاب تركيزه على الجانب الأمني للحروب بالوكالة؛ فالحرب، بوصفها استمرارًا للسياسة بوسائل أخرى، لا تقتصر على تحقيق الأهداف الأمنية على المستوى الاستراتيجي، بل تشمل كذلك توظيفها لتعزيز النفوذ الإقليمي، على سبيل المثال لا الحصر. وتُعَدّ إيران نموذجًا واضحًا في هذا الصدد؛ إذ تطرق الكتاب فقط إلى الدافع الأمني وراء تبنّيها هذا النهج، متجاهلًا أنه شكّل أيضًا وسيلة لإعادة تشكيل ميزان القوى الإقليمي لصالحها، وتعزيز نفوذها في دول عربية مركزية مثل العراق وسوريا.
أما الملاحظة الثانية فتتعلق بإغفال الكتاب لحالات تفويض عبء الحرب إلى وكلاء محليين داخل الإطار الوطني لمواجهة التهديدات. ومن ذلك، على سبيل المثال، اعتماد نظام البشير في السودان على قوات الدعم السريع لمواجهة تمرد دارفور،[11] أو اعتماد النظام المصري في حربه ضد تنظيم داعش في سيناء على ميليشيات "اتحاد قبائل سيناء".