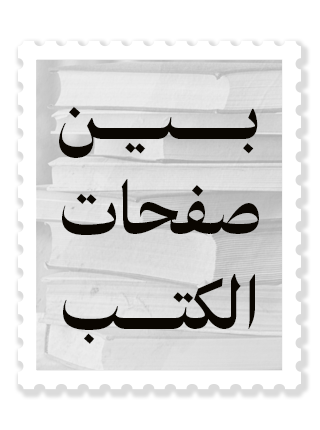يقدّم دومينيك فيدال، في كتابه "خطيئة إسرائيل الأصلية: المؤرّخون الجدد الإسرائيليّون يعيدون النظر في طرد الفلسطينييّن"، دراسة معمقة لما يطلق عليه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، مستندًا إلى أعمال المؤرخين الإسرائيليين الجدد، مثل بني موريس وآفي شلايم وإيلان بابه. يفضح الكتاب الأساطير المؤسسة للدولة الإسرائيلية، ويكشف عن الخطط الممنهجة لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، مسلطًا الضوء على حقيقة الأحداث بعيدًا عن الدعاية الرسمية، ومؤكدًا على حق الفلسطينيين التاريخي في العودة وتقرير المصير.
علي أبو هواش[1]
يوثق المؤرخ دومينيك فيدال، الفرنسي اليهودي المعارض للصهيونية والذي عمل صحافيًا في عدد من الجرائد الشيوعية والتحق بالمجموعة الدائمة لجريدة لوموند الفرنسية متخصصًا في شؤون الشرق الأوسط، من خلال كتابه "خطيئة إسرائيل الأصلية: المؤرّخون الجدد الإسرائيليّون يعيدون النظر في طرد الفلسطينييّن"[2] نقده للحركة والدولة الصهيونية، محاولًا كشف السرية التي اعتمدتها الدولة منذ قيامها وحتى اليوم.
وقد خصص فيدال كتابه لما حصل خلال النكبة وقبلها وبعدها، بدءًا من صدور قرار تقسيم فلسطين بين السكان الأصليين والمهاجرين اليهود وصولًا إلى الهدنة، مستندًا في ذلك إلى أعمال مجموعة من المؤرخين الإسرائيليين الجدد، من بينهم بني موريس وإيلان بابه. يعرض الكتاب ما كتبوه عن خطط الاحتلال الإسرائيلي لطرد الشعب الفلسطيني بين عامي 1947 و1948، كما يفند الأساطير المؤسسة للكيان الصهيوني واحدة تلو الأخرى.
فما بين خطة تقسيم فلسطين التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 وهدنة عام 1949 في أعقاب الحرب الإسرائيلية-العربية عام 1948، رحل مئات الآلاف من الفلسطينيين عن الأراضي التي احتلتها إسرائيل، تاركين منازلهم من أجل النجاة بحياتهم. وقد اعتبر المؤرخون الفلسطينيون والعرب هذا الواقع، كما أكدوا دائمًا، نتاج مخطط إسرائيلي ممنهج يقضي بطرد السكان الأصليين بشتى الوسائل، وأعنفها. وأوضح هؤلاء المؤرخون أن الغالبية العظمى من اللاجئين، الذين يُقدَّر عددهم بين 700 ألف و900 ألف، أُجبروا على المغادرة خلال المواجهات الإسرائيلية-الفلسطينية بعد الثورة الفلسطينية عام 1936، ثم خلال الحرب الإسرائيلية-العربية عام 1948، التي شهدت وقوع مجازر عديدة. وتلك هي الأطروحة التي دافع عنها مؤرخون فلسطينيون بارزون مثل وليد الخالدي ونور مصالحة وإلياس صنبر وغيرهم.
على النقيض من ذلك، ووفقًا للتأريخ الإسرائيلي التقليدي، فرّ معظم اللاجئين طوعًا استجابةً لنداءات القادة الذين وعدوهم بالعودة السريعة بعد النصر. ولم يقتصر هذا الرأي على إنكار التخطيط المسبق لعملية الإخلاء من قبل رؤساء الوكالة اليهودية وحكومة إسرائيل، بل إن المجازر، وعلى رأسها مذبحة دير ياسين في 9 نيسان/ أبريل 1948، كانت نتيجة أفعال القوات الفرعية المتطرفة التابعة لمنظمة إرغون بزعامة مناحيم بيغن ومنظمة ليحي بزعامة إسحق شامير، مما يُبرئ بهذا السرد القيادة الصهيونية التقليدية من الدم.
ولكن في النصف الثاني من الثمانينيات، تغيّرت السردية التاريخية وظهر ما يُعرف بـالمؤرخين الإسرائيليين الجدد، مثل سمحا فلابان، توم سيغيف، آفي شلايم، إيلان بابيه، وبيني موريس. وبعيدًا عن اختلافاتهم في الموضوع والمنهج والرأي، كان ما يجمعهم هو انتقادهم للأساطير المؤسسة لتاريخ إسرائيل، وتنقيحهم بشكل خاص أساطير الحرب الإسرائيلية-العربية الأولى، مما أسهم في إعادة ترسيخ الحقائق حول الاحتلال وحول هجرة الفلسطينيين، جزئيًا على الأقل، بما يكفي لتغيير التصور السائد عن ما حصل.
تفكيك أساطير إسرائيل
انطلاقًا من هذا النقد، يهدم الكتابُ مجموعةً من الأساطير التي قامت عليها الرواية الصهيونية لتأسيس إسرائيل، مستندًا إلى أعمال المؤرخين الجدد. وهي الأساطير التي خدمت الدعاية الصهيونية وسُخِّرت لسلب الفلسطينيين حقوقهم التاريخية طوال خمسةٍ وسبعين عامًا، من حقّ العودة وتقرير المصير، إلى الحقّ في الوجود والمقاومة والتاريخ والإرث.
وكانت أولى هذه الأساطير أسطورة "داود في مواجهة جليات"، التي أثبت المؤرخون بطلانها، مؤكدين من خلال الوثائق أنّ التفوّق كان في صالح القوات الإسرائيلية من حيث العدد والتسلّح والتدريب والتنسيق والدوافع، باستثناء المرحلة الوجيزة الممتدة من أيار/ مايو إلى حزيران/ يونيو 1948، التي شكّلت استثناءً محدودًا. ويُشار في هذا السياق، إلى الغياب الكامل لأيّ خطة متجانسة لدى الجيوش العربية لاسترداد الأرض، إذ لم تُبذل حتى محاولة لوضعها. أمّا الخطة الاستراتيجية المزعومة التي وضعتها جامعة الدول العربية فكانت من إعداد هواة بعيدين كلّ البعد عن مفهوم الاحتراف، ولم تكن، بلغة العسكر، خطةً بأيّ شكل من الأشكال. وقد برهن الساسة العرب على الهشاشة ذاتها في الأداء العملي، إذ جاء أداؤهم الباهت متطابقًا مع أداء العسكريين؛ فبينما انشغل السياسيون بالتشدّق بإعلان حقوق العرب دون مراعاة ميزان القوى، انصرف الضباط إلى مصالح واعتبارات سياسية على حساب مهامهم الحقيقية.
يُضاف إلى هذا التفوّق العسكري تفوّقٌ آخر على الصعيد السياسي والدبلوماسي تمثّل في الدعم الأمريكي المستمر منذ نشأة الدولة الإسرائيلية حتى اليوم، وهو تأييدٌ أعمى لكلّ ما تفعله إسرائيل في غزة وفي عموم فلسطين. كما أشار فيدال إلى أنّ علاقة إسرائيل بالاتحاد السوفييتي آنذاك لم تكن أقلّ متانةً من علاقتها بالولايات المتحدة؛ إذ كان دعم موسكو العسكري الكبير، عبر تشيكوسلوفاكيا، من أهمّ العوامل التي أثّرت في مسار الحرب. فقد ظنّ ستالين أنّ بدعمه العصابات الصهيونية يُسهم في تسريع انهيار الإمبراطورية البريطانية ودفعها إلى السقوط، في ظلّ غياب أيّ قوةٍ عربيةٍ منظّمةٍ قادرةٍ على الاستقلال بعد ثورة 1936 التي قضى عليها الانتداب بأعنف وسائل القمع.
كما يشير الكتاب إلى الاتفاق السري الذي عُقد في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، أي قبل اثني عشر يومًا من صدور قرار التقسيم في الأمم المتحدة، بين غولدا مائير وملك الأردن عبد الله الأول. وهو اتفاق لا يمكن فهم أحداث تلك المرحلة من دونه، كما ينقل الكاتب عن آفي شلايم، الذي وثّق هذا الاتفاق في كتابٍ منفصل، مبيّنًا أنه شكّل ضمانةً استراتيجية لإسرائيل، إذ تعهّد بموجبه "الجيش العربي" – الوحيد الذي يمكن اعتباره جيشًا نظاميًّا آنذاك – بعدم تخطّي حدود الأراضي المخصّصة للدولة العبرية، مقابل إمكانية ضمّ الأراضي الممنوحة للدولة العربية.
وفي الواقع، حلّ هذا التصوّر مكان مشروع التقسيم عند توقّف المواجهات، إذ استولى الأردن على الضفة الغربية وضمّها إلى أراضيه، باستثناء المناطق التي احتلتها إسرائيل، والتي زادت مساحتها إثر ذلك بنحو الثلث. كما ضمّت مصر قطاع غزة في حينه ورفضت التخلّي عنه لصالح الأردن أو إسرائيل.
ويسقط الكتاب أيضًا أحد أخطر الادعاءات وأكثرها رسوخًا في الوعي العام، وهو الادعاء القائل إن العرب هم من أعاقوا عملية السلام. ففي مؤتمر لوزان الذي دعت إليه لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، أظهرت إسرائيل في بادئ الأمر شيئًا من الانفتاح، إذ رغبت في ضمان قبولها عضوًا في الأمم المتحدة، فوافقت على توقيع بروتوكول مع جيرانها يؤكد في آنٍ واحدٍ مشروع التقسيم وحقّ العودة للاجئين. غير أنها، ما إن قُبلت عضوًا في المنظمة الدولية، حتى تنكّرت لما اتُفق عليه، وعطّلت تنفيذ قرارَي التقسيم وحقّ العودة.
الترحيل القسري وتدمير القرى: سياسة ممنهجة
أما بخصوص الأسطورة القائلة برحيل الفلسطينيين طوعًا، فيوضح دومينيك فيدال، استنادًا إلى ما نشره بيني موريس، أنه لا توجد أي وثيقة في الأرشيف الصهيوني تؤكد فرضية الدعوة العربية أو الفلسطينية إلى الفرار. وما حصل من هجرة طوعية، التي لم تتجاوز نحو ثمانين ألفًا، كان أساسًا بين الأثرياء والميسورين وأبناء الطبقة البرجوازية المدنية الذين اختاروا الهجرة على المواجهة. أما غالبية الفلسطينيين المهاجرين، فلم يكن خيارهم طوعيًا، بل فرضت عليهم المجازر المتتالية اللجوء المؤقت الذي دام سبع وسبعين سنة.
وقد أكدت وثائق الاستخبارات الإسرائيلية، التي تناولها الكتاب، هذا الواقع، إذ قدرت عدد المهاجرين بنحو 400 ألف فلسطيني مصنفين إلى أقسام: 55% هاجروا بفعل عمليات الهاغاناة، و15% نتيجة عمليات الإرغون وليحي وغيرها من التنظيمات الإرهابية الفرعية، و22% هربوا خوفًا وذعرًا وبسبب أزمة الثقة في النظام العربي والقيادة الفلسطينية آنذاك. وبذلك، فإن الهجرة المستندة إلى الدعوات العربية للخروج لم تتجاوز 5% فقط من إجمالي من غادروا أراضيهم، مما يسقط هذه الأسطورة التي يروج لها الاحتلال منذ قيامه، كما يسقط معها شعارات الجيش "الأكثر أخلاقية في العالم" وشعارات أخرى زائفة عن طهارة السلاح، الذي لم يوفر المدنيين من رجال ونساء وأطفال في مجازر القرى والأرياف، أشهرها دير ياسين والدوايمة وقرية الشيخ، ولا تزال تلك المذابح مستمرة في غزة، بما فيها جباليا وخان يونس ورفح وغيرها من بلدات القطاع.
وينبه الكاتب مرارًا إلى أن نوايا الطرد الصهيونية كانت واضحة، أبرزها عملية ترحيل قسري لنحو 70 ألف فلسطيني من أهالي اللد والرملة في تموز/ يوليو 1948، أي نحو 10% من سكان فلسطين الذين هاجروا آنذاك، مع عمليات إعدام ونهب شملت المدنيين. وحدث ما يشبه ذلك في الجليل شمالًا والنقب جنوبًا. ويؤكد الكاتب أن "خطيئة إسرائيل الأصلية" كانت خططًا لها أسماء وخرائط ومنفذون، منها عملية "داني" و"داليت" و"يفتاح" و"نحشون"، وغيرها، وهو ما أكده الأرشيف الصهيوني بعد فتحه إثر قانون الثلاثين عامًا عام 1978.
وتبع ذلك التهجير سياسة ممنهجة لتدمير القرى العربية ومنع السكان من العودة، مع مصادرة أراضيهم وممتلكات الغائبين، ما مكن الاحتلال من الاستيلاء على 73 ألف وحدة سكنية، و300 ألف هكتار من الأراضي والمزارع، وتوطين نحو 660 ألف مستوطن خلال أربع سنوات من النكبة، ليحلوا محل الفلسطينيين ويحتلوا عالمهم.
وقد خصص الكاتب فصلًا لمن أسماه "المهجر الأكبر"، رئيس الوزراء الأول لإسرائيل، دايفيد بن غوريون، الذي على الرغم من كل الحقائق السابقة، كان يعلن بوقاحة أن "إسرائيل لم تطرد عربيًا واحدًا"، بينما هو من أشرف شخصيًا على العمليات العسكرية والسياسية والدبلوماسية بين 1947 و1949، أي أنه المخطط والمنفذ لإجراءات تهجير الفلسطينيين ومنع عودتهم.
ويفرد الكتاب فصلًا أخيرًا لردود المؤرخين الصهاينة التقليديين على ما نشره المؤرخون الجدد، مؤكدًا أن النقد الأكبر لهم كان عدم استعانتهم بالمصادر العربية المكتوبة أو الشفوية، والتي كانت لتسد الثغرات وتوثق جميع مراحل النكبة من التقسيم إلى الهدنة، مع الأسباب التي دفعت الفلسطينيين إلى الفرار بأرواحهم وأطفالهم، بدل الاعتماد فقط على ما وثّقته العصابات الصهيونية، وهو ما يعكس، رغم أهميته، صورة واحدة أرادها المنتصرون تطمس الضحية وسرديّتها.
يكتسب هذا الكتاب أهميته ليس لأنه يهدم الأساطير الصهيونية فحسب، بل لأنه يساعد المناضلين من أجل حرية الشعب الفلسطيني وقيام دولته على فهم المشروع الصهيوني وأدواته وأسباب نشأته واستمراره، كما يدعمهم في إثبات الحق التاريخي للفلسطينيين في الأرض والبحر والسماء، من رأس الناقورة إلى أم الرشراش.