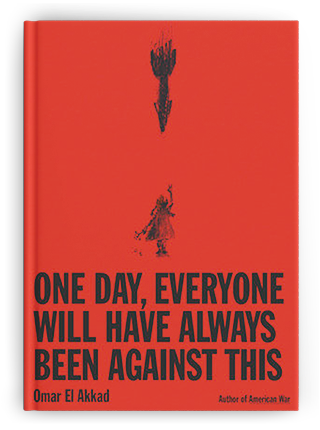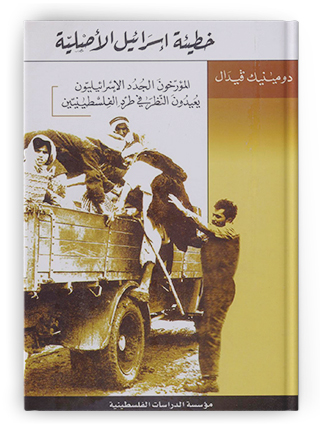تُقدّم فاطمة الصمادي في كتابها "إيران وحماس: من مرج الزهور إلى طوفان الأقصى – ما لم يُروَ من القصة" قراءة تحليلية شاملة لمسار العلاقة بين إيران وحركة حماس منذ بداياتها في التسعينيات وحتى أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. يستند الكتاب إلى شهادات مباشرة ووثائق أرشيفية ليكشف كيف تشكل هذا التحالف بين عقيدتين مختلفتين ومصلحتين متقاطعتين، في ظل تحوّلات إقليمية متسارعة. وبينما يتتبع تطورات العلاقة من مرج الزهور إلى طوفان الأقصى، يفكك الكتاب التناقضات التي تحكم توازن القوى بين المصلحة والاستقلالية، مقدّمًا رؤية نقدية لمستقبل محور المقاومة وحدود الدور الإيراني فيه.
فوزي الغويدي[1]
في زمنٍ تتشظّى فيه معاني المقاومة، ويبهت فيه الخط الفاصل بين المبدأ والمصلحة، يأتي كتاب "إيران وحماس: من مرج الزهور إلى طوفان الأقصى – ما لم يُرْوَ من القصة"[2] للباحثة فاطمة الصمادي، بعد سنواتٍ من البحث والتحليل الميداني، ليقدّم رؤيةً معمقةً وشاملة لمسار العلاقة بين إيران وحماس؛ من بداياتها في مرج الزهور جنوب لبنان، وحتى اللحظة الراهنة التي تميّزت بـ طوفان الأقصى، مُعيدًا تركيب واحدةٍ من أكثر العلاقات إثارةً للجدل في التاريخ السياسي المعاصر: علاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.
لا يتناول الكتاب هذه العلاقة بوصفها مجرّد علاقة بين دولتين أو تنظيمين، بل بين عقيدتين متجاورتين في الجغرافيا، متنافرتين في المذهب، ومتقاطعتين في الحاجة. ولا يكتفي بسرد الوقائع، بل يغوص في الجذور التاريخية والسياسية والفكرية لهذه العلاقة، محاولًا تفكيك التناقضات والتحوّلات التي طبعت مسارها.
يتألف كتاب "إيران وحماس" من أقسامٍ متداخلة، تبدأ بتوثيق تاريخ العلاقة بين إيران والقضية الفلسطينية، مرورًا بتطوّر حركة حماس منذ تأسيسها عام 1987، ثم تحليل طبيعة العلاقة بين الطرفين عبر مراحل متعددة من التقارب والتوتّر، وصولًا إلى التحديات الراهنة التي تواجه محور المقاومة. كما يوثّق تاريخ العلاقة بين إيران وفلسطين منذ نهاية العهد القاجاري (1794–1925)، مرورًا بالعهدين البهلويين (1925–1941 و1941–1979)، وصولًا إلى الجمهورية الإسلامية، ما يمنح القارئ فهمًا عميقًا للسياق التاريخي الذي تطوّرت فيه هذه العلاقة.
يُعدّ هذا الكتاب من الدراسات التي تتناول التاريخ الراهن، أو ما تصفه الباحثة بـ "التاريخ الآني"، إذ اعتمدت الصمادي منهجيةً تجمع بين التحليل التاريخي والسياسي، مع توظيفٍ مكثّفٍ للرواية الشفاهية التي استقتها من مقابلاتٍ أُجريت مع قياداتٍ ومسؤولين سابقين وحاليين في إيران وحماس، إضافةً إلى مراجعة وثائقَ أرشيفيةٍ تعود بعضُها إلى وزارة الخارجية الإيرانية في العهدين القاجاري والبهلوي، فضلًا عن موادّ إعلاميةٍ ومذكراتٍ لقياداتٍ إيرانية. هذا التوثيق المزدوج بين الشهادة والوثيقة منح العمل عمقًا نادرًا في الكتابات العربية التي تناولت الموضوع، إذ كثيرًا ما اكتفت بسرد سطح الأحداث دون الغوص في البنية الداخلية للخطابَين الإيراني والفلسطيني.
كما لجأت الباحثة إلى بناء نموذجٍ تفسيريٍّ مركّب، استند إلى نظرية الاختيار العقلاني لفهم دوافع الأطراف، مع التركيز على الخطاب السياسي بوصفه مرآةً تعكس طبيعة العلاقة وأبعادها الأيديولوجية والسياسية. وقد أتاح هذا الأسلوب تقديم قراءةٍ متوازنةٍ تبتعد عن التوصيفات المبسّطة مثل "التابع" أو "الوكيل"، وتُبرز العلاقة بوصفها تحالفًا استراتيجيٍّا معقّدًٍا يتجاوز الانقسامات الطائفية بين السنّة والشيعة.
ومع ذلك، فإن هذه المنهجية، رغم قوّتها في تقديم سردٍ غنيٍّ بالتفاصيل وشهاداتٍ مباشرة، تحمل في طيّاتها بعض نقاط الضعف التي يجب الإشارة إليها. فاعتماد الرواية الشفاهية، على أهميته في كشف الزوايا الخفية وتقديم الشهادات الحيّة، قد ينطوي على تحيّزاتٍ شخصيةٍ أو سياسيةٍ، لا سيّما في سياق علاقةٍ معقّدةٍ تتّسم بالتوتّرات والسرّية. كما أنّ بعض المصادر الإيرانية الرسمية قد تعكس خطابًا أيديولوجيًا يهدف إلى تعزيز صورة النظام وتبرير سياساته، ما يستدعي قراءةً نقديةً متأنّية.
كانت الباحثة واعيةً لهذه التحدّيات، وحاولت قدر الإمكان إفساح المجال أمام مختلف وجهات النظر، غير أنّ بعض الفصول، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالثورة السورية، كان يمكن أن تتوسّع أكثر لتشمل أصواتًا أكثر تنوّعًا، خصوصًا من داخل حركة حماس نفسها، التي شهدت انقساماتٍ داخليةً حول موقفها من تلك الثورة. مع ذلك، فإنّ تنوّع المصادر وتكامل استخدامها يمنح الكتاب موثوقيةً عالية، ويجعل منه مرجعًا مهمًّا لفهم العلاقة بين إيران وحماس في سياقها الإقليمي والدولي.
رحلة التحالف الاستراتيجي
يبدأ الكتاب بتتبّع جذور العلاقة بين إيران والقضية الفلسطينية منذ العهد القاجاري، حين كانت إيران تراقب من بعيد تحوّلات المشرق العربي بعد سقوط الدولة العثمانية، مرورًا بمرحلة الشاه التي شهدت تقاربًا سريًا مع إسرائيل، ليرسم سياقًا تاريخيًا طويلًا للعلاقة بين طهران وفلسطين قبل قيام دولة إسرائيل بوقتٍ طويل، وصولًا إلى الثورة الإسلامية عام 1979 التي قلبت الموازين وجعلت من فلسطين "قضيةً مركزية". هنا تبرز أهميته في رصده التحوّل من دعم حركاتٍ علمانية مثل "فتح"، إلى تبنّي حركاتٍ إسلامية مثل "الجهاد الإسلامي" أولًا ثم "حماس" ثانيًا،[3] متتبعًا في الوقت نفسه أثر الخطاب الإيراني عن "القدس" بوصفها قضيةً رمزية في الوعي الشيعي، قبل أن تتحوّل الثورة الخمينية إلى فاعلٍ مباشرٍ في صياغة هذا الوعي وتوجيهه.
يُبرز الكتاب كيف مثّلت الثورة الإسلامية عام 1979 نقطة التحوّل المركزية، إذ أصبحت فلسطين حجر الزاوية في سعي الجمهورية الإسلامية لبناء نفوذها الإقليمي ومدّ حضورها خارج حدودها. فقد أدرك الخميني أن القضية الفلسطينية هي اللغة الوحيدة القادرة على منح الثورة القبول لدى الشعوب العربية والإسلامية في آنٍ واحد، فكان عنوان تلك المرحلة التواصل مع الشعوب والأمم بدلًا من التواصل مع الحكومات. لذلك صاغ خطاب "القدس الثوري" بديلاً عن الخطاب القومي العربي الذي تآكل في سبعينيات القرن الماضي، وظهر مشروع تصدير الثورة الذي استهدف أربع مناطق جغرافية رئيسة: الخليج، ولبنان وفلسطين، وآسيا الوسطى والقوقاز، وأفغانستان. وقد اتّسم هذا الخطاب بسماتٍ من أبرزها رفض الحدود الجغرافية، ورسم الحدود الأيديولوجية، والدفاع عن المستضعفين.[4]
ولا تغفل الصمادي دور الرؤساء الإيرانيين في رسم ملامح السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، والتي انعكست بطبيعة الحال على علاقة طهران بالقضية الفلسطينية عمومًا، وبحركة حماس على وجه الخصوص. توضّح الباحثة أن العلاقة بلغت ذروتها في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، بينما شهدت تراجعًا واضحًا خلال فترة الرئيس حسن روحاني. كما تتناول بإسهاب مسألة الرسالة الموجَّهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية المثيرة للجدل في عهد محمد خاتمي، عارضةً مختلف وجهات النظر حولها وموقعها ضمن مسار تطوّر الخطاب الإيراني.[5]
وإذا كان بالإمكان تتبّع العلاقة بين إيران وحركة حماس عبر محطاتٍ محددة، فيمكن تقسيمها إلى خمس محطاتٍ رئيسية. المحطة الأولى تمثّلت في اللقاءات التي جمعت قيادات فلسطينية من ضمنها شخصيات من حماس قبل تأسيسها عام 1987 وبعده في عدد من المدن في دول مختلفة، أبرزها اللقاء السري الذي عُقد بين ممثلي إيران وقيادات من حماس في أحد فنادق الإمارات عام 1990، والذي يصفه موسى أبو مرزوق بأنه شكّل "مرحلة التأسيس" في العلاقة بين الطرفين. وقد عرض الوفد الإيراني حينها تقديم دعمٍ مالي، غير أن ممثلي حماس رفضوا تلقي مساعداتٍ مالية مباشرة، مؤكدين منذ البداية رغبتهم في علاقةٍ تقوم على الاحترام المتبادل لا على التبعية.[6]
المحطة الثانية جاءت مع زيارة وفدٍ من حماس برئاسة إبراهيم غوشة إلى طهران على هامش مؤتمر دعم الانتفاضة في أواخر عام 1991، وهي الزيارة التي أسفرت عن افتتاح مكتبٍ للحركة في طهران مطلع عام 1992.[7] وفي أواخر العام نفسه، قام المكتب السياسي لحماس بزيارةٍ رسمية إلى طهران للمرة الأولى، حظي خلالها الوفد باستقبالٍ رفيع المستوى، ما مهّد لتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين.
أما المحطة الثالثة، فهي مرج الزهور، التي تصفها الصمادي بـ"فتح الفتوح في العلاقة وبناء الثقة". ففي أعقاب حملة الاعتقالات التي شنّتها إسرائيل عام 1992 قبيل اتفاقية أوسلو، أُبعد 415 من كوادر حماس إلى مرج الزهور جنوب لبنان، وكان من بينهم عدد من أبرز قيادات الحركة، مثل الشهيد عبد العزيز الرنتيسي. وقد اغتنمت إيران هذه الفرصة للتواصل المباشر مع المبعدين عبر حزب الله. يوثّق الكتاب في هذا السياق حالة التوجّس المتبادل في بدايات العلاقة؛ إذ تنقل الباحثة عن القيادي في الحرس الثوري مجتبى أبطحي قوله: "أذكر تحفظهم، كانوا يعتقدون أننا كفار ومشركون ويظنون أننا نعبد الإمام علي، حتى إن بعضهم لم يكن يرغب بمد يده للسلام علي.. لكن لاحقًا عقدنا رابطة إخوة"[8].
ويشير محمود الزهار إلى أن العلاقة بدأت بصورةٍ جديّة بعد شتاء مرج الزهور، سواء مع إيران أو مع حزب الله. وتوضح الباحثة أن منحى العلاقة بين حماس وإيران أخذ يتطور تدريجيًا بعد تلك المرحلة حتى بلغ مستوى القيادة، حين التقى الشيخ أحمد ياسين بحسن شيخ الإسلام[9] عام 1998، ودُعي لزيارة طهران فلبّى الدعوة.[10]
أما المحطة الرابعة، فتمثّلت في معارضة إيران لمشاركة حماس في الانتخابات عام 2006، خشية انخراطها في عملية تسوية. غير أنّ حماس أصرت على قرارها، ما عكس استقلاليتها في صنع القرار رغم اعتمادها على الدعم الإيراني. وفي العام ذاته، نُقل ملف العلاقة مع حماس من وزارة الخارجية الإيرانية، وكذلك ملف العلاقة مع حركة الجهاد الإسلامي من وزارة الاستخبارات إلى الحرس الثوري، ويُعدّ هذا الانتقال أحد أبرز التحولات في مسار العلاقة، إذ بدأت معه مرحلة جديدة من الدعم العسكري والمالي الاستراتيجي.
أما المحطة الخامسة، فكانت الثورة السورية، التي شكّلت أكبر اختبار للعلاقة بين الجانبين. فعلى الرغم من التوترات التي نشأت بسبب الموقف المتباين من دعم النظام السوري، حيث شهدت العلاقة فتورًا ملحوظًا، ظلّ "محور المقاومة" قائمًا كإطار استراتيجي يجمع بين إيران وحلفائها، وإنْ تفاوتت مستويات التنسيق والتعاون داخله.
تكشف الصمادي أنّ هذا الفتور لم يؤدِّ إلى انقطاع الدعم العسكري بشكل كامل، بل إلى إعادة تقييم العلاقة وفتح قنوات جديدة للتواصل بعيدًا عن الإعلام. فقد أدّى موقف حماس المنحاز إلى الثورة السورية ورفضها الوقوف إلى جانب نظام الأسد إلى شبه قطيعة مع طهران، وبلغ التوتر حدّ توجيه اتهامات إيرانية لحماس باستخدام السلاح الإيراني في مواجهة النظام السوري وحلفائه. وهنا برز السؤال: هل الدعم الإيراني لحماس مشروط؟
توضح الباحثة، استنادًا إلى مقابلات شفهية مع قيادات إيرانية وحمساوية، أنّ الدعم لم يكن مشروطًا، ولا مدخلًا لنشر التشيّع،[11] وأنّ الخلاف حول الثورة السورية كان سببه تباين قراءة الطرفين لطبيعة ما حدث في سوريا؛ إذ انحازت حماس إلى موقفٍ أقرب إلى الشارع العربي الرافض لقمع النظام السوري، بينما رأت طهران في ذلك خيانةً لمحور "المقاومة والممانعة".
في المقابل، اعتبرت حماس أنّ بقائها في دمشق يُعدّ خيانةً للشعب السوري وثورته.[12] عند تلك اللحظة وقعت القطيعة الأعمق؛ فأُغلقت مكاتب الحركة في دمشق، وبدأت مرحلة الجفاء الممتدة حتى عام 2017، حين أعلنت حماس وثيقة المبادئ والسياسات العامة التي حاولت من خلالها إعادة تعريف موقفها من إسرائيل والعالم، بالقول إنها تقبل بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 من دون الاعتراف بشرعية الكيان.
في طهران، قرأت الصحافة الرسمية الوثيقة بوصفها تراجعًا عن مبدأ تدمير الكيان الصهيوني وخضوعًا لتأثير الوسطاء العرب. وكتبت صحيفة جمهوري إسلامي آنذاك افتتاحية حادّة قالت فيها إن الوثيقة تعبّر عن أفكار خالد مشعل وتوجّهاته التي تخدم أجندة التسوية.[13]
تحلّل الصمادي هذا التوتر ببراعةٍ، إذ ترى أن الخلاف لم يكن على المبدأ، بل على تعريفه. وقد أسهم صمود حماس أمام العدوان الإسرائيلي عام 2014 في إعادة تقييم العلاقة، وبناءً على ذلك عادت العلاقة إلى مسارها الطبيعي، ولو جزئيًا. أما عملية "سيف القدس" في أيار/ مايو 2021، فقد "غسلت كل شيء" – على حدّ وصف أحد قيادات الحرس الثوري – ومثّلت منعطفًا حاسمًا أعاد العلاقة إلى مسارها، إذ أدركت حماس حجم الدعم الاستراتيجي الذي تقدّمه إيران، فيما رأت طهران في أداء المقاومة تأكيدًا لفعالية استراتيجيتها.[14]
طوفان الأقصى: آخر أوراق الخطاب
يتوقّف الكتاب في فصله التاسع عند سؤالٍ محوريّ: "هل خذل محورُ المقاومة حركةَ حماس في طوفان الأقصى؟"[15] توثّق الصمّادي الخطابَ الإيراني الصادر عقب عملية طوفان الأقصى، موضّحةً من خلاله حدود الدور الإيراني في الانخراط بحربٍ شاملة مع إسرائيل. كما تبيّن انقسام النخب الإيرانية إلى ثلاثة اتجاهات في تفسير العملية: فريقٌ ظلّ مشكّكًا بها، وفريقٌ رأى فيها فخًّا أمريكيًّا–إسرائيليًّا، وفريقٌ ثالث اعتبرها عمليةً كشفت ضعف الكيان المحتل في منظومته الدفاعية.
وفي المقابل، توثّق الباحثة الدعوات الصريحة من قيادات حماس في الخارج التي طالبت إيران ومحور المقاومة بتقديم المزيد من الدعم، معتبرةً أن ما قُدّم جيّدٌ لكنه غير كافٍ.[16] كما تنفي، استنادًا إلى مقابلاتٍ شفاهية، ما رُوّج إعلاميًّا حول كون عملية طوفان الأقصى جزءًا من خطةٍ شاملةٍ تتضمّن فتح الجبهة الشمالية وجبهاتٍ أخرى في توقيتٍ تحدّده طهران.
وقد أصابت الباحثة في تحليلها حين أوضحت أنه لم يعد ممكنًا لإيران خوض مواجهةٍ مباشرةٍ مع إسرائيل بعد طوفان الأقصى واغتيال إسماعيل هنية، في ظلّ ما يُعرف بـ"حروب الظلّ" و"المنطقة الرمادية". كما تشير إلى أن سعي إيران لتجنّب التصعيد كلّفها الكثير، وأن العدوان على غزة اختبر حدود الفعل الإيراني ومدى ما يمكن أن يبلغه محور المقاومة.
ورغم استناد الباحثة إلى تأكيد قادة حماس أن الدعم الإيراني «غير مشروط»، فإن المشاهد التي أعقبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر تُظهر صورة أكثر تعقيدًا. فـ"الشرط" الضمني، كما تجلّى، هو ألّا تدفع حماس إيران إلى حربٍ إقليميةٍ شاملةٍ لا ترغب بها طهران. وبذلك يتحوّل "الدعم غير المشروط" إلى "دعمٍ استراتيجيٍّ مشروطٍ بحدود المصلحة العليا للدولة الإيرانية". ويبدو أن إيران تنظر إلى العلاقة من خلال منطق "العقلانية الاستراتيجية" الذي يضع المصالح الوطنية الإيرانية فوق كل اعتبار، حتى وإن تعلّق الأمر بأقدس قضايا محور المقاومة.
وتختتم الباحثة الفصل برؤية خليل الحيّة، التي تؤكد أن مستقبل العلاقة بين إيران وحماس سيبلغ مستوياتٍ عليا بعد الإسناد الذي وجدته الحركة من محور المقاومة.[17] غير أنّ الحرب، وإن أعادت إليها التعاطف الشعبي العربي والإسلامي، فقد كشفت أيضًا حدود استقلالها؛ إذ بدا المشهد كما لو أن الحركة تقاتل عن الجميع، بينما يراقبها الجميع باسم "الحذر الاستراتيجي".
ما الذي يتركه الكتاب من أسئلة؟
في ظلّ التحوّلات الراهنة، يظهر حزب الله وحماس كصورتين مختلفتين داخل محور المقاومة. فـحزب الله، الذي كان لاعبًا إقليميًا فاعلًا ويمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، يعاني اليوم تراجعًا ملحوظًا في قدراته نتيجة الضربات الإسرائيلية المتكرّرة والاغتيالات التي استهدفت قياداته البارزة، إضافةً إلى التحدّيات الداخلية التي أعقبت حرب عام 2024. إنّ التحوّل الذي طرأ على حزب الله، من لاعبٍ إقليمي يملك فائض قوّة يوظّفه في سوريا والعراق واليمن، إلى طرفٍ محاصرٍ يحاول حماية ما تبقّى من معادلة الردع في لبنان، يعكس حجم التحدّيات التي يواجهها محور المقاومة، في ظلّ انقسامٍ إيراني حول مدى الاستمرار في توسيع النفوذ داخل لبنان والمنطقة.
هذا التراجع يُبرز حجم الضربات التي تلقّاها الحزب، والتي استهدفت بنيته التحتية وقياداته الميدانية. وعلى الجانب الآخر، تبدو حماس أكثر صمودًا رغم التحدّيات الكبيرة، إذ استطاعت الحفاظ على تحالفاتها الإقليمية والتوازن بين جناحيها السياسي والعسكري، ورغم الحصار والضغوط وفقدان العديد من القيادات، نجحت في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ورغم ذلك، يترك الكتاب العديد من الأسئلة مفتوحة، خصوصًا في ضوء أحداث 7 أكتوبر 2023 وما بعدها، منها تساؤلات مهمة حول مدى قدرة محور المقاومة على الاستمرار كوحدةٍ متماسكة في ظلّ الانقسامات الداخلية والضغوط الإسرائيلية والدولية المتزايدة؟ وهل يمكن لهذا المحور أن يعيد بناء نفسه ويواجه التحدّيات الجديدة، أم أنّه مقبل على مرحلةٍ من التراجع والتفكّك؟ إلى أيّ مدى يستطيع محور المقاومة الصمود والتكيّف مع التحوّلات المتسارعة في المنطقة؟
هل ستتمكّن إيران وحماس من إعادة صياغة تحالفهما بما يتناسب مع الواقع الجديد؟ وكيف سيؤثّر تراجع حزب الله على توازنات القوّة داخل المحور؟ وما هو مصير القضية الفلسطينية في ظلّ هذه التحوّلات؟ تظلّ هذه الأسئلة مفتوحة، وتحتاج من الباحثين وصنّاع القرار إلى متابعةٍ دقيقة لفهم تطوّرات هذا المحور الحيوي. فالكتاب لا يقدّم إجاباتٍ حاسمة، بل يترك المجال مفتوحًا للتفكير والتحليل، وهو ما يجعله أكثر واقعية واتزانًا.
في الختام، يشكّل الكتاب مرجعًا ضروريًا لكلّ من يرغب في فهم ديناميات العلاقة الإيرانية- الفلسطينية، كما يحتوي على معلومات مكثفة حول هذه العلاقة لا تسعها المراجعة. ويدعونا إلى الحذر من تبسيط العلاقات السياسية في الشرق الأوسط، التي تتّسم بدرجةٍ عالية من التعقيد والتداخل بين الأيديولوجيا والمصلحة. في زمنٍ تتغيّر فيه التحالفات بسرعة، يظلّ فهم هذه العلاقة مفتاحًا أساسيًا لفهم مستقبل الصراع في المنطقة، وربما مدخلًا للتفكير في حلولٍ أكثر استدامة.