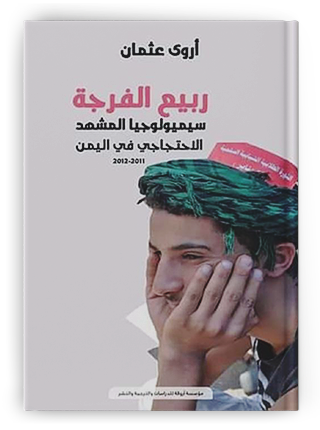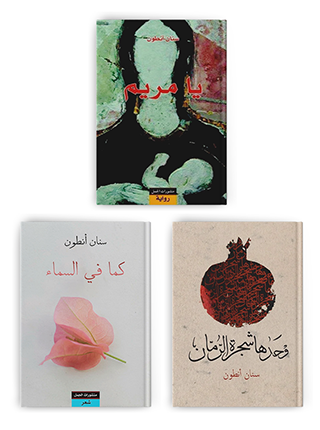يقدّم كتاب حنين شفيق الغبرا، "النساء المسلمات في مواجهة الأنوثية البيضاء: التماهي والمقاومة"، قراءة نقدية لتمثيلات النساء المسلمات في الإعلام والثقافة الشعبية الغربية، مبرزًا كيف تُعاد صياغتهن عبر عدسة الأنوثية البيضاء المهيمنة. ومن منظور تقاطعي ما بعد استعماري، تكشف الغبرا استراتيجيات المقاومة، سواء المعلنة أو الخفية، التي تمارسها النساء لاستعادة السيطرة على صورتهن وهويتهن، في مواجهة الصور النمطية وخطابات الهيمنة. كما يحلل الكتاب ثلاثة نماذج بارزة: المرأة المقهورة (ملالا يوسفزي)، المناصرة للأنثوية البيضاء (آيان هيرسي علي)، وقادة العمل الإنساني (الملكة رانيا العبد الله)؛ في دعوة صريحة لتفكيك البنى الاستعمارية وإعادة امتلاك السرديات.
ياسمين قعدان[1]
يأتي كتاب حنين شفيق الغبرا المعنون "النساء المسلمات في مواجهة الأنوثية االبيضاء: التماهي والمقاومة"،[2] الصادر عام 2021، في ترجمته العربية ضمن 250 صفحة، حاملاً سبعة فصول بينها مقدمة وخاتمة تجوب في التقاطعية النسوية والهوية والتقمّص والعدالة والتماهي والمقاومة لدى النساء المسلمات في مجتمعات متباينة.
تكمن المحاججة الرئيسية للكتاب بأن التصورات عن النساء المسلمات في وسائل الإعلام والثقافة الشعبية الغربية غالباً ما تُبنى عبر عدسة الأنوثية البيضاء، التي تسعى إلى تطبيع المعايير الغربية للجندر والعرق، ونمذجتها وتثبيتها. بحيث تتضمن هذه العملية مفهوم "التماهي" من خلال التواصل الأدائي، وذلك عبر قيام النساء المسلمات بمحاكاة/تقمص هذه الصور النمطية والتوقعات السائدة، أو مقاومتها. وتبعًا لما سبق، فإن الطرح المركزي يكمن في أن النساء المسلمات يتعرضن لصراع رمزي من خلال التنقل بين الامتثال والتحدي للمعايير المهيمنة الملقاة على عاتقهن، والتي غالبًا ما تُشكّل بواسطة تصورات عنصرية وجندرية مفروضة من الغرب.
تكشف هذه الديناميكيات عن عملية أوسع من التفاوض العرقي والثقافي، إذ تُوضع النساء المسلمات غالبًا كـ "الآخر"، أو كموضوع للإثارة وجذب الانتباه والمقاومة في آنٍ واحد. كما تؤكد الغبرا أن المقاومة تتخذ العديد من أشكال الفاعلية المباشرة إلى استراتيجيات الأداء الخفية، وأن هذه العملية لا تتجلى بالضرورة عبر أشكالٍ فنية أو رمزية فحسب، بل تأتي في سياق استعادة السيطرة على تمثيلاتهن وهوياتهن.
كما وتُشدد الكاتبة على ضرورة فهم تلك العمليات ضمن سياق علاقات القوة ما بعد الاستعمارية، والخطابات العنصرية، والسياسات الجندرية، مع الإقرار بأن النساء المسلمات فاعلات نشطات، لا مجرد موضوعات خاملة ضمن هذه الديناميكيات الاجتماعية. وعبرت الغبرا عن ذلك قائلة: "ولهذا السبب كتبت هذا الكتاب، لأجل دراسة ثنائية الظهور/الاختفاء، تلك البنى البلاغية الإشكالية المراد لها حماية الأنثوية البيضاء وإعادة استنساخها، التي بدورها تعيد توطيد الذكورة البيضاء باعتبارها البنية الأيديولوجية السائدة التي تخدم البياض. لأكون أكثر دقة؛ الهدف من الكتاب، تحديدًا، هو التركيز على طريقة انتقال ثقافة البياض عالميًا عبر الأجساد والذوات المسلمة التي تتحدث لغة المستعمر، بدلًا من لغتهم المحلية".[3] ولتوضيح محاججتها، تركز الكاتبة على ثلاثة نماذج بدئية متباينة تحولت كل منها إلى نماذج عالمية في الإعلام والثقافة الشعبية، وهي: النمط المقموع، والنمط المناصر، ونمط قادة العمل الإنساني، وهو ما سيظهر بالتوضيح خلال فصول الكتاب.
التقاطعية ما بعد الاستعمارية
بالارتباط مع ما ذُكر آنفًا، يشكّل الفصل الأول مقدمة مطوّلة ذات طابع حواري ذاتي ونظري، تسرد فيها الكاتبة مسار حياتها الذي جعلها تتأمل موقعيتها كامرأة شرق أوسطية من أصول فلسطينية، تعيش في الكويت، وتدرس في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الموقعية جعلتها تنظر لتموضع جسدها ضمن ثقافات مختلفة، وكيف يؤثر البياض على جسدها "المسلم" وأدائه الذي يعيد إنتاج هذا البياض. وتذهب إلى أن حكايتها الشخصية تُغذي هذا الكتاب بمنظور متفرد، نابع من كون جسدها يقف "بين ثقافتين".
ومن قصتها الذاتية، تتنقل الغبرا إلى توضيح النماذج البدئية التي يتغذى عليها خطاب البياض، وتطلق عليها "الأشكال الأدائية للأنوثية البيضاء"، بوصفها آليات يعاد من خلالها إنتاج هذا الخطاب حتى يتسرب إلى اللاوعي الجمعي، ويعزز الصور النمطية للأبوية البيضاء عمّا يعنيه أن تكون امرأة سوداء، أو بيضاء، أو امرأة مسلمة. وينبع ذلك، أساسًا، من استمرار هيمنة الثنائيات بوصفها مدخلاً لخلق "الآخر"، حيث تحمل هذه الثنائيات دائمًا طرفًا مسلوب القوة.
أمّا الفصل الثاني، فتُقدّم فيه الكاتبة حوارًا بين نظريات مختلفة، وتحديدًا نظريات ما بعد الاستعمار، ونظريات نزع الاستعمار، مشددة على أن الدمج بينهما يفضي إلى عدسة تقاطعية ما بعد استعمارية بوصفها منهجية ونظرية تكشف بنى البياض، وتحلل موقع النساء المسلمات في عالم اليوم التواصلي، لا سيّما داخل الخطاب الإعلامي الغربي. فمن خلال هذه العدسة، يمكن تفكيك النماذج البدئية للنساء عبر تقاطعات الجندر والعرق والجنسانية والطبقة، إذ تمنح التقاطعية القدرة على رؤية المساحات المهمّشة، وكشف أثر الخطاب في أدائية الأجساد بين التماهي والمقاومة.
ومع الدخول إلى الفصل الثالث، تبدأ النماذج التحليلية التي اختارتها الغبرا لاستكمال محاججتها بالظهور؛ إذ تتناول في هذا الفصل مجموعة من النماذج البيضاء عبر الخطابات الرسمية التي ألقتها مثلًا هيلاري كلينتون وباربرا بوش، وليز تشيني، وجورج بوش (الابن)، وباراك أوباما، بوصفهم مَن نَصّبوا أنفسهم متحدثين باسم النساء المسلمات. ومن خلال هذه الخطابات، تركز الكاتبة على السرد و"الحكاية"، وهي الأداة التي يستخدمها هؤلاء الساسة لتبرير هدف سياسي يزعم أن المجتمعات الإسلامية مجتمعات قمع وإرهاب، ما يستدعي -من وجهة نظرهم- الهيمنة والسيطرة عليها، وهو ما يُغلق الباب أمام أي إمكانية لمصلحة المرأة الملوّنة و/أو النسويات في بلدان العالم الثالث، ويعزز بالتالي خطاب الاستعمار.
وعلى الرغم من ظهور هؤلاء الساسة الأمريكيون بمظهر الجامع للعرق والجندر والطبقة والجنس والقومية، إلّا أنهم بذلك يخلقون فضاءً مهمشًا ومعاديًا للنسوية في العالم الثالث بوصفهم أصحاب سرديات عالمية. يظهر ما سبق في تركيز خطاباتهم على تعميم صورة الثقافات والمجتمعات المسلمة أو ما يُسمى بـ"بلدان العالم الثالث"، والترويج للعائلة النووية الغيرية بوصفها نموذجًا كونيًا تنشره الحداثة والعولمة والنيوليبرالية. هذا التعميم يضع جميع النساء في هذه البلدان في وضعٍ متجانس، بوصفهن إمّا غير متعلّمات، أو ضحايا اغتصاب، أو بحاجة إلى وصاية ومنقذ، مما يعزز الأبوية البيضاء، ويُقيد فاعلية النساء الملوّنات وغيرهن. وإلى جانب ذلك، نجد خطابات من قبيل خطابات ليز تشيني، التي تتخذ من النساء الملونات أو المسلمات الناجحات أمثلة على أنه لا وجود لصعوبات مختلفة تمرّ بها النساء في بلدان العالم الثالث، وكأن الصعاب والعوائق الناتجة عن البنى الاستعمارية والاقتصادية والاجتماعية هي بخف ريشة تزول متى ما أرادت المرأة ذلك.
النماذج البدئية بين التماهي والمقاومة
مع الانتقال إلى الفصول الرابع والخامس والسادس، تتناول الغبرا النماذج البدئية الثلاثة التي تتقمّص السرديات الغربية، وفق ثلاثة أنماط: النمط المقموع المتمثل في ملالا يوسفزي الباحثة عن فاعليتها، والنمط المناصر الذي تمثّله آيان هيرسي علي بوصفها مناصرة للأنثوية البيضاء ورافضة للإسلام، والنمط الثالث وهو نمط قادة العمل الإنساني الذي يتجسّد في الملكة رانيا العبد الله، إذ تبحث الكاتبة في سردية تفكك أثر خطابات الأبوية البيضاء على الأجساد المسلمة.
بالعودة إلى ملالا يوسفزي، توضّح الكاتبة، في مقدمة مطوّلة، كيف استُغل الحجاب من قِبل سردية الأبوية البيضاء لتصوير النساء المسلمات باعتبارهن مقموعات، وأجسادهن بحاجة إلى إنقاذ. وملالا، وهي الفتاة الباكستانية التي تعرضت لمحاولة اغتيال على يد طالبان أثناء ذهابها إلى المدرسة، بدأ حجابها يكشف شعرها تدريجيًا بما يتماشى مع ما يُعرف بـ"الإسلام المعتدل". وقد صُنّفت لاحقًا كأحد أبرز الأصوات الأمريكية المدافعة عن حق التعليم، عبر منصات الغرب ولغته وأدواته، لكنها ظلّت محصورة في كونها رمزًا للمعاناة والقمع بفعل "الإسلام". هذا الرمز يُستغل باستمرار من قبل الأجندة البلاغية لخطاب الغرب، سواء عبر حضورها في وسائل التواصل المختلفة، أو في كتابها وفيلمها الذي يحكي قصة حياتها، أو من خلال كونها أصغر من حصل على جائزة نوبل، وهي جميعها تُعدّ وسائط بلاغية لتحريك الأجساد والصور والنصوص بهدف تبرير السياسات الأمريكية وتجسيدها في باكستان والمنطقة عمومًا. وبهذا التماهي، تصبح ملالا "ذاتًا جيّدة"، بعكس من يحاول مقاومة هذه السردية فيُصنّف بـ"ذات سيئة". وهكذا، تُصنف الذات الجيدة مقابل انتزاع الفاعلية والتجربة وحق الجسد من ملالا نفسها. تشير الغبرا إلى أنه، بالرغم من إشارة ملالا إلى أن طالبان تستخدم الإسلام وتستغله، إلا أنها لا تخوض فعلًا في دور الرواسب الاستعمارية والبنى السياسية والاقتصادية في ظهور هذه الجماعات وتطورها، بما يصبّ مجددًا في مصلحة السياسات الغربية البيضاء وإعادة إنتاج خطابها.

الملكة رانيا العبد الله تكرّم ملالا يوسفزي بمنحها جائزة "المواطن العالمي" عام 2013 عن فئة المجتمع المدني ضمن مبادرة كلينتون العالمية. (مصدر الصورة: الموقع الرسمي للملكة رانيا)
أمّا النموذج البدئي المناصر الذي تمثله آيان هيرسي علي في الفصل الخامس، بحسب تعبير الكاتبة، يشير إلى "نسويات ملوّنات ونسويات يعِدن إنتاج النسوية الغربية البيضاء ويمركزنها".[4] وعلى خلاف نموذج المرأة المقموعة مثل ملالا، فإن المناصرات في هذا السياق يتخلّين بالكامل عن ثقافتهن الأصلية. وتعتقد هيرسي علي أن تقمصها الكامل لخطاب النسوية الغربية البيضاء يمنحها فاعلية ذاتية بصفتها متحدثة لا تحتاج إلى إنقاذ، على عكس ملالا، إذ ترفض السرديات المساندة للإسلام والنساء المسلمات، وتبدو كأن فاعليتها نابعة من انفصالها عن الإسلام. لكن هذا في الواقع يعزّز فاعلية الخطاب الغربي المعادي للإسلام والنساء المسلمات، لا فاعليتها هي شخصيًا.
تعتمد هيرسي علي في خطابها على الإشارة المتواصلة للتماثل، أي الادعاء بأن جميع النساء الملونات والبيضاوات يقفن على أرضية متساوية، مما يؤدي إلى خدمة الأنثوية البيضاء، ويمنع التقاطعية التي تلقي الضوء على فرادة التجربة النسائية ضمن بنية العرق والجندر والطبقة وغيرها. أما هيرسي علي فهي تعيد إنتاج شكل القمع على أساس الجندر والتماثل العرقي، لأن التماثل يؤدي إلى المزيد من العنصرية العرقية، بسبب الادعاء بأن الأعراق متماثلة ولا وجود للعنصرية، وأن النساء الملونات لا يواجهن أي أشكال تهميش أو تمييز من قِبل النساء البيضاوات، وهذا يتنافى مع واقع ما تعيشه النساء الملونات في البلدان الغربية. وعبر هذه السردية، يتمكّن الخطاب الاستعماري من التخلص من تاريخه الطويل في قمع النساء، بينما تصرّ هيرسي علي على أن القمع ينتج من الإسلام فقط. يركّز هذا النموذج الخطابي، كما في حالة هيرسي علي، على موضوعات مثل الحجاب والزواج المدبّر والختان باعتبارها ظواهر إسلامية قمعية خالصة تستوجب الاستنجاد بالغرب لإنقاذ النساء المسلمات منها.
في الفصل السادس، تقدّم الكاتبة نموذج الملكة رانيا العبد الله بوصفه نموذج قادة العمل الإنساني. وتوضح أنه، على الرغم من أن الملكة رانيا تشكّل موقعًا لإنتاج وترسيخ الأنثوية البيضاء عالميًا بصفتها قائدة في الشؤون الإنسانية ورمزًا للأمومة والعائلة النووية، كما أنها تعلي من الغيرية عبر موقعيتها وموقعية العائلة الملكية، وكذلك تمثل النمط الحداثي في المظهر، وتمتلك التعليم الغربي، والبشرة البيضاء، فإنها تستخدم هذه الأنثوية البيضاء بغرض مقاومتها.
فعبر أدائها لهذا النموذج، تنزع الملكة رانيا تماهيها معه بفعل موقعها السلطوي وشكلها الحداثي، ما يمكّنها من إنتاج سرديات مقاومة تُسهم في تفكيك الصور النمطية عن الإسلام. تشير الغبرا إلى أن الملكة رانيا ترفض ربط العنف بالإسلام، وتفصل بين التطرف والإرهاب وبين الدين، عبر التأكيد على فكرة السياق في تشكّل هذه الجماعات، وعبر الدفاع عن حق كل امرأة مسلمة، ترتدي الحجاب أو لا ترتديه، في أن تكون صاحبة قرار مستقل لجسدها، وأن ارتداء الحجاب لا يعني بالضرورة الخضوع أو القمع. وتذهب الكاتبة إلى أن الملكة رانيا تشكّل جسرًا بين الشرق والغرب، يحوز جسدها القدرة على العبور من التماهي إلى المقاومة.
ختامًا، وفي الفصل السابع، ترى الغبرا أن هذا الكتاب يشكّل دعوة لتطوير أدوات نقدية تساعد في تفكيك العنف والقمع، وتكسير الصور النمطية والنماذج البدئية التي تُخرس أصوات النساء. هي دعوة للجميع من أجل أن يكونوا فضاءً بينيًا متجاوزًا وعابرًا للثنائيات والتقابلات والأيديولوجيات، وأشكال الأداء التي يفيض بها الإعلام من حولنا.
عن حدود الكتاب واتساعه
لا بد من الإقرار بأن هذا الكتاب يقدّم رؤى معرفية مختلفة، وأدوات تحليلية ومنهجية ونظرية واسعة؛ فتناول التقاطعية ما بعد الاستعمارية يُعد حديثًا نسبيًا، خصوصًا في تطبيقه على المجتمعات العربية أو المسلمة. ومن المهم أن الكاتبة أقرّت بمحاولتها الابتعاد عن النظريات الغربية الكبرى، وأظهرت التزامًا عاليًا في استخدام نظريات النسويات الملوّنات بوصفها جزءًا من تفكيك بنى الهيمنة المعرفية في التحليل النظري. لقد أبدت الكاتبة انكشافًا واضحًا على ذاتها من أجل إيصال أفكار الكتاب، بحيث سردت قصصًا ذاتية تعبّر فيها عن تأملاتها الأدائية الخاصة بجسدها، أو محاولات تماهيها مع الأنثوية البيضاء، وكيف سعت إلى مقاومتها. إلا أن هناك تكرارًا واضحًا يمتد من بداية الكتاب إلى نهايته؛ ومع أن الغبرا تشير إلى أن التكرار متعمَّد بغية تفكيك ما يبدو مألوفًا بفعل هيمنة الخطابات، فإن هذا التكرار بدا مبالغًا فيه، وأحيانًا يقطع استرسال أفكار القارئ. كما أن الكاتبة لم تُقعّد البنية المفاهيمية للكتاب منذ البداية، إذ بقيت مفاهيم عديدة غير واضحة في التأسيس النظري الأولي، وجرى التعريف ببعضها لاحقًا أثناء الفصول.
إضافة إلى ذلك، يمكن الإشارة إلى أن الكاتبة لم تتوقف عند قصور النظرية التي اعتمدتها؛ فالتقاطعية تقدّم مفهوم المقاومة بوصفه فعلًا فرديًا لا جمعيًا، وهو ما قد لا يتيح مقاومة البنى الاستعمارية المتراكمة على أجسادنا، منذ قرون من الزمن وما تزال، بوصفنا نساءً، أو مهمّشين، أو من سكان الجنوب العالمي، أو غير قادرين جسديًا. بناءً على ذلك، بقي مفهوم المقاومة عائمًا عبر ثنايا الكتاب، على عكس مفهومي التماهي والتقمص اللذين حضرا بقوة؛ ما يشير إلى الحاجة لتغيير أو توسيع المفاهيم المعرفية المرتبطة بالأدائية والأجساد.