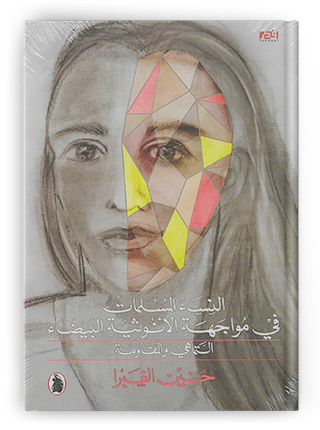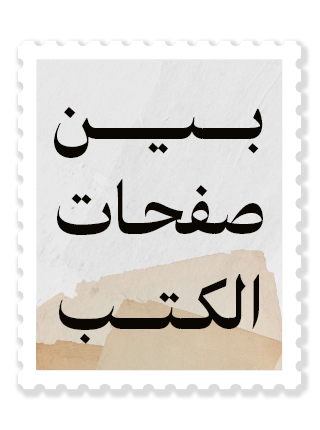في هذه المراجعة-الحوار، تستعيد دينا عزت مع سنان أنطون رحلته الأدبية والفكرية، انطلاقًا من نشأته في بغداد، مرورًا بتجربته الأكاديمية في الولايات المتحدة، وصولًا إلى توثيقه لبغداد بعد سقوط صدام حسين، المدينة المثقلة بالحروب والقمع. وتتتبع المراجعة في أعماله الروائية والشعرية، مثل "وحدها شجرة الرمّان" و"إعجام" و"يا مريم"، كيف جعل من محنة الإنسان -في وجوده السياسي والاجتماعي- محورَ كتابته، مركزًا على العراق والعراقيين في كل ما خطّه، ومسلّطًا الضوء على أسئلة الهوية والأقليات والتقاطع بين التاريخ والسياسة، مع حرصه على أن تصل هذه التجارب إلى القرّاء خارج المنطقة العربية.
دينا عزت[1]
وُلد سنان أنطون في عام 1967، العام الذي مُنيت فيه الجيوش العربية بهزيمة سريعة أمام إسرائيل. وبعد أكثر من عقدين، وفي خضم ما عُرف بحرب الخليج الأولى عام 1991، غادر المنطقة العربية إلى الولايات المتحدة، حيث واصل دراسته الجامعية وشرع في مسار أكاديمي وأدبي نشر خلاله سلسلة من الروايات والقصائد التي تحمل صدى الذات والوطن التارك المتروك، ذلك الوطن الذي يُشرّع أبواب الرحيل ويغلق خلفه بوابات العودة.
في عام 2003، عام "سقوط بغداد" على يد القوات الأمريكية وحلفائها، والذي مثّل الخطوة الأخيرة في إنهاء الحكم الدكتاتوري لصدام حسين، توجه أنطون إلى بغداد ليستمع ويسجّل شهادات أهل المدينة عن الحياة تحت عقود من القمع، لينجز لاحقًا وثائقيه "عن بغداد" برفقة آخرين. تلك الرحلة، وسط الركام والذكريات المحطمة، شكّلت الأساس الذي صاغت منه رواياته القادمة، لتصبح مرآة لتاريخ العراق الممزق وآماله المعلقة في سرد مؤثر.
في العام نفسه، نشر أنطون روايته "إعجام"،[2] حيث يظهر "فرات"، الشاب القابع في سجون الدكتاتور، بمثابة انعكاس للأسى الشخصي والوطني في آن واحد. فرات هو العراقي الذي درس اللغة الإنجليزية وآدابها، وتمرّد على التأليه السياسي لصدام حسين، في مدينة مكتظة بصور القائد "المغوار" التي تهيمن على طرقات بغداد. رفضُه لذلك النظام البعثي ليس سوى امتداد لرفض أعمق لفكرة التأليه والآلهة في مجملها. في محبسه، يدون فرات مآسي القمع، مستخدمًا لغة غنية بالتناص المخفي بين الواقع الذي يمجّد شخوص النظام وبين رؤيته الخاصة لهم. هذه التدوينات لا تُفهم إلا لاحقًا على يد "طلّال"، الذي تستجلبه وزارة الداخلية لفك طلاسمها وكشف ما تحويه من رسائل وأسرار.
أما "نمير"، بطل رواية "فهرس"،[3] التي صدرت لأول مرة عام 2016، فيتوجه إلى بغداد بعد سقوط صدام حسين إثر الغزو الأمريكي، حيث يشهد المدينة ويستمع إلى روايات أهلها عن حياتهم تحت القمع الطويل. هناك يلتقي ببائع الكتب "داوود"، الذي يعمل على فهرسة الحرب وتوثيق أحداثها، محاولًا حفظ ذاكرة المدينة. وقد دخلت الرواية القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2017، المعروفة باسم "جائزة بوكر العربية".
التدوينات المشفّرة التي تنتقل من فرات إلى طلّال، وتروي مأساة العراق وجرحه الغائر، تشكّل مفتاحًا لفهم الأعمال الأدبية التي أنتجها أنطون في رواياته وشعره. فرات في "إعجام"، كما "جواد" مغسل الموتى في "وحدها شجرة الرمان"[4] الصادرة عام 2012 بعد عقد على سقوط بغداد، و"سامي" في رواية "خزامى"[5] الصادرة عام 2023، و"يوسف" في "يا مريم"[6] الصادرة عام 2012 والتي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية، كل هؤلاء يمثلون سرديات العراق والعراقيات والعراقيين، تلك التي عاشوها في ظل حكم صدام حسين وحروبه، وتلك التي شهدوها بعد سقوط الدكتاتور، حين سيطرت الطائفية وأشعلت نيرانها، وحوّلت بغداد، "التي كانت سجنًا كبيرًا يمكن التجول داخله بحرية"، إلى سلسلة من السجون المتلاصقة التي تحرسها المليشيات، كما كتب أنطون في "وحدها شجرة الرمان."
رواية "وحدها شجرة الرمان" هي ربما الأكثر شعريّة بين أعمال أنطون، أو على الأقل تلك التي يمتزج فيها الشعر والسرد في عمل أدبي متناغم. ويعود ذلك إلى سيطرة متلازمة الحياة والموت على صفحات الرواية، حيث يتناهي صدى أفكارها في كثير من قصائد أنطون، خصوصًا تلك المعنونة "ليلٌ واحدٌ في كلّ المدن"[7] من ديوان يحمل الاسم نفسه، والتي يكتب فيها:
تلوّح السعفاتُ مودّعة
من شبابيك أغنيةٍ قديمةٍ
عن النهرِ
قبل أنْ تختنقَ أمواجُه بالجثث
وفي قصيدة "في حياة قادمة" من ديوان "كما في السماء،"[8] يكتب أنطون:
في حياتي القادمة
لن أكون "أنا"
سأكون زهرة بريّة
تستلقي على سفح تلّ بعيد
تستريح عليها الفراشات
ويشكّل هذان الديوانان امتدادًا لمسار أنطون الشعري الذي ابتدأه في ديوانه الأول الصادر في القاهرة عام 2003 بعنوان "موشور مبلل بالحروب."[9]
تجدر الإشارة إلى أن آب/ أغسطس 1990 كان قد شهد انعقاد قمة عربية طارئة في القاهرة، طالبت صدام حسين بإنهاء غزوه للكويت، الذي وقع في الثاني من آب/ أغسطس من ذلك العام. ومنذ ذلك الوقت، شرعت بغداد في مسار طويل من التداعي قبل سقوط صدام، لتسعى جاهدة لجمع شتات المدينة والذاكرة المتناثرة، حتى انعقدت القمة العربية في بغداد في عام 2025، معلنةً ما يشبه محاولة لاستعادة بعض ما فُقد. وفي حديثه بعد انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية في أيار/ مايو، أعرب أنطون عن تشاؤمه، قائلًا إنه لا يرى في مثل هذه القمم أو غيرها ما يعنّي كثيرًا لمدينته الجريحة، وأضاف: "القمم، منذ عقود، لم تكن سوى مشهد مضحكٍ مبكٍ معًا."
بحسب أنطون، فإن سرديات المدن لا تروي أبدًا ما كان يجري فيها من هذا النوع من الاجتماعات، التي تبقى دائمًا على الهامش. وبغداد، عنده، هي سردية "وطن متجاوز للمقاربة"، يتشكّل في واقعة هنا أو هناك.
تتجسّد بغداد أمام القارئ كصليب للألم والنجاة معًا، وهو الثابت الدائم في التجربة الأدبية لأنطون. فبغداد أنطون هي الحلم، والهاجس المسيطر. كما ترسمها صفحات روايته، فهي مدينة مثقلة بالتاريخ والحكايات، لأبنائها على اختلاف انتماءاتهم وآرائهم، بأماكنها الصغيرة، وساحاتها الكبرى الباقية رغم "الاحتلال الأميركي الذي فكك مؤسسات الدولة وحوّل العراق إلى ساحة مفتوحة للعنف".
وكما يقول أنطون: "بغداد تتغيّر ولا تموت." ففي قلبه وذاكرته، تبقى المدينة التي كان يطارد فيها الفراشات طفلًا، في ركض يحمل براءة الحياة وبهاء الطبيعة. ولا يرى أنطون، في الذكرى الخامسة والثلاثين لغزو صدام للكويت وما تلاه من حرب على العراق ثم احتلاله، أي تعارض بين رفضه قمعَ صدام ودمويتَه، ورفضه في الوقت ذاته احتلالَ العراق وتحويله إلى ساحة لطائفية عمياء تتغذى على العنف.
في عالم أنطون، الموت يحيا فيمات، يتنفس في شوارع مدينته ويعايش أهلها، كما في "وحدها شجرة الرمان"، حيث تتوالى الأجساد القادمة من ساحات القتل لتُغسَل قبل أن تُكفَّن بالبياض وتُوارى ثرى الوطن. الموت في رواياته عنوان لحقيقة فلسفية في جوهرها؛ ليس بداية لشيء ولا نهاية لآخر، وليس بالمعنى الميتافيزيقي أو الحتمي. وعلى المستوى الشخصي، يصرّح أنطون بأنه لا يؤمن بحياة أخرى بعد الموت، قائلاً: "حتى لو كانت هناك حياة أخرى، فلن أكون أنا هو أنا".
ومع ذلك، فإن للموت عند أنطون بعدًا واقعيًا متجسّدًا في الحروب التي تمزق خرائط الجغرافيا والهوية. فأسئلة الحروب في هذه المنطقة من العالم تتكرر بلا انقطاع، من بغداد إلى غزة المنكوبة والغارقة في حرب لا تهدأ ولا تنتهي. "كيف لنا ألا نرى هذا، ونحن نشاهد طفلًا من غزة، في التاسعة من عمره، يحمل نعش أخيه؟" كما يقول بأسى بالغ.
ينشغل أنطون اليوم كثيرًا بغزة وما يحلّ بها، ويقول: "هذا لا يجب أن يُسمّى حربًا، بل يجب أن يُسمّى بحثًا عن الإبادة... ما يحدث في غزة هو إنهاء لغزة وإنهاء لأهلها، وسط كل هذا التخاذل والتواطؤ من الأنظمة العربية... (المتغافلة) عن حقيقة المشروع الإسرائيلي من النيل إلى الفرات... (وفي كل الأحوال)، هو مشروع قائم على صراع الوجود." ويضيف أن ما يجري في غزة هو الدليل الساطع على أن "الحضارة التي نعيشها هي، في المحصلة النهائية، حضارة بربرية"، إذ يتعايش العالم مع المجزرة بوصفها جزءًا من "الأخبار المعتادة"، في حين يواصل "ذلك الوحش الذي يُدعى إسرائيل، والذي لا يشبع من القتل والدماء"، قتل أعداد كبيرة من الأطفال والنساء. أما من لا يُقتَل فقد يُسلب أطرافه أو قدراته الأخرى.
ويعمل أنطون حاليًا على عدة مشاريع، من بينها ترجمة لأشعار محمود درويش، الشاعر الفلسطيني، تأكيدًا على ترابط الاسم مع القضية، لا مجرد اقتران الشعر بالهوية.
في الوقت نفسه، يتابع أنطون تطوّرات الوضع في سوريا، ويرى ذلك التشابه مع ما كتبه عن عراقه؛ إذ انصهرت سوريا بدورها تحت دكتاتورية بعثيّة قاسية، ثم شهدت سعيًا موؤودًا نحو الديمقراطية، فسقوطًا للطاغية، قبل أن تنزلق سريعًا إلى التشرذم بدواعي الطائفية. هذا هو، كما يقول، "الليل الواحد" حيث "الغربة المفروضة على الإنسان، وحيث الخراب الذي يحمله معه."
من هنا يفهم أنطون تلك الحساسية التي يبعثها الأدب المعبر عن التجربة الإنسانية، والتي يجدها القارئ في كتاباته كما في نصوص أخرى قادمة من سوريا أو بلدان مختلفة، كالأدب اللاتيني الأمريكي. ويقول: "هذا هو سحر الأدب الذي ينبه من الحياة، فيكون عابرًا للحدود، يستشعره القارئ في المشرق ومصر والمغرب". ويضيف أن الأسئلة التي تطرحها رواياته، خاصة "وحدها شجرة الرمان" و"يا مريم"، هي أسئلة ترتبط بالهوية والحياة والمعنى في كليهما، وهو ما يجعل هذه الأعمال قابلة للقراءة والتفاعل في مناطق خارج العالمين العربي والإسلامي.
وقد تُرجمت روايات أنطون إلى الإنجليزية وإلى العديد من اللغات الأخرى، وهو يعمل حاليًا على ترجمة روايته "خزامى" بنفسه لتصدر خلال أشهر قليلة. ويدرك أنطون شغف القارئ الأجنبي بما يكتب، لأنه يلامس قضايا عابرة للجغرافيا، ولأن الهوية، في النهاية، تتشكّل وتُعاد صياغتها بين ما يكتبه الروائي أو الشاعر وما يتلقّاه القارئ.
يقول أنطون: "الإشكالية هي أن الناس يظنون أن الهوية شيء عابر للتاريخ، لكن من يتحرّى العلاقات بين شرائح مختلفة في بلدان معينة يدرك أن الهوية – أي هوية ما – لم تكن دائمًا بالضرورة متحزّبة في هذا الاتجاه أو ذاك، أو محمّلة بالحمولة السياسية" التي تبدو عليها اليوم وفي سياق معين. سؤال الهوية وتحوّراتها، وسؤال تقاطع الهويات، هو بالتأكيد محور أساسي في كتابات أنطون. والرواية النموذج في هذا الشأن هي "يا مريم"، وكذلك "وحدها شجرة الرمان". وفي "إعجام" يبرز الكاتب كيف يسعى الدكتاتور للهيمنة على الأقليات، فتصبح الهوية ساحة صراع بين الفرد والسلطة، بين الحرية الشخصية وإرادة القمع السياسي.
وملحَقًا بسؤال الهويات، بحسب أنطون، يأتي سؤال الأقليات، الذي أصبح اليوم في العراق كما في سوريا، وفي غيرها من بلدان التعدد العرقي، سؤالًا ملحًّا. يرى أنطون أن فكرة "المجتمعات الطاردة للأقليات أصبحت مسألة-فكرة ملحّة (في الواقع وفي النقاش) خلال السنوات العشرين الأخيرة"، لكنه يضيف أن هناك سؤالًا ملحقًا بهذه الظاهرة، وهو "إذا كانت المجتمعات طاردة للأقليات اليوم، فكيف عاشت هذه الأقليات في ذات هذه المجتمعات لمدة قرن من الزمان أو أكثر؟" ويؤكد أن الأمر مرتبط بخيار سياسي من حيث "التخندق في خصومات". تلك الأسئلة ما تزال ترافق أنطون في رواية قادمة يعمل على كتابتها حاليًا، ويرفض بشدة الحديث عنها، فهو لا يحب الإفصاح عما لم يكتمل بعد.
ولهذا يرفض أيضًا الإفصاح عن كتاب أكاديمي يعمل عليه حاليًا، ويترك للقارئ مجال توقع محتواه في ضوء ما يعرفه عن هذا الكاتب العراقي، المولود في أسرة مسيحية، رغم أنه لا يعرّف نفسه على أنه مسيحي، ولا يعترف بالتقسيمات والخانات، ويؤكد دومًا أنه من بغداد. يعيش أنطون اليوم ويعمل في نيويورك، حيث يدرّس الأدب العربي، وقد نال درجة الدكتوراه عن أطروحته حول الشاعر العباسي الشيعي ابن الحجاج، المعروف بحبه لآل البيت.
ختامًا، ما يقدّمه سنان أنطون عبر رواياته وشعره هو محاولة صادقة لاستعادة ذاكرة الوطن والإنسان في مواجهة الخراب والقمع والحروب. من بغداد إلى غزة، ومن قصص الأقليات إلى تحوّلات الهوية، تتجسّد رؤيته في مدينة لا تموت، مدينة تختزن الألم كما تختزن الأمل. وهناك، يظل الأدب نافذةً تتيح للقارئ الاقتراب من جوهر التجربة الإنسانية، عابرًا الحدود والزمن، متجاوزًا القيود السياسية والاجتماعية.