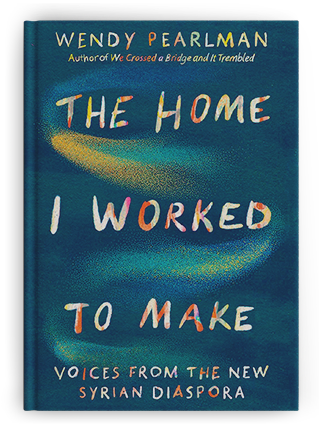يتناول كتاب سوجاتا أشواريا "غاز البحر الأبيض المتوسط الإسرائيلي" التداعيات الداخلية والخارجية لاكتشافات الغاز الطبيعي في إسرائيل، وتحولها من دولة مستورِدة للطاقة إلى مصدِِّرة لها، وما ترتب على ذلك من آثار اقتصادية وجيوسياسية على منطقة شرق المتوسط. كما يستعرض الجدل الدائر حول حوكمة الموارد الطبيعية، وسياسات الضرائب والتصدير، ويحلّل دبلوماسية الغاز الإسرائيلية مع دول الجوار. فيقدّم الكتاب، في مجمله، قراءة تركيبية تجمع بين التاريخ والسياسة والاقتصاد، لفهم واقع الطاقة في إسرائيل ومساراته المستقبلية.
رامز صلاح [1]
لم تكن اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط مجرّد حدث اقتصادي عابر، فقد شكّلت تحوّلًا ديناميًا في الواقع الجيوسياسي للمنطقة برمّتها، منبئةً بتغيير غير مسبوق في قواعد السياسة والاقتصاد، ومبشّرةً، في الوقت ذاته، بإمكان تحويل المنطقة من بؤرة صراع إلى ساحة تعاون وتبادل مُربح. في هذا السياق، يقدّم كتاب "غاز البحر الأبيض المتوسط الإسرائيلي: الحوكمة المحلية، الأثر الاقتصادي، والتداعيات الاستراتيجية"[2] لسوجاتا أشواريا، الأستاذة في مركز دراسات غرب آسيا بالجامعة المليّة الإسلاميّة في نيودلهي، تحليلًا شاملًا لقطاع الغاز الطبيعي الناشئ في إسرائيل، مسلّطة الضوء على تأثيراته المتعدّدة على المستويين الداخلي والخارجي.
يستعرض الكتاب، المؤلّف من أربعة فصول، تاريخ قطاع الطاقة بدءًا من الاعتماد شبه الكامل على واردات الطاقة وصولًا إلى اكتشافات الغاز، ويناقش التحدّيات التي واجهتها إسرائيل في صياغة سياسة وطنية فعّالة لإدارة هذه الموارد الجديدة والبحث عن موطئ قدم لها في سوق الطاقة الإقليمية.
تتبنّى الكاتبة منهجية متعدّدة التخصّصات، تجمع بين العلوم السياسية والاقتصاد والعلاقات الدولية، لتحليل الديناميات المعقّدة لحوكمة قطاع الطاقة في إسرائيل. كما تعتمد على المناهج النوعية في قراءة الوثائق السياسية، والأطر التنظيمية، والسياق التاريخي لتطوّر الطاقة في هذا الكيان، الذي يحتل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1948.
إسرائيل.. من النُدرة إلى الوفرة الطاقويّة
تبدأ أشواريا كتابها بمقدمة تسرد تاريخ الطاقة في إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، في مرحلة اتسمت بنقص حاد في مصادر الطاقة، وفي ظل محيط إقليمي عربي غني بالموارد لكنه معادٍ سياسيًا، الأمر الذي حال دون اندماجها في أي شبكة إقليمية فاعلة لتبادل الطاقة.
ومن زاويةٍ أوسع، تُناقش الكاتبة اعتماد إسرائيل الكبير على الفحم المستورد في توليد الكهرباء، بوصفه انعكاسًا لتحديات استراتيجية رافقتها منذ أزمة النفط عام 1973، في ظل الحظر النفطي العربي الشامل. وتوضح أن هذه الهشاشة البنيوية، التي تفاقمت مع حرب أكتوبر وما تلاها من حظر نفطي، كشفت عن ضعف استراتيجي في قلب اقتصاد صناعي آخذ في النمو. وقد دفعت تلك الأزمة إسرائيل إلى تبنّي استراتيجية متعددة المسارات لضمان أمن إمدادات الطاقة، تمثّلت في تنويع مصادر الاستيراد، والبحث عن موردين أقرب جغرافيًا، وتسريع عمليات التنقيب عن مصادر محلية، وتأمين الحماية المادية لمنشآت الطاقة المعرّضة للخطر، إلى جانب استكشاف مصادر الطاقة المتجددة، في محاولة للحد من اعتمادها شبه الكامل على الوقود الأحفوري.
وفي هذا السياق، تستعرض الجهود الإسرائيلية المبكّرة للتنقيب عن النفط والغاز داخل أراضيها، مؤكّدة محدودية النتائج التي أسفرت عنها تلك المحاولات. كما تُسلّط الضوء على أثر احتلال سيناء عام 1967 في تحسين وضع إسرائيل الطاقوي، إذ مكّنها من السيطرة على حقول نفط غنية في شبه الجزيرة، ما أسهم في تحقيق اكتفاء نفطي مؤقت لعدة سنوات، وشكّل آنذاك بارقة أمل للدولة اليهودية.
وتُشير الكاتبة إلى أن إسرائيل اعتمدت تاريخيًا على استيراد نحو 98% من احتياجاتها الطاقوية، مما عرّضها لضغوط سياسية واقتصادية من الدول المنتجة للنفط والغاز في المنطقة. وتتناول أيضًا بداية التحوّل الجوهري مع اكتشاف حقول الغاز قبالة سواحلها في أواخر القرن العشرين، بما مثّل بداية تغيير نمط الاعتماد التقليدي على الفحم والنفط، ومهّد لتحوّل جذري في الوضع الطاقوي مع مطلع الألفية الجديدة، عقب اكتشاف حقول الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية للدولة. وجاء التحوّل الأبرز في عامي 1999 و2000 مع اكتشاف حقلي "يام تيثيس"، الذي يحتوي على نحو 1.2 مليار متر مكعب من الغاز، و"نوا"، ما مكّن إسرائيل من تقليص اعتمادها على واردات الطاقة وتعزيز أمنها الطاقوي. وتواصل هذا المسار باكتشاف حقل "تمار" عام 2009، ثم حقل "ليفياثان" الضخم عام 2010، لترتفع احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي من صفر إلى مئات مليارات الأمتار المكعبة، وهو ما أحدث تحوّلًا عميقًا في موازين الطاقة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وفي سياق متصل، تطرح قضية حقل غاز "غزة البحري"، بوصفها مثالًا كاشفًا على تداخل الطاقة بالسياسة. وقد اكتشفته شركة "بريتيش غاز" عام 1999 قبالة سواحل غزة، ويُمثّل المورد الطبيعي السيادي الوحيد الذي كان من شأنه أن يمنح الفلسطينيين قدرًا من الاستقلال الاقتصادي، ويخفّف من اعتمادهم القسري على إسرائيل في قطاع الطاقة. غير أنّ أشواريا تذكر، بشكل عابر، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون استخدم حق النقض (الفيتو) عام 2000 لتعطيل صفقة كانت تقضي بشراء إسرائيل الغاز من هذا الحقل. وقد برّرت الحكومة الإسرائيلية هذا التعطيل، كما يورد الكتاب، باعتبارات أمنية بحتة، قوامها التخوّف من أن تُستخدم عائدات الغاز في دعم قوى مقاتلة مناهضة لإسرائيل.
وتتناول أيضًا اتفاقية النفط الطارئة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تعهّدت واشنطن بموجبها بتزويد إسرائيل بالنفط في حال تعرّضها لحظر أو نقص في الإمدادات. وبرغم تمديد هذه الاتفاقية مرتين، عامي 1994 و2004، تُشير الكاتبة إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما امتنعت عن تجديدها عند انتهاء مفعولها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014. وعليه، يمكن فهم هذا القرار بوصفه تعبيرًا عن واقع طاقوي وجيوسياسي جديد، لا دلالةً على تراجع التحالف الاستراتيجي؛ إذ قادت إدارة أوباما عام 2016، وفقًا لإيشواريا، جهود وساطة مكثّفة لإطلاق حوار طاقوي جديد، تمحور حول تصدير الغاز الإسرائيلي عبر تركيا إلى أوروبا، في محاولة لإنهاء القطيعة التي أعقبت حادثة "مافي مرمرة" عام 2010 بين أنقرة وتل أبيب.[3]
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تُفعّل هذه الاتفاقية فعليًا في أي وقت، فإن حرصها على استمرارها يكشف عن سعيها الدائم إلى الإبقاء على مظلة دعم استراتيجي أمريكي تحسّبًا لأي طوارئ مستقبلية. غير أنّ مرحلة ما بعد انتهاء الاتفاقية شهدت تركيزًا متزايدًا على تطوير قطاع الغاز الطبيعي، مدفوعًا بالاكتشافات الكبرى في شرق البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي عزّز أمن إسرائيل الطاقوي وقلّص اعتمادها على النفط المستورد.
الحوكمة الطاقويّة الإسرائيليّة
في الفصل الثاني، تركز أشواريا على اكتشافات الغاز الطبيعي في إسرائيل وتطوّر الإطار التنظيمي لإدارة هذه الثروة، مقدِّمةً تحليلًا تاريخيًا مفصلًا لمسار الاكتشافات وانعكاساتها على السياسات الحكومية، وما رافقها من تجاذبات بين المصالح العامة والخاصة. وتسلّط الضوء على قانون البترول لعام 1952 بوصفه الإطار القانوني الأول الذي نظّم عمليات التنقيب والإنتاج، مشيرةً إلى أنّ هذا القانون وُضع في مرحلة كانت تعاني فيها إسرائيل ندرةً حادّة في الموارد، فأتاح امتيازات ضريبية سخية للشركات بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع البحث عن مصادر طاقوية جديدة.
غير أنّ هذا الإطار التشريعي لم يكن مهيّأً للتعامل مع التحوّل البنيوي الذي أحدثته اكتشافات الغاز اللاحقة، الأمر الذي استدعى إدخال إصلاحات جوهرية على نظام الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الغاز، إلى جانب صياغة سياسات جديدة تستهدف ضمان أمن الطاقة وتعزيز المنافسة في السوق المحلية. ومع اكتشاف حقول غاز ضخمة، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في منظومة الحوكمة القائمة، بما يضمن حصول الدولة على حصة عادلة من عائدات الغاز وتوجيهها لخدمة الصالح العام.
في هذا السياق، تناقش أشواريا عمل لجنة إيتان شيشنسكي، التي شكّلت محطة مفصلية في تاريخ قطاع الغاز الإسرائيلي، إذ أوصت بتعديل النظام الضريبي، وإلغاء الإعفاءات السخية التي مُنحت سابقًا لشركات التنقيب، وإقرار نظام ضرائب تصاعدية على الأرباح الفائضة، انطلاقًا من مبدأ أن "الموارد الطبيعية ملكٌ للشعب" وينبغي أن تعود عليه بالنفع. وتُبرز الكاتبة أنّ إسرائيل اتخذت، منذ وقت مبكر، خيار إسناد تطوير قطاع الغاز إلى القطاع الخاص، مستفيدةً من الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة.
غير أنّ تجربة اكتشاف واستغلال حقلي "تمار" و"ليفياثان" كشفت، بحسب التحليل، عن توترات قائمة بين أيديولوجية السوق الحرة ومتطلبات المصلحة العامة. فقد أظهر الاعتماد شبه الكامل على آليات السوق، أو ما يُعرف بـ"اليد الخفية"، كيف يمكن أن تُفضي هذه المقاربة إلى نتائج مُجْحِفة، تستحوذ فيها الشركات الخاصة على النصيب الأكبر من الأرباح، فيما تتراجع حصة الدولة والمجتمع من العائدات. وتكشف هذه الحالة عن محدودية نموذج السوق الحرة في إدارة الموارد الطبيعية وتوزيع عوائدها على نحو عادل، إذ يفترض هذا النموذج تحقيق المصلحة العامة تلقائيًا، بينما تُظهر التجربة الإسرائيلية إمكانية تحوّله إلى أداة لترسيخ هيمنة المصالح الخاصة وتعميق اختلالات توزيع الثروة. ويتقاطع هذا الاستنتاج مع أطروحات جوزيف ستيغليتز النقدية،[4] التي تبرز إخفاقات السياسات النيوليبرالية، ولا سيما فيما يتصل بإدارة الموارد العامة والعدالة في تقاسم عوائد الثروات الطبيعية.
واجهت توصيات لجنة شيشنسكي معارضةً شديدة من شركات الغاز، التي رأت فيها "مصادرةً لأرباحها"، وادّعت أنّها ستؤثّر سلبًا في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة، وتُعيق تطوير حقول الغاز الجديدة. غير أنّ الحكومة الإسرائيلية تبنّت، في نهاية المطاف، هذه التوصيات، وأقرّت قانونًا جديدًا لفرض ضرائب على أرباح النفط والغاز، في خطوة عكست تحوّلًا في النظرة إلى الغاز بوصفه موردًا استراتيجيًا، وكشفت عن إدراك متزايد لأهمية إسهامه في رفاه المجتمع.
ولم تكن مسألة التصدير أقلّ إثارةً للجدل من قضية الضرائب؛ فمع اكتشاف حقول غاز ضخمة، برزت تساؤلات حول سُبل الموازنة بين تلبية احتياجات السوق المحلية، واستثمار فرص التصدير لتعزيز الاقتصاد، وتحسين العلاقات الإقليمية. وفي مواجهة هذه الإشكاليات، شكّلت الحكومة لجنة أخرى برئاسة شاؤول تزيمح لدراسة سياسة تصدير الغاز، سعيًا إلى التوفيق بين مصالح الشركات المستثمرة، الساعية إلى تعظيم أرباحها عبر النفاذ إلى الأسواق العالمية، ومخاوف قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي دعت إلى حظر تصدير الغاز وضمان توافر كميات كافية للاستهلاك المحلي. وبعد دراسة معمّقة لسيناريوهات العرض والطلب المستقبلية، أوصت لجنة تزيمح بتحديد حصص للتصدير، مع التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بجزء وافر من الاحتياطيات المكتشفة للاستخدام المحلي، معتبرةً أنّ هذه الكميات كافية لتلبية احتياجات إسرائيل من الطاقة.
غير أنّ هذه التوصيات أثارت جدلًا واسعًا؛ إذ رأى منتقدوها أنّها لا توفّر ضمانات كافية لأمن الطاقة على المدى الطويل، وطالبوا بحظرٍ كاملٍ للصادرات وتوجيه الثروة المستخرجة لخدمة "المصلحة الوطنية". في المقابل، دافعت الشركات المستثمرة عن حقها في التصدير، مؤكّدةً أنّه شرط أساسي لجذب الاستثمارات وتطوير القطاع، ومحذّرةً من تراجع الاستثمار في حال فرض قيود صارمة. "ولم يقتصر هذا الجدل على الساحة السياسية، بل امتدّ إلى القضاء، حيث تقدّمت جهات معارضة بدعوى طعنت فيها في قرار الحكومة تبنّي توصيات لجنة تزيمح، معتبرةً أنّها تمسّ حقوق الأجيال المقبلة، التي قد تواجه نقصًا في الغاز لتلبية احتياجاتها المستقبلية. غير أنّ المحكمة العليا رفضت الدعوى، معتبرةً أنّ القرار الحكومي لا يفضي إلى نضوب فوري للموارد، وأنّه يظلّ قابلًا للمراجعة من قِبل الحكومات المستقبلية".
الغازُ الإسرائيليّ كقاطرة للتنميّة
في الفصل الثالث من كتابها، تستعرض أشواريا التأثيرات الاقتصادية لاكتشافات الغاز على الاقتصاد الإسرائيلي، مقدِّمةً تحليلًا دقيقًا لمختلف القطاعات التي استفادت من هذه الاكتشافات، والدور الذي أدّاه الغاز في تعزيز النمو الاقتصادي. وتُبرز الكاتبة كيف أسهم الغاز في خفض تكاليف توليد الكهرباء، ما انعكس على تقليص أسعارها للمستهلكين وتعزيز تنافسية الصناعة الإسرائيلية، معتبرةً أنّ هذه الاكتشافات مثّلت "ثورة طاقوية" حقيقية.
ويُسلّط الكتاب الضوء على استخدامات الغاز في القطاع الصناعي، ولا سيما في الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعات الأسمدة والحديد والصلب. كما يشير إلى أنّ الغاز الطبيعي أسهم في تطوير صناعات جديدة، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد عليه مادةً أولية، الأمر الذي ساعد على تنويع بنية الاقتصاد الإسرائيلي وتقليص اعتماده على القطاعات التقليدية. وتتناول الكاتبة كذلك استخدام الغاز في قطاع النقل، ولا سيما في تشغيل حافلات النقل العام، بما يحدّ من مستويات التلوث ويحسّن جودة الهواء في المدن، مؤكدةً أنّ "الغاز يوفّر لإسرائيل فرصة الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقلّ اعتمادًا على الوقود الأحفوري".
وفي المقابل، تشير أشواريا إلى أنّ إسرائيل لا تزال في مراحل مبكرة من استثمار العوائد الكاملة للغاز الطبيعي، وذلك لأسباب عديدة، من بينها التأخّر في تطوير البنية التحتية للغاز، خاصة شبكات التوزيع التي تغطّي مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن التردّد في الاستثمار في الصناعات المعتمدة على الغاز بسبب المخاطر السياسية والأمنية، والحاجة إلى سياسات حكومية أكثر فاعلية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.
ولمواجهة مخاطر ما يُعرف بـ"المرض الهولندي"، تناقش الكاتبة فكرة إنشاء صندوق سيادي للثروة، يُستثمر فيه جزء من عائدات الغاز خارج إسرائيل. وترى أنّ هذه الآلية من شأنها حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الغاز، وتوفير مورد مالي مستدام للأجيال المقبلة، بما يضمن حسن إدارة هذه الثروة الطبيعية وعدم استنزافها على المدى القصير.
وتؤكد أنّ اكتشافات الغاز كان لها أثر ملموس في تنشيط الاقتصاد الإسرائيلي، إذ شهدت قطاعات عديدة انخفاضًا في التكاليف وارتفاعًا في الإنتاجية، ما عزّز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. كما تتوقع أن تدرّ الضرائب والعائدات المرتبطة بالغاز إيرادات كبيرة على خزينة الدولة، بما يخلق فرصًا واسعة للنمو في مختلف مفاصل الاقتصاد.
غير أنّ الكاتبة تُحذّر من أنّ التدفق المفاجئ لعائدات الموارد الطبيعية، سواء أكانت نفطًا أم غازًا أم معادن، يحمل مخاطر اقتصادية معروفة، تُعرف بـ"المرض الهولندي" أو "لعنة الموارد" التي سبق الإشارة إليها. وتستحضر في هذا السياق تجربة هولندا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عقب اكتشاف حقل غرونينجن العملاق للغاز عام 1959، حيث أدّى تدفّق العملات الأجنبية إلى ارتفاع قيمة العملة الوطنية وتراجع تنافسية قطاعات التصدير الأخرى، وما رافق ذلك من تباطؤ صناعي وارتفاع في معدلات البطالة.
وتخلص أشواريا إلى أنّ الهدف الجوهري من إنشاء صندوق الثروة السيادي يتمثّل في الحفاظ على ثروة الحاضر لصالح الأجيال القادمة، عبر تحويل الدخل المتأتي من الموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الأرض إلى أصول مالية مستدامة. وتستند الكاتبة إلى أدبيات الاقتصاد وتجارب دول غنية بالموارد، مثل النرويج وتشيلي، للتنبيه إلى المخاوف المتعلقة بتقلّبات أسعار السلع، وما يترتّب عليها من ضرورة تحييد الموازنة العامة عن هذه التقلبات قصيرة الأجل. وفي هذا السياق، يتمثّل الهدف من "ركن الأموال" في الصندوق السيادي في الاحتفاظ بالعائدات خارج الاقتصاد المحلي إلى حين توافر فرص استثمارية مجدية.
الغاز الإسرائيليّ ووهم السلام الاقتصادي
اقتصاديًا، تكتسب اكتشافات الغاز في إسرائيل أهمية محورية؛ إذ إن إمكانات التصدير لا تعزّز أمن الطاقة فحسب، وإنما تمنحها موقعًا متقدمًا في سوق الطاقة الإقليمية. وقد بدأت بالفعل صادرات الغاز إلى دول الجوار، مثل مصر والأردن، مع خطط للتوسّع مستقبلًا نحو أوروبا، ولا سيما في ظل أزمة الطاقة التي تعانيها العديد من الدول الأوروبية.
وقد مكّنت هذه الاستقلالية الطاقوية الجديدة إسرائيل من الانتقال نحو نموذج يُقدَّم بوصفه أكثر استدامة، مع تقليص ملموس في بصمتها الكربونية. إذ يشكّل الغاز اليوم نحو 40% من إجمالي استهلاك الطاقة، ويوفّر قرابة 70% من احتياجات البلاد من الكهرباء. ولا تقتصر الآثار الاقتصادية لهذه التحولات على قطاع الطاقة وحده، بل تمتد إلى تحفيز فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي. وتشير أشواريا إلى أنّ تطوير البنية التحتية لاستخراج الغاز ومعالجته ونقله من شأنه أن يدفع النمو في القطاعات المرتبطة، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا. غير أنّ هذا المسار يظل مشروطًا بالقدرة على تحقيق توازن دقيق بين المكاسب الاقتصادية ومتطلبات الاستدامة البيئية، وهو تحدٍّ متجذّر في بنية النظام الرأسمالي ذاته.
وعلى الرغم من الفرص الكبيرة التي قد تتيحها اكتشافات الغاز في المنطقة للبنان، ولا سيما تلك التي تشمل الحقول المتاخمة لإسرائيل، فإن التوترات السياسية المستمرة ما تزال تعيق أي تقدّم فعلي. فرغم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية عام 2022، والتي كان من المفترض أن تمهّد لتعاون طاقوي أوسع، حالت الأزمات الاقتصادية، والفساد الداخلي، وتضارب المصالح السياسية دون استثمار هذه الموارد على نحو فعّال. وعلى الرغم من أنّ الاتفاقية منحت لبنان السيطرة على حقل "قانا"، فإن العوائق الاقتصادية والسياسة منعت تحقيق استفادة حقيقية من هذا المورد.
أما في الحالة الفلسطينية، فلا يقلّ المشهد الطاقوي تعقيدًا وخطورة. إذ تشير أشواريا إلى أنّ تطوير حقل "غزة البحري"، على الرغم من احتوائه احتياطيات واعدة، ظلّ مقيّدًا بشدة بفعل السياسات الإسرائيلية. كما واجهت محاولات السلطة الفلسطينية التفاوض على صفقات لشراء الغاز من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي عراقيل سياسية وأمنية متعدّدة، ما حال دون أي تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.
وفي الفصل الرابع، تنتقل أشواريا إلى مناقشة الآثار الاستراتيجية لاكتشافات الغاز على المنطقة، مستعرضةً التحولات في المشهدين السياسي والاقتصادي، وإمكان توظيف الغاز أداةً دبلوماسية لتحسين علاقات إسرائيل بدول الجوار. وتؤكد، في أكثر من موضع، أنّ الغاز قد يشكّل "جسرًا للتعاون، عبر بناء شبكة من المصالح المشتركة والتخفيف من حدّة النزاعات". وتتناول في هذا السياق اتفاقية تصدير الغاز إلى الأردن، التي واجهت معارضة شعبية واسعة، لكنها أسهمت، في نهاية المطاف، في تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين.
كما تناقش إمكانات تصدير الغاز إلى مصر، التي تمتلك محطتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، معتبرةً أنّ هذا المسار قد يعزّز موقع مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز. وتربط أشواريا هذا التعاون بأهمية التفاهم الأمني بين البلدين، ولا سيما في ضوء التحديات المشتركة في شبه جزيرة سيناء. غير أنّ التجربة المصرية، منذ تسعينيات القرن الماضي، تكشف تعقيدات الموازنة بين المصالح الاقتصادية المتأزمة والحسابات السياسية المعقدة. فيما سعت مصر لاستغلال فرص التعاون الطاقوي مع إسرائيل لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة وتعزيز أمنها الطاقوي، ظلّ هذا التعاون محاطًا بتحفّظات شعبية وسياسية واسعة، وهو ما تعكسه الاتفاقية الأخيرة لتصدير الغاز، التي دخلت حيز التنفيذ أواخر كانون الأول/ديسمبر 2025.
وتسلّط الكاتبة الضوء كذلك على العقبات التي تعترض تصدير الغاز إلى تركيا، في ظل التوترات السياسية بين الجانبين والنزاع القائم حول قبرص، مشيرةً إلى أنّ نجاح هذا المسار "يظل مرهونًا بتحسين العلاقات السياسية وحلّ النزاع القبرصي". غير أنّ هذا التحليل، في مجمله، يبدو وكأنّه يعاني قدرًا من "قِصر النظر الجيوسياسي"، إذ يمنح الأولوية للبُعد الاقتصادي، متجاهلًا في كثير من الأحيان ثقل الصراعات التاريخية، والتعقيدات السياسية، والتوترات الدينية التي تحكم مسار العلاقات الإقليمية.
ويتعزّز هذا القصور مع التفاؤل المفرط الذي تُبديه أشواريا إزاء قدرة الغاز الإسرائيلي على تحويل المنطقة إلى واحة للتعاون والسلام. فوفقًا لنظرية النظام العالمي لإيمانويل والرشتاين،[5] قد يؤدّي التعاون الاقتصادي في مجال الطاقة إلى إعادة إنتاج علاقات الهيمنة، إذ تستفيد الدول "المركزية" على حساب الدول الطرفيّة. كما تُحذّر نظرية التبعية من أنّ العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة قد تُفضي إلى تكريس التخلف وتعميق التنافس بين القوى الإقليمية.
وتبرز تجربة قطر، بوصفها من أبرز القوى العربية الرائدة في سوق الغاز العالمي، مثالًا على سعيها المستمر لتعزيز مكانتها عبر توسيع علاقاتها الاقتصادية. ومع ذلك، واجهت الدوحة ضغوطاً سياسية من بعض الدول العربية الأخرى بسبب طبيعة علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل. تجلى هذا الأمر بوضوح في أوائل الألفية الجديدة، عندما وقّعت قطر مذكرة تفاهم مع الجانب الإسرائيلي لاستيراد الغاز الطبيعي. وعلى الرغم من هذه الضغوط، استمرت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بشكل غير معلن حتى عام 2003؛ ففي ذلك العام، أعربت قطر عن استعدادها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، مشترطة تحقيق تقدم ملموس في عملية السلام مع الفلسطينيين.
وعلى الرغم من أنّ اكتشافات الغاز في شرق المتوسط تُقدَّم، في الكتاب، بوصفها فرصة لتحقيق "السلام الاقتصادي"، فإن هذا الطرح يغفل حقيقة أنّ التعاون التجاري وحده لا يكفي لتجاوز صراعات استعمارية بنيوية. فهذه الاكتشافات تتم في سياق دولة استعمارية استيطانية إحلالية تسفك دماء الشعب الفلسطيني وتواصل سياساتها القمعية ونهب موارده، ولا يمكن فصل البعد الاقتصادي عن هذا الواقع السياسي والأخلاقي.
إضافة إلى ذلك، يفتقر الكتاب إلى معالجة جادة للتأثيرات البيئية المترتبة على استكشاف الغاز وإنتاجه، وهو نقص لافت في ظل تصاعد الاهتمام العالمي بقضايا المناخ والبيئة. فدراسة الآثار البيئية للصناعات الاستخراجية باتت ضرورة ملحّة، لا سيما في منطقة هشّة بيئيًا كشرق المتوسط. وبصورة عامة، يظلّ السلوك الإمبريالي الاستيطاني الإحلالي في فلسطين، الممتد منذ عام 1948، عائقًا أمام أي تعاون إقليمي حقيقي أو سلام مستدام، وهو ما يتجلّى بوضوح أكبر في ضوء أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما تلاها من جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
غاز المتوسط بعد 2023: من "السلام الاقتصادي" إلى جيوسياسية الإبادة والارتهان
تكشف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن تحوّل نوعي في بنية الاستعمار ذاته، يتجاوز ما تناولته أدبيات "الطاقة السياسية" حتى صدور كتاب أشواريا عام 2019، ومقاربتها الطموحة لفكرة "السلام الاقتصادي" عبر الغاز. فعلى الصعيد البيئي، تشير التقديرات إلى أنّ الانبعاثات الكربونية المباشرة الناجمة عن العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى كانون الثاني/يناير 2025 بلغت نحو 1.89 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون،[6] وهو رقم يفوق إجمالي الانبعاثات السنوية لما يقارب ستًّا وثلاثين دولة، ما يجعل من الحرب حدثًا بيئيًا كونيًا، لا مجرّد صراع إقليمي عابر.
وعلى المستوى الطاقوي، كان للحرب أثرٌ مؤقّت تمثّل في قرار وزارة الطاقة الإسرائيلية، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقف الإنتاج في حقل "تمار" القريب من غزة لأسابيع بسبب المخاطر الأمنية، الأمر الذي انعكس آنذاك على صادرات الغاز إلى مصر. غير أنّ هذا التعطيل سرعان ما جرى تجاوزه؛ إذ استؤنف الإنتاج بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2023، لتدخل إسرائيل لاحقًا مرحلة توسّع ملحوظة في صادراتها الغازية. ففي عام 2024، ارتفعت الصادرات بنسبة 13.4%، لتصل إلى نحو 13.2 مليار متر مكعب إلى كلٍّ من مصر والأردن، فيما بلغ إجمالي الإنتاج قرابة 27 مليار متر مكعب. وتُوِّج هذا المسار بتوقيع صفقة استراتيجية في آب/أغسطس 2025، بقيمة 34.6 مليار دولار، لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "ليفياثان" إلى مصر حتى عام 2040، عقب تصديق رئيس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق في 17 كانون الأول/ديسمبر 2025، في سياق ضغوط أمريكية مباشرة.
غير أنّ الأخطر من هذا التوازي بين الإبادة والتوسّع الاقتصادي هو اندماجهما في إطار سياسي وقانوني دولي أعاد إنتاج العنف بوصفه "أداة إدارة" لا انحرافًا عن النظام القائم. فبعد الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة "اليوم التالي" في غزة، وما تلاها من مخرجات اجتماع شرم الشيخ، أقدمت إسرائيل على إنهاء وقف إطلاق النار قبل بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، في مسار سُجّل خلاله أكثر من 700 انتهاك موثّق لترتيبات التهدئة. ويكشف ذلك أنّ وقف إطلاق النار لم يكن سوى آلية مؤقّتة لإعادة ترتيب الوقائع الميدانية، لا مدخلًا فعليًا لإنهاء الحرب.
وفي هذا السياق، جاء الغطاء الدولي الأكثر دلالة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حين اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2803، الذي صادق على خطة ترامب ذات البنود العشرين بشأن غزة، قبل الدخول في مرحلتها الثانية. وقد أُقرّ القرار بثلاثة عشر صوتًا، مقابل امتناع عضوين فقط هما روسيا والصين. ولا يكتفي هذا القرار بتأييد الخطة الترامبية/ السلام الترامبي، بل يدعو إلى إنشاء هيئتين انتقاليتين لإدارة القطاع: "مجلس السلام" للإشراف على المساعدات والإعمار والإدارة اليومية، و"قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة" تتولى الأمن ونزع سلاح حركة حماس إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، من دون أي إشارة إلى الإبادة المستمرة منذ عامين، أو تقديم مسار واضح للمساءلة عنها.
ولا يمكن فهم هذا المسار إلا في ضوء ما وصفه جمال حمدان مبكرًا بـ"أعلى مراحل الاستعمار الاستيطاني"،[7] حيث يتكامل العنف العسكري مع البنية الاقتصادية والاستراتيجية في مشروع واحد يقوم على نفي الوجود السكاني الأصلي. فالاستعمار الصهيوني، وفق تحليل حمدان، هو استعمار ثلاثي الأبعاد: استيطاني، واستراتيجي، واقتصادي. وهو ما تؤكده الحالة الراهنة، إذ تُدار الإبادة في غزة بالتوازي مع إعادة تثبيت إسرائيل مركزًا إقليميًا للطاقة، وتُشرعن هذه العملية عبر أطر دبلوماسية واقتصادية وقانونية دولية تُقدَّم بوصفها "خطط سلام" أو "ترتيبات استقرار"، كما يتجلّى في جنوب لبنان وجنوب سوريا. ويمكن توصيف هذا السياق بوصفه شكلًا من "الاستعمار الأمريكي الجديد"، حيث تسعى "الجهة الراعية" بلا كلل لتكريس مصالح "المشروع الاستيطاني"، بما يعيد إنتاج علاقة الهيمنة بأدوات معاصرة. وفي المحصّلة، يعيدنا هذا الواقع إلى الخلاصة القاطعة التي صاغها جمال حمدان في كتابه المرجعي "استراتيجية الاستعمار والتحرير"، حين كتب: "إنّ الشرق العربي لا يمكن أن يتّسع للعرب ولإسرائيل معًا؛ فوجود أحدهما نفيٌ لوجود الآخر، ولكي يبقى أحدهما، لا بدّ أن يذهب الآخر".