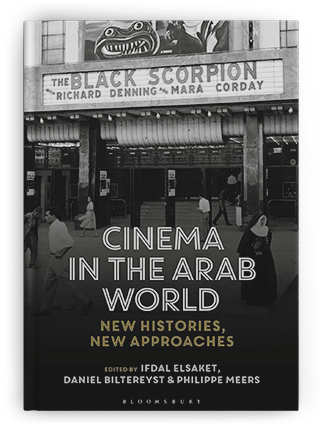تقدم ويندي بيرلمان، في كتابها "وطن صنعناه: أصوات من الشتات السوري الجديد"، سردًا عميقًا لمحنة السوريين الذين أُجبروا على ترك ديارهم. وتتتبّع قصص هؤلاء الأفراد وهم يسعون لبناء هوية جديدة في ظلّ الخسارة، وتستكشف معاني الوطن المتعدّدة التي تبلورت في نفوسهم.
إبراهيم فوزي[1]
في عام 2011، خرج السوريون إلى الشوارع مطالبين بالحرية، فقوبلت احتجاجاتهم السلمية بقمع عسكريٍّ وحشيٍّ أسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين. وبعد ثلاثة عشر عامًا من الحرب الأهلية، كُتبت صفحة جديدة في تاريخ سوريا؛ إذ أسقطت المعارضة السورية نظام بشار الأسد في غضون اثني عشر يومًا، لينتهي عهده الطويل والقمعي نهايةً دراماتيكية بهروبه من البلاد. غير أنّ هذا التحوّل السياسي لم يُنهِ آثار الحرب العميقة، التي ظلّت حاضرة في حياة ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها.
أدّت الحرب الأهلية إلى تهجير نحو سبعة ملايين سوري خارج حدود البلاد، وإلى نزوح أكثر من سبعة ملايين آخرين داخلها، لتتشكّل بذلك واحدة من أكبر موجات اللجوء في العصر الحديث. ومن قلب هذه التجربة القاسية، وبالاعتماد على مئات المقابلات الشخصية، يقدّم كتاب "وطن صنعناه: أصوات من الشتات السوري الجديد"[2] الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024، أصوات العشرات من السوريين الذين أُجبروا على الفرار من وطنهم، ويتتبّع قصصهم وهم يحاولون إضفاء معنى على خسارتهم وشتاتهم، وبناء وطنٍ جديد لأنفسهم.
يقف خلف هذا العمل ويندي بيرلمان، أستاذة العلوم السياسية في جامعة نورثويسترن، ومؤلِّفة خمسة كتب تناولت سياسات الشرق الأوسط. ويأتي كتابها هذا مكمِّلًا لكتابها السابق "عبرنا جسرًا وارتعد: أصوات من سوريا"، الذي وثّق، بأصوات مَنْ عاشوا التجربة، قصة الحراك السوري للإطاحة بالنظام الدكتاتوري، والحرب الأهلية التي أعقبته.
ينفتح كتابها "وطن صنعناه" على سؤال مركزي حول مفهوم الوطن، ليسرد بعض السوريين المتفرقين في خمس قارات قصص مغادرة الوطن، وفقدانه، والبحث عنه، والعثور عليه أحيانًا، أو العجز عن استعادته أحيانًا أخرى. وتكشف رحلاتهم عن الألم والانتصار على حد سواء؛ فبينما يحنّ بعضهم إلى سوريا، لا يرغب آخرون في العودة إليها أبدًا. يعثر بعضهم على صداقات جديدة، ويكتشفون الإيمان والثقة بالنفس، في حين يتعرّف آخرون على المعنى الحقيقي للرضا. من خلال هذا النسيج المتشابك من الأصوات، يتشكّل معنى جديد للوطن.
يحمل مفهوم الوطن في اللغة العربية ظلالًا متعددة من المعاني، ما يجعله عصيًّا على الإحاطة الكاملة. فقد انطوى عبر تاريخه على دلالات متنوّعة نتجت عن محاولات متعدّدة لتأطيره، فضلًا عن كونه مفهومًا مُسيّسًا منذ بروز الاستعمار والقومية في أراضٍ شكّلت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية. ويتضمّن هذا المفهوم، كما بيّنت وداد القاضي في دراستها الشهيرة حول طرق التعبير عن الوطن وحنين المرء إليه كما صُوٍّر في الأدب العربي القديم، معاني العائلة والقبيلة والعشيرة والأصدقاء؛ إذ ينجذب الإنسان إلى الروابط العميقة التي تشدّه إلى وطنه. وتغذّي هذه الألفة خبراتٌ جسدية ومشاعر وذكريات متراكمة تُشكّل وجدان الفرد. كما يمكن لفكرة الوطن أن تشير، جغرافيًا، إلى إقليم تنقّلت فيه القبائل، أو إلى مأوى حضري، أو مدينة، أو منطقة، أو حتى دولة.[3]
الفرضية والمنهجية
تنطلق الفرضية الرئيسة لبيرلمان من أن اللاجئين يملكون الكثير مما يعلّموننا إيّاه عن مفهوم الوطن بوصفه فكرةً مجرّدة، وواقعًا معيشًا، وحلمًا بعيد المنال. فشهاداتهم تشكّل نقطة انطلاق لفهم تعقيدات النزوح القسري واللجوء، كما تؤكد أن اندماجهم في المجتمعات الجديدة التي يعيشون فيها إنما هو عملية ديناميكية يتغيّر فيها اللاجئون والمجتمعات المضيفة على حدٍّ سواء. ومن أبرز ما يميّز عملها قدرتها على إجراء المقابلات بعناية فائقة، مقرونةً باهتمام عميق بإنسانية السوريين اللاجئين وتجاربهم الفردية.
ينقسم الكتاب إلى سبعة أجزاء هي: "الرحيل"، و"الرحيل.. مرة أخرى"، و"البحث"، و"الفقد"، و"البناء"، و"الانتماء"، و"العيش". وتستند بيرلمان في تقديمها للكتاب، وفي معالجة كل قسم من أقسامه، إلى مزيج من النظرية السياسية، والفلسفة، والأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع. وتعكس هذه الأقسام مراحل الرحلة التي يخوضها كل شخص، وجهودهم المتقاطعة للعثور على معنى للوطن، كاشفةً عن تنوّع هائل في مساراتهم وتصوراتهم له.
تعتمد منهجية الكتاب على المقاربة الإثنوغرافية، غير أن بيرلمان تقدّمها بأسلوب يجعل كل قصة تبدو مستقلة بذاتها، من دون أن تُدرَج ضمن إطار بحثي صارم. وهو ما يمنح "وطن صنعناه" جاذبية سردية تجعله أقرب إلى الرواية في أسلوبه، لكنه يتجاوزها تأثيرًا وألمًا؛ لأن القصص التي يرويها تنبع من تجارب واقعية عاشها أصحابها.
أجرت بيرلمان أكثر من مئتي مقابلة على مدار اثني عشر عامًا، لكنّها لم تتمكن من تضمين الغالبية العظمى منها في الكتاب، كما خضعت المقابلات التي أدرجتها لاختصارٍ كبير. وفي حديث لها بجامعة بوسطن، وصفت بيرلمان تجربتها بأنها كانت مؤلمة ومبتكرة في آنٍ واحد، وتحدّثت بصراحة عن التعقيدات الأخلاقية التي رافقت عملها؛ إذ عبّرت عن قلقها الشديد من أن تتسبّب في إيلام السوريين الذين أجرت معهم المقابلات، وحرصت على أن يكون جميع المشاركين مستعدين وراغبين في مشاركة تجاربهم. ومن بين الاستراتيجيات التي اعتمدتها في اختيار المشاركين، أن طلبت من معارفها السابقين دعوة أصدقائهم وأقاربهم؛ لأن الدعوة حين تأتي عبر علاقة وثيقة قد تمنح أولئك اللاجئين حرية أكبر في القبول أو الرفض.
أمثلة من قصص اللاجئين
عبر صفحات الكتاب، يسرد سوريون مُشتّتون في خمس قارات قصص مغادرة الوطن، وفقدانه، والبحث عنه، والعثور عليه. وتكشف هذه الرحلات عن مزيج معقّد من الألم والانتصار في آنٍ واحد، وسيجد كل قارئ شخصية تظلّ عالقة في ذاكرته. أمّا بالنسبة لي، فكانت شخصية "عقبة" هي الأكثر حضورًا.
عندما وصل عقبة إلى مدينة تروجين في ألمانيا، استخدم "ترجمة جوجل" لكتابة رسائل إلى مجلس المدينة، والموظفين، والقس، متسائلًا — بلغة ألمانية ركيكة لكنها مفهومة — عن سبل التطوّع والمشاركة في المجتمع. قوبلت رغبته في المساعدة بالصمت، بل وسألته امرأة إذا كان هناك نساء أو أطفال في مأوى اللاجئين الذي يقيم فيه، وحين أجاب بأنه يضمّ رجالًا فقط، لم تهتم. واجه عقبة الصورة النمطية للاجئين بوصفهم نساءً وأطفالًا محتاجين، لا شبابًا قادرين على الإسهام والعطاء.
بدأت الأبواب تُفتح له تدريجيًا بمساعدة أحد السكان المحليين، ويدعى "إرنست". وسرعان ما تعرّف إلى امرأة مسنّة تُدعى "أوما"، وهي كلمة ألمانية تعني "الجدة". كانت أوما قد فقدت زوجها، وأصبحت بحاجة لمَنْ يساعدها في الطلاء، ونقل الأثاث، وبعض الأعمال المنزلية الأخرى. تطوّع عقبة في دار لرعاية المسنين، وبدأ يبني ثقته بنفسه، ويكوّن علاقات جديدة، قبل أن ينضمَّ إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي في تروجين. وبعد ذلك، حصل على وظيفة في شركة ألمانية كانت ترسله أحيانًا إلى لبنان للعمل مع اللاجئين السوريين هناك. التحقت به خطيبته من سوريا، وتزوّجا، وكانت أوما تستضيف زوجته خلال فترات سفره. وقد رأت في عقبة حفيدًا أرسله الله إليها من سوريا بعد فقدان زوجها.
وإلى جانب هذه القصة، يورد الكتاب شهادة "كريم"، وهي شهادة تفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول مفهوم الوطن، والتهجير، والبحث عن معنى في أعقاب الصدمة. يصف كريم مشاركته في الثورة السورية، مشيرًا إلى مواجهته الغاز المسيل للدموع بـ"البيبسي"، ويتحدّث عن شعور الاحتجاج بوصفه تجربة غيّرت حياته، ومنحته إحساسًا بتحقيق شيء جوهري بعد زمن طويل من الإرهاق. يروي كريم أيضًا قصة اعتقال صديقه "محمد"، ويصف حزن والدته بعد وفاته متأثرًا بإصاباته الناتجة عن التعذيب. تسلّط شهادة كريم الضوء على خسارة الأوطان، وقمع السلطات، والتحوّلات العميقة في علاقة السوريين بوطنهم بعد الثورة.
جروح الحرب، وآلام التهجير: رحلة نحو الشفاء
يُعدّ هذا الكتاب عملًا عن التهجير في المقام الأول، غير أنّه يقدّم رؤية مغايرة تمامًا للصورة النمطية السائدة عن اللاجئين؛ فالسوريون هنا يظهرون بوصفهم أناسًا عاديين وأذكياء، يختبرون الفرح والغضب، ويملكون طاقات كامنة لا تختزلها معاناتهم. إن القصص التي يتضمّنها هذا العمل قصص إنسانية لأشخاص فرّوا من العنف والاضطهاد، وسعوا إلى الأمان. كما تتنوّع الرحلات التي يعرضها بتنوّع أصحابها، ويكشف كثير من هؤلاء عن إمكانات كبيرة للانخراط الفاعل في المجتمعات التي استقرّوا فيها. ويعلّق بعضهم صراحة على الصورة النمطية للاجئين، كما يفعل "مصري" المقيم في طوكيو باليابان، إذ يقول: "حتى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تصوّر اللاجئين على أنهم يائسون ويعانون، وذلك لجمع التبرّعات. إن هذا جزء من المشكلة؛ فهم لا يركّزون على مواهب اللاجئين وإمكاناتهم.. أريد تغيير ذلك".
تتخلّل هجرة هؤلاء اللاجئين محاولات متكرّرة للعثور على وطن وإعادة بناء الحياة، غير أنّ مأساة اللجوء تحرم بعضهم من القدرة على خلق ما يمكن تسميته وطنًا؛ فخطر اللجوء يظلُ قائمًا، ويمكن أن يواجه أيّ شخص في أيّ مكان، وإن كان يتغيّر في حدّته وطبيعته. ومن ثمّ، تقترح بيرلمان ضرورة تحويل تركيزنا من السعي إلى منع اللجوء فحسب، إلى دعم اللاجئين في مساعيهم لإعادة بناء أوطانٍ جديدة تلبّي احتياجاتهم وتنسجم مع تطلّعاتهم.
في الختام، تكشف بيرلمان، من خلال أصوات اللاجئين السوريين، عن تعقيدات اللجوء، وخسارة الأوطان، والرغبة الإنسانية العميقة في الانتماء. يركّز كتابها على إنسانية اللاجئين وقدرتهم على الصمود، ويتحدّى التصوّرات المبسّطة لمفهوم الوطن. فكثيرٌ من السوريين، حتى أولئك الذين وجدوا بعض ملامح الوطن في بلدان أخرى، ما زالوا يواجهون السؤال المؤلم ذاته: "هل تريدون العودة إلى الوطن؟".
وبالنسبة لملايين السوريين الذين خرجوا في مظاهرات عام 2011، شكّل اللجوء فقدانًا للمكان وحرمانًا من وطنٍ كانوا يطمحون إلى بنائه بحرية. أمّا أطفال الثورة السورية، فإن اللجوء لم يكن بالضرورة بداية المنفى، بل محطة أخرى في مسار طويل وشاق من البحث عن الانتماء؛ فبناء وطن جديد عملية تتطلّب جهدًا ومرونة. إن خلق شعور داخلي بالوطن يظلّ تحدّيًا بالغ الصعوبة للاجئين، لكنه في الوقت نفسه ضرورة وجودية لا غنى عنها.
لقد فتح انتصار المعارضة السورية في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 الباب أمام عودة بعض اللاجئين إلى وطنٍ مثقل بالذكريات. ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عاد أكثر من مليون لاجئ سوري إلى وطنهم خلال العام الماضي. كما أوضحت ممثّلة المفوضية في لبنان "كارولينا ليندهولم بيلينغ" أنّ ما يُقدَّر بنحو 400 ألف لاجئ سوري في لبنان قد عادوا إلى سوريا، فيما أكّد وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، في تصريح أدلى به في الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ عدد السوريين الذين عادوا طوعًا من تركيا إلى الأراضي السورية خلال العام الماضي بلغ 550 ألف شخص. علاوة على ذلك، أشارت المفوضية إلى أنّ استطلاعًا أظهر أنّ 80% من اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن ولبنان ومصر والعراق يرغبون في العودة إلى وطنهم يومًا ما.