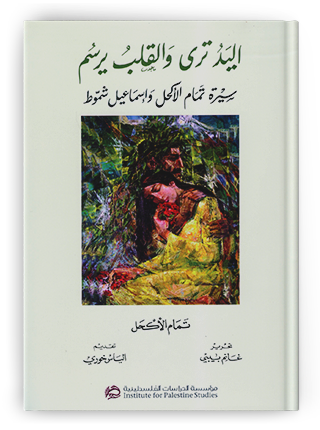يقدّم نزيه الأيوبي في كتاب "تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط" مقاربة لفهم جذور نشأة الدولة والاستبداد وغياب التحوّل الديمقراطي في المنطقة، مبتعدًا عن التفسيرات القومية أو الثقافوية. يعتمد على تحليل تاريخي للاقتصاد السياسي والتشكيلات الاجتماعية، مستفيدًا من المفاهيم الماركسية مثل "نمط الإنتاج"، لكنه يتجاوزها نحو رؤية أكثر تركيبًا تربط بين الاقتصاد والثقافة والدولة. يتناول الكتاب، بالتفصيل، تحوّلات الدولة في عدد من الدول العربية، ويطرح أدوات تحليلية تجمع بين الليبرالية والماركسية لفهم تشكّلاتها الحديثة. ومن خلال هذا الإطار، يشرح الأيوبي لماذا فشلت الدولة العربية في التحوّل إلى دولة حديثة تمثيلية، على غرار التجربة الغربية.
ياسمين قعدان [1]
يُعدّ كتاب نزيه الأيوبي "تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط"، [2]مرجعًا تأسيسيًا وجامعًا نظريًا وبيانيًا في مفهمة الدولة العربية. تأتي نسخته المترجمة إلى العربية عام 2010 في 970 صفحة موزعة على اثني عشر فصلاً موسّعًا عن موضوع الدولة العربية. يقدّم الأيوبي، في هذا العرض الكثيف، دراسة مقارنة عن الدولة في العالم العربي، بأسلوب متأنٍّ يستند إلى أطر مفاهيمية ونظرية، يسعى من خلالها إلى تأطير مفهوم الدولة بشكل عام، وتجلياته الخاصة في السياق العربي. تنطوي هذه المقارنة على تعميمٍ غير مُختزل لفهم الظاهرة، وعلى تخصيصٍ حذر يتجنّب الوقوع في الجوهرانية.
يوضح الأيوبي أن المراجع العربية تمثّل أساسًا في دراسته، وأن محاورته لها تأتي ضمن الأطر النظرية الغربية (الفرنكفونية، والأنجلوساكسونية، والألمانية)، دون إسقاط أيٍّ منها، وإنما بصياغة توليفةً مفاهيمية جديدة تُقدّم فهمًا أوسع لمختلف الظروف والمحددات التاريخيّة، والاقتصاديّة، والسياسيّة، والثقافيّة. يركّز الكتاب على عدد من الدول العربية، هي: مصر، سوريا، العراق، المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، تونس، والجزائر، كما يشير بشكل أقل تركيزًا على كلٍّ من: اليمن، لبنان، والمغرب.
تشريح الدولة فصلًا فصلًا
في مستهلّ الكتاب، وتحديدًا في الفصل الأول، يوضح الكاتب مقصده من مفهوم "تضخيم الدولة"؛ والذي يقوم على مسألتين نظريتين. تأتي الأولى لفهم توسّع الدولة داخل المجال العام الحكومي والقطاع الخاص ضمن الأداء الوظيفي، في اقتراح يقترب من أطروحة "الدولة مفرطة النمو"، والتي صاغها حمزة علوي؛ إذ يرى الأيوبي أن الدولة العربية غدت مفرطةً في التمدّد خلال العقود الأربعة الأخيرة- تبعًا لدراسته المنشورة عام 1995.
وتحمل كلمة "تضخيم" مفارقةً تتعلّق بتقدير قوة الدولة في السياق العربي، إذ أن هذه الدولة لا تستند في تشكّلها إلى أسس سوسيو-تاريخية داخلية. فيصفها الأيوبي بأنها ليست قوية بالمعنى البنيوي لأنها تفتقر إلى البنية التحتية للدولة تبعاً لمفهوم مايكل مان، وتفتقر إلى الهيمنة الأيديولوجية وفق التصوّر الغرامشياني. ولذا يُطبق عليها صفة التشاركية، التي تتراوح بين الأسس التنظيمية للمصالح الشعبوية/التعبوية كما في مصر، و"العضوية التضامنية الجماعية" كما في المملكة العربية السعودية. ويؤدي مفهوم آخر دورًا مركزيًّا في هذه التشاركية، وهو مفهوم مهم عند الكاتب، هو "التمفصل"، الذي يقدم فهمًا للتشكيلات الجديدة التي تنشأ عند تقاطع الفردانية الفلسفية، والطبقات الاجتماعية، والعلاقة مع المجتمع المدني، كما حدث في المجتمعات الرأسمالية الغربية. ويركّز الأيوبي على عقد الثمانينيات من القرن العشرين بوصفه مرحلة مفصلية في التفكير بموضوع الدولة عند المفكرين العرب، بعد هيمنة مفهومي الأمة الإسلامية والقومية العربية على الفكر والواقع. فالدولة القُطرية، في نظره، لم تدخل حيّز التشكّل والوعي العربي إلا متأخرة.
يبرز في هذا الطرح التوجّه الماركسي في تحليل ظاهرة الدولة. وعلى الرغم من محاولات الكاتب انتقاد التصوّر الماركسي التقليدي للدولة بوصفها انعكاسًا للبنية التحتية، إلا أنه يستدعي أدوات ماركسية أخرى، مثل مفهوم "التمفصل" في الماركسية البنيوية، وانحيازه الغرامشياني في تناول مفهوم "الهيمنة" حيث يطوّر مفهوم "التشاركية" بديلاً عن مفهوم الشرعية في الدولة لدى ماكس فيبر، الذي يقوم على "احتكار العنف" من قبل الدولة. كما يُبقي الأيوبي على مفاهيم مركزية في الاقتصاد السياسي، مثل "علاقات الإنتاج" و"نمط الإنتاج" وغيرها، لتكون جزءًا من تحليله المركّب.
يشير الأيوبي إلى أن أحد العوامل المؤدية إلى تضخّم الدولة هو تأخّر نشوء نمط الإنتاج الرأسمالي، ما أدى إلى زيادة تدخل الدولة في المجتمع. ويقدم لاحقًا هذا المحور بتفصيل أكبر عند شرحه لمفهوم "التمفصل"، الذي يبيّن كيف تنتج أنماط اقتصاديّة وسياسيّة من التفاعل بين نمط الإنتاج الرأسمالي وأنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية، أو غير الرأسمالية، السائدة في المجتمعات العربية. ويُظهر كيف أن هذه الأشكال لم تُمحَ، بل استمرت وتعايشت بفعل متغيرات عديدة، مثل الاستعمار أو المحاكاة والتقليد. ويشير كذلك إلى أن نمط "الجزية" أو "الأتاوة"، الذي كان سائدًا في بعض السياقات، شكّل عائقًا أمام التراكم الرأسمالي، وأسفر عن قيام نظام تداولي يعتمد بشكل كبير على العالم الخارجي.
كما يتناول الكتاب الأثر الثقافي على شكل الدولة في السياق العربي، بدايةً من الأصل اللغوي لكلمة "دولة" في اللاتينية والعربية، وما تعكسه من تناقض الحالة السياسية، بين الاستقرار في اللاتينية، وتقلبات وفقدان السلطة بالعربية. بالإضافة إلى ذلك، يبرز مفهوم "الأمة" أو "الجماعة"، الذي يأخذ منحى أكثر أهمية من مفهوم الدولة في المجتمعات العربية والإسلامية.
يضيف الكاتب إلى كل ما سبق نقاشًا تحليليًا معرفيًا ومفاهيميًا مهمًا ومثيرًا للاهتمام حول معنى "الحرية" في السياق العربي، وكيف تأثّر هذا المعنى باستقاء مفهوم الدولة من الأثر الاستعماري الفرنسي والبريطاني- الليبرالي، واللذين لا يحملان العمق الجدلي نفسه الذي طُرح في الفلسفة الألمانية حول الحرية، كما عند هيغل في تصوره للدولة الأخلاقية مثلاً. ويشير الأيوبي إلى أن مفهوم "العدل" يهيمن في الثقافة الإسلامية العربية على معنى الحرية. يطرح مثالاً على هذا النقاش من خلال كتابات عبد الله العروي عن الدولة العربية، إذ يرى العروي أنها جسد وعضلات دون روح أو عقل، ولا تتضمن الحرية بالمعنى الهيغلي، وإنما نشأت عن سيرورتين: الأولى نتيجة تطوّر الدولة السلطانية الاستبدادية، والثانية سيرورة إصلاحية استمدت عناصرها من ترتيبات إدارية واتصالات حديثة من الغرب، إلى جانب تحسينات في مجال الزراعة والتجارة. وقد انطلقت هذه السيرورة تاريخيًا مع التنظيمات والإصلاحات العثمانية في القرن التاسع عشر، وكانت مدفوعة لتعزيز سلطة السلطان العثماني من جهة، وبضغط من القوى الاستعمارية لتوسيع السوق الإمبريالية وإضعاف القوى المحلية من جهة أخرى. كل ذلك أسهم في بقاء الدولة غريبة عن المجتمع، والميل أكثر إلى مفهوم الأمة والخلافة. كما أن مفهوم الحرية في السياقين العربي والإسلامي ارتبط تاريخيًا بحالات تقع خارج نطاق الدولة أو في مواجهتها، مثل البداوة، أو القبيلة، أو التصوف.
يحاول الأيوبي من خلال تبسيط الإطار المفاهيمي وبعد استعراضه العديد من النظريات والكتابات، أن يؤكد أن أي محاولة لفهم أشكال الدولة وتحوّلاتها في السياق العربي تتطلب الجمع بين التحليل الفرداني- الليبرالي والتحليل الطبقي- الماركسي في آن معًا. وعلى هذا الأساس، يقوم مفهوم "التشاركية" بوصفه شبكة من العلاقات المتداخلة بين الدولة والمجتمع، وبين العام والخاص، بما يربط بين الاقتصادي والسياسي والثقافي ضمن سياق التاريخ الاجتماعي لكل بلد على حدة.
ويقوم الفصل الثاني معنونًا بـ "أنماط الإنتاج وأصول الدولة العربية- الإسلامية"، على أن هناك إقصاء معين لمختلف أنماط الإنتاج التي وجدت في المنطقة العربية من حيث تأثيرها على السلطة، كمثل نمط الإنتاج الإروائي- الزراعي، وكذلك نمط الإنتاج البدوي. يشير الأيوبي في هذا السياق إلى مساهمات ابن خلدون فيما يخص تحليله للصراع بين البدو والحضر على السلطة. كما يتناول نمط الإنتاج "الفتحي"، الذي يقوم على الغنائم من الفتوحات الإسلامية بالإضافة إلى الجزية التي كانت تُفرض على غير المسلمين. ويُبيَّن في هذا السياق كيف تحوّل نمط الإنتاج من طابعه التجاري-القبلي السابق للإسلام في مكة، إلى نمطٍ "فتحي/تراكمي ضرائبي" قائم على الغنائم، والتخزين، ومراكمة الثروة مع الفتوحات الإسلامية. وتُستعرض لاحقًا تحوّلات أنماط الإنتاج في العصور الأموية والعباسية والعثمانية، حيث تمفصلت بين الإقطاعي، والزراعي، والعسكري، والضرائبي، بما يُظهر أن النظام السياسي كان عاملًا حاسمًا في تشكيل هذه الأنماط وتغيّرها. ويُطرح في هذا الإطار تساؤلٌ نظري حول العلاقة بين البنية الفوقية (السياسة) والبنية التحتية؛ إذ تُقدَّم مقاربة تُخالف التصوّر الماركسي التقليدي الذي يرى أن البنية التحتية هي التي تغير النظم السياسية والثقافية والأيدلوجية، ويُقترح بدلًا من ذلك أن السياسة قد تكون هي الفاعل الأسبق في إعادة تشكيل أنماط الإنتاج.
أما الفصل الثالث، فيتناول نمط الإنتاج الاستعماري في المجتمعات العربية، والتي طبقت سياسات "اللبرلة الاقتصادية"، مما شجع على نشوء الأوليغارشية المحلية. وقد نتج عن ذلك نمط من الطبقية يختلف في نشأته عن البرجوازية الأوروبية في سياق نمط الإنتاج الرأسمالي، إذ اتّسمت هذه الطبقات المحلية بالارتباط برأسمالية الأطراف أو التابعة، مع استمرار الأنماط الإنتاجية التقليدية. ويشير كذلك إلى بروز الكتل الوطنية التي ظهرت على السطح نتيجة لهذه التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي نفسها التي واجهت الاستعمار، ولكنها لم تستطع مواجهة التغيرات الاقتصادية التي حدثت، فسوريا مثلًا مع منتصف الخمسينيات، دخلت بنمط إنتاج "رأسمالية الدولة" ضمن فخ نمط الإنتاج الاستعماري. ومما ذكر آنفًا، ينتقل الأيوبي في الفصلين الرابع والخامس إلى تناول نشوء فكرة القومية العربية وفشلها، موضحًا كيف أن الانهيار العثماني سمح في ظهور هذا الخطاب، لكنه في الوقت ذاته أسهم في تقويضه، إذ لم يرافقه نشوء كتلة موحّدة ومتضامنة. كما هيمن مفهوم الدولة القطرية على هذا الخطاب الوحدوي، ما انعكس بدوره على أشكال الحكم السياسية عربيًا.
يسلّط الفصل السادس الضوء على موضوع الجمهوريات الراديكالية الشعبوية في العالم العربي، خصوصًا تلك التي وصفت نفسها بأنها "اشتراكية". ويستفيض الأيوبي في طرح تساؤلات عن الأنظمة السياسية والاقتصادية التابعة لهذه الأنظمة، ويقترح أنّ الاهتمامات الرئيسية للدول العربية الراديكالية كانت سياسية بالدرجة الأولى، كما هو الحال في التجارب الناصرية، والبعثية، والبورقيبية، وجبهة التحرير الوطني في الجزائر. أما الاشتراكية، فيرى أنها لم تكن سوى وصف ملحق أُضفي على هذه الأنظمة، ولم تُجسَّد فعليًا على أرض الواقع. بل إنّ ما حدث، بحسب تحليل الأيوبي، هو أنّ هذه الأنظمة السياسية العربية، رغم تبنّيها للخطاب الاشتراكي، أسهمت في تعزيز نمط الإنتاج الرأسمالي. أما في الفصل السابع، فيتوسّع النقاش ليشمل دول الخليج الريعية، حيث يُوضّح كيف أسهمت "هبة النفط" في تعزيز شرعية الحُكّام وإطالة عمر الأنظمة الحاكمة، مع ظهور أصوات معارضة خافتة قد تتعالى إذا ما تراجعت تلك الهبة. وفي الفصل الثامن، يتناول الكاتب العلاقات المدنية والعسكرية، مشيرًا إلى تضخّم الإنفاق العسكري في الدول العربية، لا سيّما خلال عقد الثمانينيات، وإلى الدور البارز الذي لعبته المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. ويستعرض في هذا السياق أمثلة متعددة عن الانقلابات والتمردات العسكرية التي شهدتها الأنظمة العربية ما بعد الاستعمار. وهذا يحيلنا إلى الفصل التاسع، الذي يشير فيه الأيوبي إلى أن الأنظمة العربية اختارت نموذج "البقرطة" كوسيلة للتنمية، مستعرضًا نماذج لدول تأثرت بالإرث الاستعماري الفرنسي أو البريطاني، وهو ما انعكس على شكل مؤسساتها الإدارية والسياسية. وفي الفصل العاشر، ينتقل النقاش إلى مسألة الخصخصة في البلدان العربية، حيث يجادل الكاتب بأن موجة الخصخصة لم تكن نتاج مراجعة فعلية لأداء القطاع العام أو لكفاءة إدارته، بل جاءت كردّة فعل على الأزمات المالية التي واجهتها الدولة، ونتيجة للضغوط التي مارستها وكالات النظام العالمي.
وصولاً إلى الفصل الحادي عشر، والذي نتوسّع في مناقشته في هذه المراجعة، نظرًا إلى أنّه يتناول سؤالاً راهنًا ومستمرًا في المجتمعات العربية حول الديمقراطية. يبدأ الأيوبي هذا الفصل بالتساؤل عمّا إذا كانت الديمقراطية ممكنة في الشرق الأوسط، ويصف فيه أحوال بعض الدول العربية من حيث ممارساتها وسياساتها على المستوى الديمقراطي. كما يجادل بأنّ للديمقراطية مستلزمات ثقافية وفكرية؛ فهي ليست مجرد شكل من أشكال الحكم، بل تقليد ثقافي وفكري متجذّر.
في تشريح التعثّر الديمقراطي العربي
ينتقد الأيوبي مجموعة من الادعاءات التي ترى في الديمقراطية خصيصة ثقافية غربية، نشأت في سياق تطوّر أوروبا التاريخي، بدءًا من الإقطاع مرورًا بالإصلاح الديني والتنوير وصولًا إلى الثورة الفرنسية. ويرفض التصور القائل إن منطقة الشرق محكومة تاريخيًا بثقافة استبدادية تفتقر إلى مفاهيم الحرية، أو أنّ مصطلح "الأحزاب السياسية" يحمل دلالات سلبية في السياق الإسلامي، أو أنّ الإسلام بطبيعته يعادي الديمقراطية ويميل إلى السلطوية/الشمولية. يقدّم الأيوبي في المقابل مجموعة من المجادلات حول خصوصية ثقافة الشرق، التي تقوم على مفهوم الجماعة، وقيم العصبية والتشاركية، بعكس مفاهيم اللبرلة الغربية. وبأن "الثقافة العربية الإسلامية تحمل معها قيم متناغمة أو متناشزة مع الديمقراطية في آنٍ واحد، اعتمادًا على المجتمع الخاص، والمفصل التاريخي"[3]. ويشير إلى أنّ هذه الثنائية المتناقضة ظهرت بوضوح في الثمانينيات مع صعود "الإسلام الأصولي"، الذي استخدم أدوات الديمقراطية للوصول إلى الحكم، رغم عدائه المعلن لها، كما حدث مثلًا في الجزائر.
فيما يتعلق بالمستلزمات الاجتماعية والاقتصادية للديمقراطية، يجادل الأيوبي بأن الديمقراطية حُصرت في المجتمعات الرأسمالية التقدّمية، في حين أن حالة التمفصل التي عرفتها بلدان الشرق الأوسط لم تُفضِ إلى نشوء طبقة أو أيديولوجيا مهيمنة تضمن قيام نظام سياسي مستقر. ونتيجة لذلك، اتّسمت الدول في هذه المنطقة بما يسميه "الدولة الضارية"، بسبب هشاشتها البنيوية والأيديولوجية، بحيث أصبح التعبير عن المصالح يتمّ بصورة مباشرة، من دون وسائط مؤسسية، وغلب على العلاقة بين الدولة والمجتمع طابع التناقض بدلًا من التكامل. كما يربط الأيوبي بين الحالة الاقتصادية، ومستوى التنمية التصنيعية، ومدى ارتباط الدولة أو تبعيتها للاقتصاد العالمي، وموقع الدولة ضمن النظام العالمي "دول نامية، دول متقدمة"، وبين إمكانية المطالبة بالديمقراطية؛ خصوصًا في ضوء نمو الثروة في القطاع الخاص، وارتفاع مستويات الضرائب، بوصفها من بين المحددات التي تدفع نحو الدمقرطة. ويشير إلى أن التحول الديمقراطي، بحسب هذه الدراسات، غالبًا ما يرتبط بعاملين: الأزمة المالية للدولة، والعولمة. إلا أن الأيوبي يلفت أيضًا إلى أنّ الأزمة الاقتصادية قد تؤدي، في حالات أخرى، إلى تعزيز النزعات السلطوية أو حتى الفاشية، كما حدث في تركيا وغانا وكوريا. ومن جهة أخرى، قد تمثّل الهيمنة الغربية أحد المحفزات الرئيسية للدفع باتجاه الديمقراطية، رغم أن الغرب كثيرًا ما تصرّف بانتقائية في التزاماته السياسية ومواقفه من حقوق الإنسان، إذ وقف في حالات عديدة إلى جانب حكّام استبداديين، كما في الأردن وإيران.
ينتقل الأيوبي بعد ذلك إلى تناول مسألة نشوء الديمقراطية في ضوء العلاقة الاقتصادية بين الدولة والمجتمع، لا سيّما من حيث تمفصل القطاعين العام والخاص، ومدى سيطرة الدولة أو تدخّلها بالمنحى الاقتصادي، إضافة إلى طبيعة الدولة الزبائنية في هذا السياق، ودورها في تلبية احتياجات الأفراد. ويشير إلى أن المنطقة الرمادية الواقعة بين القطاعين العام والخاص تمثّل المجال الذي يتشكّل فيه المجتمع المدني؛ إذ إن إمكانيّة الفصل بينهما تتيح لهذا المجتمع أن يظهر بوصفه وسيطًا بين الدولة والمجتمع. غير أن هذه العلاقة تظلّ معقّدة؛ إذ تنشأ بين ما تفرضه البرجوازية من مصالح، وبين علاقتها بالدولة التي قد تسعى إلى تحجيم القطاع العام مع الإبقاء عليه، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعظيم فائض أرباحها من خلال الهيمنة على المجالين السياسي والإداري. ويؤكّد الأيوبي أن التوتّر يبقى قائمًا بين الحقلين السياسي والاقتصادي، وبين المجالين العام والخاص. كما يشير إلى وجود تعبئة سياسية ضمن مجال الأعمال الإسلامية، الذي يشكّل قطاعًا بديلًا من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مفصولًا عن تحكّم برجوازية الدولة، كما تجلّى ذلك، مثلًا، في نمو هذا القطاع في مصر.
ثم ينتقل إلى مناقشة أنواع الديمقراطية، لتكون أولها ما يسمّيه "الديمقراطية التجميلية" أو "الشكلية"، وهي تنشأ من اعتقاد خاطئ بأن تبنّي هذا الشكل سيجذب انتباه الدول الكبرى، ويدفعها إلى تعزيز التجارة مع الدول الأقلّ حظًّا، بل وربما مساعدتها. ويُشير إلى أن هذه الظاهرة ظهرت في القرن التاسع عشر في البرازيل والبرتغال تحت شعار "من أجل أن يراها الإنجليز"، وتحوّلت لاحقًا في نسختها المعاصرة إلى "من أجل أن يراها اليانكيز". وقد يستمر هذا الشكل في الحفاظ على بعض ممارسات التعددية، كما حدث في فترة حكم السادات في مصر.
يناقش الأيوبي، تحت عنوان لافت، مفهوم "سياسات الشوارع"، في إشارة إلى أشكال التظاهر التي تعبّر بها فئات اجتماعية مختلفة عن رفضها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المجحفة. وقد تبدأ هذه الاحتجاجات بتظاهرة عمّالية أو طلابية، ثم تتوسّع لتشمل فئات أوسع تطالب بتغييرات على المستويين الاقتصادي والسياسي، وقد تتحوّل أحيانًا إلى ثورة تجتاح البلاد بأكملها، كما حدث في إيران، والجزائر، وتركيا. وتؤدي هذه الحركات في بعض الأحيان إلى الإطاحة بالنظام السياسي أو إلى فرض إصلاحات عليه، غير أن فعاليتها غالبًا ما تكون مشروطة بوجود امتداد أو وسيط سياسي داعم، مثل الأحزاب أو النقابات. فحين تكون هذه الحركات ذات طابع احتجاجي صرف لا مطلبي، يسهل على الدولة احتواؤها أو القضاء عليها بسرعة. ويتطرّق الأيوبي كذلك إلى علاقات أخرى تسهم في تعزيز خطابات جديدة على مستوى الدولة، مثل توسعة المجال القانوني والقضائي، واستغلال القانون من قِبَل أطراف مختلفة لتحقيق مصالح بعينها. كما يناقش دور مجموعات المصالح، والكيفية التي تنخرط بها التعدّدية من خلال إنشاء برامج أو اتحادات نقابية متنوعة، يمكن أن تستفيد من لحظات الضعف السياسي للدولة لتؤسّس داخلها مجالات للخصخصة.
الحالات القطرية
ضمن عنوان "الحالات القُطرية"، يشير الأيوبي إلى أن مسارات الدمقرطة تحدث ضمن نمطين من الأنظمة. النمط الأول يظهر في مجتمعات سمحت بحدوث التصنيع والتمايز البنيوي بين الطبقات والمصالح، كما هو الحال في تركيا ومصر وتونس. أما النمط الثاني، فيتجلّى في مجتمعات تتسم بدرجة عالية من "التمفصل"، حيث تتيح الترتيبات التوافقية أو التشاركية نشوء صيغ أقرب إلى التعددية، كما في لبنان أو اليمن.
في الحالة المصرية، يشير الأيوبي إلى أنها كانت من الدول الرائدة في مسار التحوّل الديمقراطي خلال الستينيات والسبعينيات، حيث سُمح للأحزاب السياسية بالتشكّل. إلا أن انتخابات عام 1984 في عهد مبارك شابها قدر من الغرابة، خصوصًا في ما يتعلق بنظام التمثيل النسبي؛ إذ جرى ضمّ أصوات الأحزاب الضعيفة، التي لم تحصد عددًا كافيًا من الأصوات، إلى الحزب الفائز، ما عزّز من تفوّق الحزب الحاكم التابع لمبارك. وقد أثار هذا الترتيب جدلًا واسعًا حول هيمنة الحزب الحاكم على نتائج الانتخابات. كما تباينت التحالفات السياسية بين الأحزاب الأخرى، وشهدت الساحة استقطابًا بين الريف والمدن، كما هو الحال مع حزب وفد والإخوان المسلمين.
أما في تونس، فقد شكّل إسقاط حكم الحبيب بورقيبة عام 1987 أحد أبرز محفّزات التعددية السياسية، بعدما حُرِمت البلاد من هذه التعددية طيلة ثلاثين عامًا من حكمه. وقد شهدت فترة بن علي توسعًا في مشاركة الأحزاب، والنقابات، والاتحادات، إلا أنّ هذا الانفتاح لم يترسخ طويلًا؛ فقد خَبَت الآمال في التحوّل الديمقراطي بفعل ممارسات النخبة السياسية، واستمرار الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما أفسح المجال أمام تنامي حضور الجماعات الإسلامية في المجال السياسي. ومع ذلك، استمرّ حكم بن علي، على غرار بورقيبة، في احتكار السلطة.
في النموذج الأردني، ظلّت العملية الانتخابية معلّقة منذ عام 1967 حتى عام 1989، إلى أن دفعت مجموعة من الضغوط الاقتصادية وسياسات صندوق النقد الدولي الشعبَ الأردني إلى المطالبة بتغيير الحكومة وإجراء إصلاحات ليبرالية. وقد شهدت تلك الانتخابات صعودًا ملحوظًا لصوت التيارات الإسلامية في السياسة الأردنية. تلا ذلك تشكيل "الميثاق الوطني الأردني"، الذي نصّ على السماح بتشكيل الأحزاب السياسية شريطة التزامها بالعملية الديمقراطية، وعدم تدخلها في القوات المسلحة أو أجهزة الأمن، وألا يكون لها دعم خارجي. وقد شكّلت هذه السياسات محاولة لفصل الملك عن مسؤولية الفشل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، غير أنها أخضعت الأردن لتأثير جملة من العوامل السياسية الخارجية، مثل حرب الخليج والقضية الفلسطينية.
أما في سوريا، فقد كانت "الحركة التصحيحية" عام 1970 لحظةً مفصلية أثّرت على مسار التحوّل الديمقراطي، إذ قاد الفصيل البراغماتي بقيادة حافظ الأسد انقلابًا ضد الفصيل اليساري الذي كان يقوده صلاح جديد. ترافقت المرحلة التالية للانقلاب مع تخفيف بعض القيود الاقتصادية على القطاعات التجارية والتصنيعية، إلا أن ذلك لم يعنِ تخلي الدولة عن تدخلها في الاقتصاد. وقد لاقت سياسات الأسد الاقتصادية والتمركز المدني اعتراضًا من كبار ملاك الأراضي، وساندهم في ذلك بعض التجار والحرفيين، بالتوازي مع صعود الإسلام السياسي، الذي يمكن فهم تمرد حماة عام 1982 في سياقه. كما اتسمت انتخابات عام 1990 بعودة التمركز الصارم لحزب البعث واحتكاره للسلطة التنفيذية، في ظل نهج سياسي وأيديولوجي لا يفسح المجال أمام التعددية الحزبية الحقيقية. ورغم تنوع الفئات التي انخرطت في الأحزاب، من تجار وإسلاميين وطبقة وسطى وبرجوازية قديمة وجديدة، فإن مشاركتها السياسية كانت في الغالب مصلحية، تهدف إلى الدخول في بنية الدولة لا إلى مراقبتها أو محاسبتها.
في المقابل، تميّزت الحالة العراقية بموسمية ظهور اللبرلة وغياب أي تحرّك جاد نحو الديمقراطية، إذ اختُزلت الأخيرة ضمن هيمنة حزب البعث. وقد كان لحرب العراق مع إيران تأثير كبير في المسار الاقتصادي، حيث اتجهت السياسات نحو زيادة الخصخصة، وترافق ذلك مع تغيّر في خطاب صدام حسين السياسي، إذ بدأ يَعِد بإجراءات أكثر ديمقراطية وتعددية حزبية. يوضّح الأيوبي أن هذا الخطاب لم يكن إلا محاولة لكشف خصوم النظام وملاحقتهم ثم تصفيتهم، أو لتقديم متنفس للشعب المنهك بالحروب والمآسي الاقتصادية، أو لسبب ثالث، يراه الأيوبي الأقوى، يتمثّل في رغبة النظام بجذب انتباه الغرب عبر التظاهر بالديمقراطية، خاصة بعد الانتهاكات التي ارتكبها نظام صدام حسين، وازدياد الموارد المالية بعد الحرب مع إيران.
ينتقل الأيوبي بعد ذلك إلى مناقشة الديمقراطية في الجزيرة العربية والخليج، مبتدئًا بالمملكة العربية السعودية. ويتساءل: هل هناك ديمقراطية ممكنة في المملكة؟ يستعرض في هذا السياق المسار التاريخي للنظام السياسي السعودي، وتأسيس مجلس الشورى الذي صدر قانون تأسيسه عام 1992، لكنه بقي معلّقًا لبعض الوقت، تبعًا لطبيعة المجتمع القَبَلية والمناطقية، التي قد تكون أحد أسباب تأخر تفعيله. وقد شُكّل المجلس عام 1993، وضمت عضويته مجموعة من التكنوقراط وحَمَلة الشهادات الجامعية. ويشير الأيوبي إلى تصريحات متعددة للملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود تؤكد على "حدود" اللبرلة، وتشير إلى أن الديمقراطية لا تناسب خصوصية المجتمع السعودي. كما يُحيل إلى جملة من القضايا الجدلية التي تميّز النظام السعودي، مثل وضع النساء، وحقوق القيادة، والسياسة العامة، إضافة إلى سطوة "شرطة الآداب".
أما الكويت فقد امتلكت خبرة مبكرة في الانتخابات والحياة السياسية، بل حملت أعلى التوقعات في مجال الديمقراطية بين دول الخليج. ومع ذلك، برزت إشكاليات واضحة، أهمها حصر عملية الانتخاب بالذكور ممن تجاوزوا سن الحادية والعشرين، ما أدى إلى إقصاء النساء كليًّا، إلى جانب قصر التصويت على من استطاعوا إثبات نسبهم إلى الكويتيين منذ عام 1920. ومع اندلاع حرب الخليج الثانية، واجهت العائلة الأميرية انتقادات شديدة بسبب سياسة الفرار وعدم المقاومة. ومع ذلك، لم تتمكّن التجمعات السياسية الكويتية بعد التحرير من فرض تغيير جوهري على السلطة، إذ بقيت العائلة الأميرية متماسكة، وأعادت النظام السياسي إلى سابق عهده.
بدت الإمارات العربية المتحدة أقلّ انفتاحًا مقارنة بجارتيها البحرين وقطر، اللتين شهدتا إصلاحات سياسية في مجال الديمقراطية والانتخابات. أما الإمارات، فلم تشهد تغييرات سياسية ملموسة بعد حرب الخليج، وظل "المجلس الوطني الاتحادي" قائمًا بصيغته الاستشارية التي أُقرّت عام 1972، وهو يضم ممثلين عن حكّام الإمارات المختلفة دون سلطة تشريعية فعلية.
وتحت عنوان "المغامرة اليمنية"، التي تُعد من أقل التجارب حظًا من الناحية الاقتصادية، شهدت اليمن أول انتخابات حرة وشاملة في عام 1992، على خلاف معظم دول الجزيرة العربية والخليج، ما يثير تساؤلات عمّا إذا كانت تمثّل تجربة ديمقراطية حقيقية، أم استثناءً يؤكّد القاعدة! يرى الأيوبي أن اليمن تمتاز بكونها أرض "التمفصلات"، وبيئة لتجربة توافقية/تشاركية إلى حدٍّ ما. فقد عزّز الرئيس اليمني علي عبد الله صالح هذا النهج الديمقراطي، وشُكلت لجان شبه تشاركية ضمّت قوى "ثورية"، و"شعبية"، و"قومية"، كما أُقرّ "الميثاق الوطني" عام 1982. تبع ذلك تأسيس ما يقارب 400 جمعية تعاونية ونقابية، إضافة إلى مجالس استشارية قبلية وريفية، ما يعكس ازدهار المجتمع المدني في تلك المرحلة. وأسهمت تحويلات نحو مليون ونصف يمني يعملون في الخارج في تحقيق ازدهار اقتصادي شمل القطاعين الحكومي والخاص. عملت الدولة أيضًا على تطوير النظم الإدارية والبيروقراطية، فيما أسهمت التعاونيات في تعزيز الخدمات التعليمية والصحية في الأرياف. واستفادت الحكومة من إيرادات الجمارك الناتجة عن الاستيراد، وفرضت نظامًا ضريبيًا، وسعت إلى ترسيخ مركزية سياسية مدنية.
وبالاستفادة من سياسات اللبرلة، حاول النظام الاجتماعي تقليص نفوذ البنية القبلية وتعزيز النهج التقدّمي في مختلف المناطق. ويصف الأيوبي الديمقراطية التي اتسمت بها اليمن عقب انتخابات عام 1993 بأنها "ديمقراطية المواثيق". لكن، بعد ذلك العام، اتّهم قادة الحزب الاشتراكي حكومة علي عبد الله صالح بالتحوّل نحو السلطوية، كما حمّلوه مسؤولية اغتيال العديد من كوادر الحزب. وفي عام 1994، شنّ صالح حربًا على من وصفهم بـ"القوى المعادية للشرعية والوحدة"، انتهت بفرض الوحدة بين الشمال والجنوب بقوة السلاح، لتدخل الديمقراطية حينها في طور من التحييد لصالح خطاب الوحدة.
من يملك الفضاء العام؟
في قسم العام/خاص، الأهلي/المدني، يشير الأيوبي إلى أن المجتمعات العربية تتسم بجملة من التعقيدات، مثل التعددية المتزايدة، وتعدد مجموعات المصالح، ومواجهة الجماعات الإسلامية للدولة في محاولاتها الإمساك بتيار الديمقراطية وفق نهجها الخاص. ويُضاف إلى ذلك ضعف المجال الاقتصادي، لا سيما في القطاع الخاص لصالح هيمنة الدولة. كل هذه التعقيدات تطرح سؤالًا ملحًا حول حدود وفاعلية المجتمع المدني في الدول العربية.
يبدأ الأيوبي بتعريف المجال المدني بأنه: "ذلك الجزء من الميدان العام الذي لم تستعمره بيروقراطية الدولة وشبكة الإدارة العامة". وبرأيه، فإن هذا هو ما يشكل تخوم مأسسة المجتمع المدني. ويعود ليتساءل عن إمكانية تطور ثقافة مدنية في العالم العربي. فالديمقراطية لا تتعلق فقط بالتمثيل والمشاركة، بل تشمل أيضًا المعارضة والتنافس.
أما الإسلاميون، فيحملون سمة المعارضة في الدول العربية، وبالتالي أصبحوا جزءًا من عملية الدمقرطة من حيث الممارسة والسياق الموضوعي. وقد حقق الإسلاميون في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات نتائج ملحوظة في الانتخابات بمختلف الدول العربية، من مصر والأردن إلى الجزائر وغيرها، كما رأينا سابقًا. في تلك المرحلة، بدأ الصعود الإسلامي ينافس الدولة على الفضاء العام؛ فبينما سيطرت الدولة عليه اقتصاديًا، تحدّاها الإسلاميون على المستوى الأخلاقي، مستحضرين الأخلاق بوصفها جوهر السياسة.
وهنا تكمن صلب المشكلة: إذ لم تتعامل لا الدولة ولا الإسلاميون مع المجال المدني على المستوى السياسي، مما أبقى "المجال المدني" السياسي في فقر مدقع. ينتقل الأيوبي بعد ذلك إلى نقاش نظري بين الطاهر لبيب، وبرهان غليون، وعبد الرحمن الكواكبي، حول علاقة المجتمع المدني العربي بمفاهيم مثل الاستعمار، والحرية، والاستبداد، والمقاومة. ونتيجةً لذلك، بقيت العلاقة بين الدولة والمجتمع علاقة إقصاء، لا علاقة تكامل.
يبقي الأيوبي سؤاله مفتوحًا حول إمكانية اندراج الإسلاميين فعليًّا ضمن منظومة ديمقراطية واقتصادية، على نحو ما فعلته الكالفينية مثلًا. ليجيب: ربما، فالإمكانيات مفتوحة، لكن ليس في المستقبل القريب. وهذا تساؤل مهم جدًا، غير أنني أتأمل في كمّ العنف الذي رافق الصعود الإسلامي في ثمانينيات القرن الماضي، والذي تجدد في "أحداث رابعة" في مصر. فهل بالإمكان حقًا التخلص من ذاكرة دموية تعود لتنتج نفسها عند كل مفترق، وسط مفاهيم متناقضة، يفترض أن تصبّ في صالح إعلاء الديمقراطية؟ وهل نحن، كعرب، نُعيد تمثيل دور الجلاد لأنفسنا في سبيل تحقيق نظام سياسي ديمقراطي، أو في محاولة خلق بنية مجتمع مدني ذات منشأ وطابع غربي، كان أصلًا سببًا في تشويه مجتمعاتنا تحت ذريعة اللحاق بركب "النظام العالمي" وهيمنة الغرب؟ وسؤال أكثر مرارة يطلّ: هل سنستمر في الدوران حول جملة "من أجل أن يرانا اليانكيز!" ضمن منظومة الاقتصاد السياسي العالمي، وأفكار التنمية، التي تُبقي علينا السلاسل نفسها من التبعية والقيود؟
في خاتمة الكتاب، وتحديدًا في الفصل الثاني عشر، يفكك الكاتب سمات تُنسَب إلى الدولة، مثل: "الدولة القوية"، أو "الصلبة"، أو "الضارية". ومن خلال هذا التفكيك، يسعى الأيوبي إلى إثبات أن الدول العربية ليست دولًا قوية بالمعنى الحقيقي، بل هي "دول ضارية". يعتمد الأيوبي في طرحه على معيار اندماج الدولة مع الشعب بوصفه علاقة توافقية. ففي حين تبني الدول العربية علاقتها بالمجتمع على أساليب قسرية عبر أجهزتها العسكرية، وتُنتج أدوات ضبط تُوهم بالقوة، يرى الأيوبي أن القوة الحقيقية تكمن في كيفية استخلاص الدولة للفائض الاقتصادي. فالدولة الضارية، كما يوضح، تنتزع ملكية الفائض من المجتمع باستخدام وسائل شبه قسرية. أما الدولة القوية، فهي القادرة على تحصيل الفائض من خلال ضرائب مباشرة، تُفرض استنادًا إلى مبادئ قانونية واقتصادية ومحاسبية واضحة ومُعترف بها. ويُشير هذا الطرح إلى أن الاستبداد وانسداد الأفق الديمقراطي يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بحالات الركود الاقتصادي. ويختتم الأيوبي كتابه بالتأكيد على أن على النخب السياسية العربية أن تستوعب هذا الدرس سريعًا، انطلاقًا من فكرة جوهرية مفادها أن الدولة والمجتمع لا يُبنيان إلا معًا، لا أحدهما على حساب الآخر.