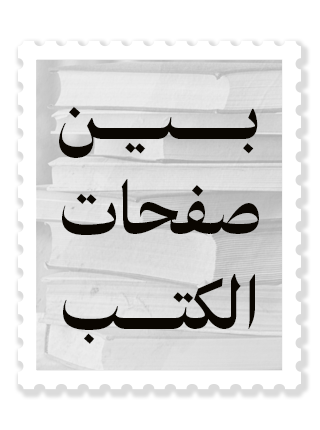يتقاطع المسار السينمائي لداود عبد السيّد، في كتاب "داود عبد السيّد: سينما الهموم الشخصية"، مع المسار الشخصي والفكري لعلاء خالد، ليشكّلا معًا ما يشبه سيرة فنية وفكرية مزدوجة. يتأمل خالد سينما داود بوصفها مشروعًا إبداعيًا يتراوح بين الذاتي والجمعي، ويتنقّل بين الهزيمة والحلم، والواقع والخيال، مركّزًا على "الفرد العادي" بوصفه نافذة لاكتشاف الذات والمجتمع في آن واحد.
محمد عبد العظيم علي[1]
صدر كتاب "داود عبد السيّد: سينما الهموم الشخصية"[2] للكاتب علاء خالد في عام 2024، وجاء في جزأين يُشكّلان بنيته الأساسية: يتألف الجزء الأول من مقدمة وثلاثة عشر مقالًا، يتناول كلٌّ منها جانبًا من مشروع داود عبد السيّد السينمائي، بينما يضم الجزء الثاني مجموعة من الحوارات مع المخرج نفسه، إضافةً إلى حوارات مع مهندس المناظر أنسي أبو سيف، والموسيقار راجح داود، اللذين شكّلا مع عبد السيّد حالة من التآلف والنجاح الفني.
تعود جذور العلاقة بين علاء خالد وداود عبد السيّد إلى عام 1993، بعد أن شاهد خالد فيلمي: "البحث عن سيد مرزوق" و"الكيت كات"، إذ ترك الفيلمان أثرًا بالغًا في مسيرته الشخصية والفكرية. ومنذ ذلك الحين، بدأت حوارات متعدّدة بينهما، تطوّرت لاحقًا لتُشكِّل النواة التي انبنى عليها هذا الكتاب. لذلك، يرى خالد أن الكتاب يتموضع في تلك المسافة الفاصلة بينه وبين داود، ويعدّه أقرب إلى "عمل إبداعي" منه إلى كتاب نقدي، بل هو "قراءة شخصية".. في فن وأفكار سينما داود عبد السيّد.
سينما الواقعية الجديدة.. من الهزيمة إلى المقاومة
يستهلّ خالد كتابه بإضاءة على جيل "الواقعية الجديدة" في السينما، وهو الجيل الذي انشغل برصد تفاصيل الفرد العادي وهمومه الشخصية، إلى جانب رصد الواقع الذي يعيشه، من دون انحياز مسبق لنموذج محدد يُفسّر من خلاله الواقع وعلاقة الفرد به. وربما كان الدافع الأهم وراء ظهور هذا الجيل وهذه الرؤية الجديدة هو هزيمة عام 1967، التي أسّست علاقته بالسينما على أساس نقد "الواقع القديم" الذي أدّى إلى الهزيمة، والسعي إلى إعادة تشكيله. هكذا، جاء مخرجو جيل الواقعية الجديدة ليردّوا على الهزيمة، كلٌّ بطريقته، عبر إزاحة الستار عن واقع مغاير، وفرد جديد لم يكن مرئيًا في السينما التقليدية.
يرى خالد نفسه ابنًا لهذا الجيل؛ الباحث عن الحقيقة والاختلاف الذي يقرّبه من ذاته، ومن حلمه الشخصي في الحياة. غير أن هذا الحلم تشكّل في مناخ مهزوم بأثر رجعي، ليس فقط جراء هزيمة عام 1967 التي عايشها صغيرًا، وإنما بفعل سلسلة من الهزائم الاقتصادية والفكرية والروحية التي عرفها المجتمع لاحقًا.
في ظل هذه الخلفية، منحته الهزيمة، والمراجعات الفكرية التي تلتها، أفقًا فكريًا ووجدانيًا يُشبه ما منحته لمخرجي جيل الثمانينيات من مشروع سينمائي ناضج ومتماسك، يدافع عن قضايا، ويتكئ على ذاتية مشبعة بالبُعد الاجتماعي، حتى وإن لم يكن هذا البُعد ظاهرًا بشكل مباشر في أفلامهم. أسهم هذا الجيل في خلق شبكة مشاعر جديدة لا تفسر الواقع بقدر ما تضع الفرد في صدارة المشهد، مع إضافة لمسة شعرية نابعة من عمق هذا الفرد، ضمن سمات عامة مشتركة، تطرح علاقة الفرد بالجماعة داخل واقع جديد يتأرجح بين الواقعية والفانتازيا.
يحتلّ الشارع موقعًا أساسيًا في سينما هذا الجيل، ذات الطابع التوثيقي. كما أن فكرة "البحث" تُعدّ محورًا مشتركًا بين كثير من أفلامه، سواء كان بحثًا بوليسيًا كما في فيلم "ضربة شمس" لمحمد خان، أو رحلة استنارة يخوضها البطل كما في "البحث عن سيد مرزوق" لداود عبد السّيد، أو شعور الفرد بالمسؤولية الجماعية كما في "سواق الأتوبيس" لعاطف الطيب، حيث يُجسّد مواجهة الفرد لأزمات اجتماعية وسياسية ناتجة عن تحولات المجتمع وتنكره لذاته. وفي مقابل هذه المعالجات الواقعية، نجد توظيفًا للأفكار الاجتماعية والسياسية والطبقية نفسها، ولكن في قوالب سينمائية فانتازية، جديدة، ومرحة أحيانًا، كما في بعض أعمال خيري بشارة.
من البطل الفرد إلى البطل الضد
لم يُحب خالد نمط البطولة الفردية التي منحها داود لبعض أبطاله، تلك القوى التي تتركز في شخص، مثل شخصية الشيخ حسني في "الكيت كات"، فقد تعارض هذا التوجه مع قناعاته، خاصة في ظل نقده لفكرة البطل الفرد بعد تجربة عبد الناصر، التي تركت أثرًا عميقًا في وعي المجتمع المصري. لكن مع مرور الوقت، تراجعت حدة تلك الانتقادات، وتحوّل الفيلم، بالنسبة له وللكثيرين، إلى أيقونة تمزج بين الحلم والتجاوز، وتوازن بين سينما "الحلم الجماعي" وسينما "الحلم الفردي". وربما لم تكن البطولة في الفيلم لِفرد بعينه، بقدر ما كانت لجماعة تمثّل طبقة اجتماعية تعيش في مكان واحد.
يرصد الكتاب سمات مشروع داود السينمائي، ومن أبرزها "الفردانية"، إذ يظهر "الفرد الاستثنائي"، الذي لا يُقدَّم كبطل، بل كشخص عادي يحمل كل تناقضاته، لكنه يمتلك خاصية "البوح الصادق". وهذا البوح لا يصدر عن وعي مباشر، بل عن تحوّلات نفسية عميقة تُدخل اللاوعي في دائرة الوعي، عبر الحلم، أو التداعي الحر، أو الخيال. وتمثّل هذه الحالة، وفقًا لتصورات كارل يونغ، بداية تحقق "الفردانية"، أي تصالح الإنسان مع ذاته من خلال الاتصال بمكامن اللاوعي.
تشغل "المساواة" أيضًا موقعًا محوريًا في هذه الفردانية؛ إذ يرى خالد أن داود يعيد خلق كون سينمائي وفكري يقوم على أسس جديدة، لا تنطلق من محاولة تمثيل صورة المجتمع، أو استنساخ الواقع الأصلي، بل من إيمان بأن الفرد قادر على عكس مجتمع موازٍ، وخلق واقع آخر، غير الواقع المسيس والمباشر.
ومن السمات اللافتة في مشروع داود السينمائي: السرد. إذ ثمة حضور ملحّ "للراوي" في أفلامه، بُعبّر من خلاله عن بوح ذاتي موجّه إلى الذات والآخر في آن معًا. قد يظهر هذا الراوي في تعليق صوتي على الأحداث، أو في مونولوج داخلي لشخصية أو أكثر. وتتميز هذه المونولوجات بلغة خاصة، تصل أحيانًا إلى حدود الشعر، في حيث قوة تركيبتها، وثراء عناصرها التخييلية، وعمقها النفسي.
في نهاية الرحلة، يحقّق أبطال داود نوعًا خاصًا من "النجاح" لا يُقاس بمعايير الإنجاز التقليدي، بل بالتقبّل واكتشاف الذات. هو نجاح ينبع من إعادة مَوقَعة وجوده الاجتماعي، والاعتراف بجزء أصيل في ذاته ولا وعيه، دون التخلّي عن الحلم. نلمس ذلك في شخصية الشيخ حسني في "الكيت كات"، أو يحيى أبو دبورة في "أرض الخوف"، أو يوسف كمال في "البحث عن سيد مرزوق"، أو نرجس في "أرض الأحلام". فالاستنارة، في عالم داود السينمائي، ليست لحظة يقين بقدر ما هي محاولة لإعادة رسم خريطة جديدة للذات، تبدأ من الداخل وتنفتح على الآخر والعالم.
رحلة مليئة بالصعلكة
ارتبط مفهوم "الرحلة" الحديث بظهور "الفرد"، بوصفه بطلها وصانعها، فالرحلة مرتبطة بالفردانية إلى حد ما، بالشك، اكتشاف الوجود، الرسالة الداخلية. إنها تشبه الرحلة الدينية، وإن اختلفت عنها في الأهداف. ففي سينما داود عبد السيّد، لا تكون الرحلة عبر المسافات أو بالأقدام، بل بالتجربة، بالصدمة، بالصدفة، وبالتجاوز، إنها رحلة نحو الاستنارة، تحدث عند تجاوز الحواجز الذاتية والوجودية، حيث يُكتشف الله في مكان جديد، بعد أن يُكتشف العجز الإنساني والضعف البشري.
يحمل مفهوم "الصعلكة" حضورًا محوريًا في أفلام عبد السيد، حيث يتسامى المفهوم ويتشكل فنيًا في قوالب مختلفة، ليصبح أحد ثوابته كمخرج له رؤى يكررها في أفلامه، على نحو يقرّبه من ما يسمى "سينما المؤلف". وغدت الصعلكة هنا ليس فقط نمط حياة، بل مجاز للتحرر من القيود، والخروج عن نظام اجتماعي وفكري سائد، منظم، ومقيد للحرية.
في نفس السياق، يعد نموذج الصعلوك أحد تمثّلات الفردانية، من جهتها الشعرية تحديدًا. فالصعاليك، جميعهم، خرجوا عن القطيع، أو تمرّدوا على النظام، سواء كان الخارجي أو الداخلي. لذا، أصبح هذا النموذج رمزًا للخروج من مأزق العادية والاستهلاك وفقدان الهوية الإنسانية، ومحاولة ممارسة الحرية بالشكل الذي ينبغي أن تُمارَس بها.
أما مفهوم "الاستنارة" الذي يطرحه داود في أفلامه، فهو لا ينبع دومًا من سعي وجودي خالص نحو اكتشاف الذات في عالم غامض، أو من رغبة في التغلب على ضعف الإنسان الفرد، بل يتشكّل أيضًا من تفاعل هذا السعي الفردي مع أزمة مجتمعية شاملة. لقد تشابكت أزمة الجيل/المجتمع مع الأزمة الوجودية للفرد، فانبثق عنهما نسيج رمزي جديد، حيث اختلطت هزيمة الخارج مع ضياع الداخل، وتداخلت أسئلة الكينونة بالهوية، وتاه الإنسان في عالم لم يعد يعرفه. كأن الهزيمة أصبحت مادة التفسير ومفتاحه، لأنها حضرت على المستويَين المادي والمجازي، وأتاحت للوعي الفردي أن ينفتح على أسئلة كبرى: وجودية، أخلاقية، واجتماعية؛ وهي أسئلة ما كانت لتدخل نسيج الوعي العام لولا هذه الهزيمة الجماعية، أو الجرح المشترك الذي خلّفته في النفوس. لقد نبشت الهزيمة في الضمير، وأطلقت منه تفسيرات متعدّدة لأزمة الإنسان المعاصر.
وربما نجد في مفهوم "القيامة" المسيحي العنصر الأقرب إلى تصور داود عن الخلاص؛ لا لحظة الصلب، بل لحظة الانبعاث. كأن داود، عن وعي أو لا وعي، يتجاوز لحظة الألم القصوى، "زمن الصلب"، لأنه فوق الاحتمال، ولأنه غير إنساني، ليقفز مباشرة نحو القيامة. وربما يكون هذا الزمن المحذوف – زمن الصلب – هو ما غاب عن حياة أبطاله قبل دخولهم التجربة التي ستُعيد إليهم الحياة؛ هو "زمن ما قبل الحكاية"، أو "زمن المعاناة" غير المرئي، الذي يُستبدل على الشاشة بلحظة التحول والاكتشاف.
السينما: تمرّد الحلم
في السينما، ثمّة عالم جديد حاضر، لكنه في مكان غير مرئي، يمكن أن نتعايش معه ونلمسه بوجودنا. هذا هو الحلم الذي جعل من السينما نافذة على عالم حلمي أو أسطوري، رغم واقعيتها. وهنا تتجلّى المفارقة في أفلام داود أننا نعيش في المنتصف، بين حلمنا الفردي وحلم الجماعة، حيث يمرّ الأفراد كظلال معكوسة على الشاشة البيضاء لهذا الحُلم الجماعي.
من أبرز سمات مشروع داود السينمائي هذا التداخل بين الواقع والحلم. ففي الأفلام ثمّة عالم واقعي، وآخر حلمي ممسوس بغموض ميتافيزيقي، يشكّل تمثيلًا لذلك "المكان/ العالم الآخر" الذي يتحاور معه المخرج باستمرار، ويعدّ ركيزة أساسية في رؤيته الفنية.
يشغل الإنسان، في أفلام داود، العالمين معًا، بل يصل بينهما، حتى إن رسائل مادية تصدر من هذا العالم الآخر، كأن هذا "المكان الحلمي" لم يعد منفصلًا عن "المكان الواقعي"، بل صار كلاهما مكونًا لتجربة شعورية مزدوجة. وعندما يتداخل العالمان -عالم الواقع وعالم الحلم-، تُولد الحكاية، يُستوعب العالم الغريب داخل المألوف، ويتسرب اللامعقول إلى بنية المعقول، عندها تتحول الحياة نفسها إلى حكاية.
تقوم فكرة داود على عنصرين رئيسيين: أولًا، عقل نقدي تحرّري يؤكد على إعلاء قيم الفردانية، ويظهر في تأكيده فكرة الاستنارة النابعة من تفسير علمي للوجود المادي. وثانيًا، إيمانه بنوع من الغموض الذي يمثل القلب أو الروح في العصور المادية التي نعيشها، أو المكان الذي يتجسد فيه اللاشعور الجمعي.
سيرة الطبقة الوسطى
في الحوار الطويل الذي اندمجت فيه كل الحوارات بين الكاتب والسينمائي، يشير داود إلى نشأته وسط أسرة عادية تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، مؤكدًا أنه لا يحتاج إلى استعارة هموم طبقة أخرى. لكنه يرى، في المقابل، أن الحديث عن الطبقة لا يكتمل دون تجاوزها؛ إذ لا بدّ للفرد من أن يخرج عن حدود طبقته كي يتسع أفقه. فمن وجهة نظره، تُبنى القيمة الطبقية لا على الانغلاق داخلها، بل على قدرتها على التماس مع الآخرين في الجانب الإنساني الأشمل. ويُعَدّ داود من المخرجين الذين فهموا جوهر الطبقة الوسطى، بوصفها طبقة القلق والحركة والحلم. وهي في رأيه، الطبقة التي خرج منها معظم الذين أحدثوا تغييرًا في المجتمع.
ينعكس هذا الإحساس الطبقي والوجودي في تداخل واضح بين شخصية داود وبين شخصيات أبطاله، ليس مع بطل بعينه، ولكن من خلال "حاصل" الشخصيات التي صاغها في كل أفلامه تقريبًا، وربما كان هذا التداخل نتيجة للاصطدام بين حدود الطبقة وحدود الحرية الفردية، تلك الفردانية المقدّسة التي تسبق الانتماء الطبقي وتعلو عليه، لكنها في الوقت نفسه تبحث عن صيغ مشتركة للتعبير عن التمرد والأمل داخل الجماعة. هكذا، تتولّد مساحة جديدة بين الفرد والطبقة، أو بين الفرد والمجموع.
في هذا السياق، تؤدي الحكاية غير الواقعية دور مساحة المصالحة بين الطبقة المتوسطة والتجاوز والحُلم. هي الخلطة الأيديولوجية التي يعتمد عليها داود في بناء أفلامه، ليمسك بأطراف هذه الرؤية التي سيرى بها المجتمع، ودون تخل عن أي من ثوابته أو قضاياه، ولكنه سيضعها في مساحة جديدة داخل اللاشعور.
ربما يُعدّ هذا الحلم، في تكوينه واستخدامه، أحد المسارات التي نشأت كردّ فعل على هزيمة عام 1967، وإحدى أدوات مقاومتها الرمزية. فهذا التعصّب للحلم، بوصفه أيديولوجيا مكتملة بذاتها، يمثل تجاوزًا روحيًا أو صوفيًا، ونوعًا من الخلاص عبر الحلم، مهما بدت معقوليته ضئيلة. إنه بمثابة درجة مفقودة في سلّم الواقع، لكنها تُتجاوز بالحلم. تلك الإيديولوجيا غير المكتوبة، التي يحتل هذا الحلم مركزها، ليست سوى بقايا لأحلام سياسية وطبقية، وانكسارات وهزائم، ودفقات دينية طوباوية. وكما تضع هذه الأيديولوجيا أساسًا لحلم مستحيل، فإنها تضع أيضًا أساسًا لبطل – أو ضدّ بطل- مستحيل بدوره.
بناء الحالة.. مكان خاص وزمان خاص
يتّضح من أفلام داود عبد السيّد أن الزمن ليس مجرد إطار خارجي للأحداث، بل هو زمن داخلي، زمنيّة شخصية تتعلّق بتحوّلات الأبطال، وخصوصًا أولئك الذين يعيشون على هامش المجتمع أو ينتمون إلى فئاته "العادية". من خلال هذا الزمن الخاص، يكتب داود تاريخًا غير مباشر لما حول الشخصيات، حيث يصبح زمن البطل هو المقياس الحقيقي، وتغدو همومه الفردية أكثر أهمية مما يحدث خارجه.
ولا يقتصر هذا التفرّد على الزمن، بل يشمل المكان أيضًا، حيث يُعامَل كعنصر فاعل في بناء الحالة السينمائية. في إحدى حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي"، أشار علاء خالد، في حديثه عن كتابه، إلى تحوّلات المكان في سينما داود، وكيف تتحوّل الأماكن إلى فضاءات مختلفة، معزولة عن الواقع الاجتماعي. نرى ذلك في "سارق الفرح" حيث تدور الأحداث في المقطّم، الإسكندرية في "رسائل البحر"، ومكان خارج الإسكندرية في "قدرات غير عادية". كأن داود يوسّع مفهوم المكان ليجعله يتجاوز الإطار الاجتماعي التقليدي، مانحًا إياه حسًا رمزيًا خاصًا، مكانًا له قوانينه الخاصة، والخروج منه ينطوي على صعوبة أو مفارقة.
وفي هذا السياق، يمكن فهم استخدام داود للرمز ليس بوصفه أداة مباشرة أو تفسيرية، بل كامتداد لحالة شعورية تُبنى من خلال التكوين البصري والمكاني. يقول أنسي أبو سيف: "لا أحبّ استخدام الرمز في السينما، لأنه، في رأيي، يخاطب الأغبياء، كونه مباشرًا وسطحيًا." لكنه يوضح أن مخرجين كبارًا مثل توفيق صالح وأبو سيف وشاهين يستخدمون هذا الأسلوب، لكن بالنسبة لجيل الواقعية الجديدة، ومنه داود، فقد انتقل بالرمز من كونه تمثيلاً مباشراً إلى كونه "حالة" تُعاش.
ويتّضح هذا الفهم للرمز بوصفه تجربة وجودية، في قول أبو سيف: "الكون كبير جدًا، ونحن أشياء صغيرة، نلعب بداخله. فهذه الصروح الكبيرة والإنسان الذائب بداخلها ترمز لعلاقة بين الإنسان والكون. لقد عبّر داود عن هذه العلاقة في فيلم "أرض الخوف" عندما وضع أبطاله داخل جامع السلطان حسن. فكان شكل تواجدهم داخل هذا الفراغ يثير رجفة في النفس".. كأنها تذكير بضآلة الإنسان أمام اتساع الكون، وفي الوقت نفسه عن العلاقة المزدوجة التي تربطه به.
ويتكامل هذا التكوين الرمزي والزمني والمكاني عبر عنصر الصوت، وتحديدًا الموسيقى، بوصفها جزءًا من بناء الحالة. يؤكد الموسيقار راجح داود أن "الحالة" هي التي تصنع الموسيقى. فمثلًا في موسيقى فيلم "الكيت كات"، وظّف تناقضًا مقصودًا في الآلات الموسيقية ليُحاكي التناقض في حالة الشيخ حسني: رجل أعمى يتصرّف مع الناس كما لو كان مبصرًا، يقود دراجة نارية. وعلى الرغم من أن البعض رأى في المشهد دراما كوميدية، فإن راجح داود قرأه على نحو مختلف: رجل يتحدّى عجزه بإرادة صلبة، وهو بُعد خفيّ عبّرت عنه الموسيقى، وارتقت به إلى مستوى أكثر سموًا.
ألوان السينما
ينتقد داود عبد السيّد أنماطًا من السينما لا يجد فيها ما يعبّر عنه. يبدأ بنقد "أفلام الزمن الجميل" في الأربعينيات والخمسينيات، التي يراها مريحة وظريفة، تقدم لمشاهدها الاسترخاء وتوهمه بحياة خالية من الهموم، حيث ينال الشرير جزاءه، ويتنصر الطيب في النهاية. أما ما يُعرف بـ "السينما النظيفة"، فيراها شكلًا من النفاق الفني، يسعى إلى استرضاء الجمهور وضمان دخول الأسرة بأكملها إلى قاعة العرض، لكنها في جوهرها متصالحة مع الوضع القائم، ومستسلمة لكل ما هو تقليدي.
ينتقد أيضًا الأفلام الدينية، معتبرًا أنها تتوجّه إلى جمهور متفق سلفًا مع أفكارها، فيقول: "أنا أريد أن أشتبك مع المتفرج كي أغير أفكاره قليلًا، وليس تثبيتها، أحاول أن أغير سواء من نفسي أو من الآخرين". كما ينتقد "السينما المستقلة" ويرى أن بعض صانعيها تجاوزوا جمهورهم تمامًا، ما أفقد أعمالهم البوصلة الاجتماعية بسبب غياب الجمهور عن المشهد. في المقابل، يوجّه نقدًا للسينما التجارية التي، في رأيه، تسعى إلى دغدغة مشاعر المتلقي، أي "تزغزغ وتطبطب" على الجمهور و"تضع بصلة في عينه" ليبكي. أما السينما الفنية، فهي التي تمنح المشاهد فرصة للفهم.
يلاحظ داود وجود أنماط فكرية متكررة في السينما: فإما أن تنشغل بقضايا طبقات مقهورة بوضوح، مثل الفقراء أو النساء، وهي موضوعات لا يفضّلها، أو تتجه نحو أعمال تجارية بلا مضمون، أو تسلك طريق النقد الاجتماعي المباشر لقضايا مثل التحرش وحقوق الأرامل، وهي أيضًا لا تستوقفه. في المقابل، يحمل همومًا لا تتسق مع أي من هذه الفئات، بل تتعلق بتجربة إنسانية أكثر تركيبًا وتعقيدًا.
يتمحور السؤال بالنسبة إليه حول كيفية بناء علاقة حقيقية مع الجمهور: لا يمكن صنع سينما لا تلامس المتلقي، لكن في الوقت نفسه، لا يصح أن تُفصّل الأعمال حسب مزاجه. هنا يكمن التحدّي. أما الشكل السينمائي الأقرب إلى روحه، والذي لا يزال ممكنًا في نظره، فهو "سينما الرحلة"؛ تلك التي تنشغل بالهموم الشخصية للإنسان، كالفقر، والظلم، والجنس، والحب.
كتاب سينمائي برؤى متعددة
إذا كانت السينما قد نشأت من انعكاس الضوء على شريط الفيلم، فإن كتاب «داود عبد السيد.. سينما الهموم الشخصية» هو كتاب سينمائي بامتياز؛ إذ يعكس رؤى وأفكار المخرج داود عبد السيد التي تجسدت في أفلامه، والتي بدورها حمَلت همومًا إنسانية مشتركة على الشاشة، وأسهمت في تشكيل رؤية جديدة للعالم لدى المتفرج، كما يرى علاء خالد. هذه الرؤية تمس ذات المتلقي وتوقظ فيه شعاعًا جديدًا من التأمل، يعود بدوره إلى المخرج في دائرة تفاعل مستمرة، عبر حوارات امتدت لأكثر من عقدين.
هذا التفاعل يولِّد توافقات بين رؤيتين: رؤية المخرج ورؤية المتلقي/المحاور، تنصهر في رؤية ثالثة تتشكل مع كل قراءة جديدة للكتاب. فهو ليس مجرد تسجيل لهذه الحوارات، بل عمل حي، تتجدد فيه الانعكاسات والتأملات مع كل قارئ أو مشاهد جديد، لتنبثق منه رؤى متجددة حول المكان، والحياة، والفن، والذات.
"داود عبد السيد.. سينما الهموم الشخصية" هو كتاب عن العلاقة المتبادلة بين القارئ / المتفرج والنصّ المركب الذي تمثله أفلام داود، من خلال تفاعلات الكاتب والمبدع علاء خالد. يسعى خالد للإحاطة بالنقاط المركزية في فكر داود، كما ينفتح الكتاب أيضًا على فكر علاء نفسه وفكر القارئ، في علاقة تتجلى فيها مساحات الضوء المشترك: الضوء الذي يُسلّطه علاء على أفلام داود، والضوء الذي تعكسه تلك الأفلام على أفكاره، وأفكار المتلقي، ليكشف الجميع أنفسهم في أماكن جديدة لم يكونوا قد رأوها من قبل.