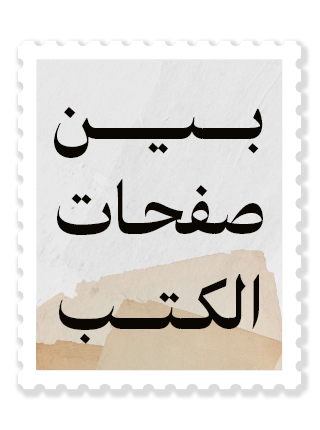في كتابها "مشهد الحرب: إيكولوجيات المقاومة والبقاء في جنوب لبنان"، تقدّم منيرة خياط دراسة عن الحياة على الحدود الجنوبية للبنان، حيث تتعايش المجتمعات مع الحروب وتبتكر شبكات معيشية وممارسات بيئية تُمكّنها من الصمود. ومن خلال ممارسات السكان اليومية، مثل زراعة التبغ، وحصاد الزيتون، وتربية الماعز، تكشف خياط كيف تتحوّل الأرض والبيئة إلى أدوات للحياة والمقاومة. يجمع الكتاب بين البحث الميداني واللغة السردية التصويرية، ليقدّم رؤية عن الحياة في مناطق النزاع من منظور أهلها، بعيدًا عن النظريات المجردة والمقاربات السياسية التقليدية.
هلا أبي صالح[1]
تزامنت قراءتي الأولى لكتاب "مشهد الحرب: إيكولوجيات المقاومة والبقاء في جنوب لبنان"[2] مع مشاهدة صور وفيديوهات عودة الجنوبيين اللبنانيين إلى أراضيهم ومنازلهم بعد اتفاقية وقف إطلاق النار بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. فقد رأينا على شاشات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي طوابير العودة إلى قرى ومدن الجنوب. كما بدأت منيرة خياط كتابها بوصف طوابير السيارات المتجهة جنوبًا بعد وقف إطلاق النار عقب حرب تموز 2006. وبطبيعة الحال، يستطيع أهلي وأجدادي أيضًا أن يصفوا مشهد عودة الجنوبيين إلى أراضيهم ومنازلهم بعد كل جولة حرب مع الكيان الإسرائيلي.
يُعد هذا الكتاب دراسة إثنوغرافية للحرب في قرى الحدود الجنوبية اللبنانية تركز على العوامل الاجتماعية والبشرية والبيئية التي تقوم عليها بيئة الحرب، يتألف من مقدمة ومدخل وستة فصول وخاتمة، والتي تضع العمل بشكل أساسي في الأدبيات الأوسع حول أنثروبولوجيا الحرب. أرادت ميرنا خياط، وهي باحثة تُعنى بدراسة أنماط الحياة في أزمنة الحرب، وببناء تصوّرات تنطلق من الجنوب العالمي، أن تجيب في كتابها "مشهد الحرب" عن سؤال أساسي: لماذا يعود الجنوبيون بكثافة بعد كل جولة حرب؟ وكيف يواصلون العيش على أرضٍ لا تعرف السلام أبدًا وتظل في حالة حرب واستنفار دائم؟
عند الانتهاء من قراءة الكتاب، نجد إجابات لبعض التساؤلات التي تطرأ عند التفكير في الحرب بمعناها الاجتماعي لا السياسي: "ما معنى الحرب بالنسبة لمن يعيشونها؟" و"كيف يواصل الناس حياتهم في الحرب؟" في مقابلة، أوضحت الكاتبة أن كتابها لا يدور حول الحرب بحد ذاتها، بل حول الحياة والأنظمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تستمر وتنمو في خضم دوامة العنف وجولات الحروب، إذ يعيش الجنوبيون دائمًا تحت وطأة هذه الأوضاع العنيفة وسيف الحرب مسلط فوق رؤوسهم، ومع ذلك تظل الحياة حاضرة وتنمو في هذه المنطقة الجغرافية.
ما يميز هذا الكتاب هو الحضور الكثيف لأصوات وقصص الجنوبيين أنفسهم؛ فهم الذين يتحدثون ويروون يومياتهم في الجنوب اللبناني وعلاقتهم بأرضهم، بحيث نقرأ كلماتهم مباشرة لا من ينوب عنهم. صحيح أن الكاتبة صاغت هذه الشهادات، لكنها وضعتها في إطار بحثي محدّد، موضحة في الكتاب منهجيتها البحثية وما واجهته من صعوبات وحدود خلال عملها. ويمتاز الكتاب أيضًا بأنه لا يقتصر على التاريخ السياسي للمنطقة. فمع أن الكاتبة خصصت فصلًا لتاريخ جنوب لبنان وصراعاته، متطرقةً إلى المقاومة وحزب الله، إلا أنها لم تجعلهما محورًا أساسيًا، بل ركزت بصورة أعمق على حياة الأفراد. ومن خلال السرد يتضح أن المقاومة وُجدت قبل حزب الله وستبقى بعده.
ما معنى الحرب؟
ما معنى الحرب؟ وتحديدًا، ما معناها في سياق جنوب لبنان، وفي دول الجنوب عمومًا؟ هذا سؤال جوهري، لأن فصول الكتاب تكشف أن الحرب ليست مفهومًا واحدًا. فعندما نسمع كلمة "حرب"، يخطر ببالنا دائمًا التصور الإمبريالي والكولونيالي لها. وتُظهر دراسة سلوك الدول الاستيطانية والإمبريالية تجاه الصراعات المسلحة أن فهمها للحرب يختلف جذريًا عن الفهم السائد في العلاقات الدولية المعاصرة، خصوصًا بعد الحرب العالمية الثانية وتطور حقل "دراسات السلام والصراع" (Peace and Conflict Studies).
فبدلًا من النظر إلى الحرب بوصفها أداة أخيرة لتسوية النزاعات، تُفهم في سياقها التاريخي باعتبارها وسيلة لتحقيق مكاسب جيوسياسية واقتصادية، أساسها السيطرة على الأراضي والموارد. هذا المنظور متجذّر في تاريخ تلك الدول المرتبط بالاستعمار والتوسع، إذ شكّلت القوة العسكرية أداتها الأساسية لفرض الهيمنة ونهب الثروات وتثبيت النفوذ. ونتيجة لذلك، ظلّت عقلية "الغزو والاحتلال" جزءًا من بنيتها الفكرية، ما يدفعها إلى التعامل مع النزاعات الراهنة بعدسة تاريخية ترى في الحرب فرصة لتعزيز نفوذها ومصالحها على حساب سيادة الدول الأخرى.
لذلك، لن تفهم الدول الاستيطانية معنى الحرب إلا في إطار ما ذكر أعلاه، حتى لو اعتبرت الحرب من الماضي بالنسبة لها. فهي لا تدرك المعاني الأخرى للحرب في دول أخرى، ويتضح هنا إلى حدٍّ ما موقف ذو طابع دوني أو متعالٍ، يُشبه "متلازمة المنقذ الأبيض"، تجاه المجتمعات والدول التي تعيش في حالة حرب.
تؤكد خياط أن الاعتراف بطبيعية الحرب لا يعني تطبيعها أو رومانسيّتها، بل توثيق "الإرادة (المقاومة) للحياة في الحرب" كمصدر لنظرية حرب من الجنوب، تظهر كيف تُولد الحياة في أتون الصراع. في مواجهة التصورات التقليدية للحرب بوصفها "غرابة غريبة"، تبيّن خياط أن هذه الغرابة متجذرة في واقع مشترك، مرتبط بالعنف المعاصر للصناعة والرأسمالية والاستغلال، مما يجعل الحرب ظاهرة حياةً متواصلة وليست مجرد حدث سياسي أو استثنائي.[3]
يشرح هذا الكتاب الأوجه الأخرى للحرب بعيدًا عن المفهوم السائد لدى الدول الاستيطانية. فهو يستعرض عالمًا ينبض بالحياة، ينمو ويتطور رغم قسوة الحروب ودوائر العنف المستمرة. لا يقدّم الكتاب مجرد سرد لتاريخ الصراع، بل رحلة عميقة في حياة الأفراد الذين يعيشون في ظل هذه الظروف الاستثنائية، ويكشف كيف يتكيف سكان هذه المنطقة مع تأثيرات الحرب على حياتهم اليومية والاجتماعية والاقتصادية.
كما يستكشف الكتاب مفهوم الحرب من منظور أهل الجنوب، حيث تُفهم ليس بوصفها صراعًا عسكريًا فحسب، بل دفاع عن الوجود، عن الأرض، الهوية، والكرامة. وفي هذا السياق، يبرز دور البيئة في تشكيل مقاومة حية، حيث تتحول الأراضي والجبال والأنهار إلى عناصر أصيلة في قصة الصمود، لتصبح بيئات مقاومة تحكي تاريخ التحدي والبقاء. ويظهر هذا بوضوح في أولى صفحات الكتاب، حين يقول "أبو ساحل"، رجل عجوز من جنوب لبنان: "أول ما فعلته عندما عدت إلى هنا هو أني غرست أشجار الفاكهة في حديقتي. لقد غرست نفسي هنا ولم ولن أغادر مرة أخرى".[4]
كيف نعيش الحرب؟
يتجاوز الصراع في الجنوب اللبناني كونه مجرد سلسلة من الأحداث العسكرية، فقد أصبح جزءًا أصيلًا من نسيج الحياة ذاته. منذ أجيال، يعيش هذا الشريط الحدودي حالة حرب مستمرة تندلع دوريًا لتهزّ الاستقرار وتخلّف الدمار، ثم تفرض على الأهالي مهمة شاقة تتمثل في إعادة البناء. لم تعد الحرب قوة خارجية تؤثر على المشهد فقط، بل تحوّلت إلى جزء من البيئة الحية، تشكّل تضاريس الأرض وتغيّر إيقاعات الحياة اليومية، لتصبح قوة مولّدة لنوع فريد من الوجود الإنساني؛ حياة تُعاش بكل تفاصيلها رغم كل شيء، تتسم بمرونة عميقة وصلابة استثنائية. وهكذا، يصبح الجنوب مكانًا تتشابك فيه جذور المقاومة مع مواسم الزراعة، وتنمو الحياة على أنقاض الدمار.
يستكشف الكتاب "عوالم تنمو وتزدهر في ظل الحرب"، مبيّنًا الحياة التي تستمر في خضم الصراع الدائم. تغوص الكاتبة في دراسة ما تسميه "البيئات المقاومة"، وهي علاقات حيوية تتجاوز نطاق البشر، وتشكّل شبكة من الترابط تستمر في صون الحياة وسط مواسم الدمار المتكررة.
تركّز الحياة في هذه المناطق في معظمها على الأنشطة الزراعية مثل زراعة التبغ، المعروفة أيضًا باسم "نبتة المقاومة"، وحصاد الزيتون، ورعي الماعز. ولا تقتصر هذه الممارسات على كونها مصدرًا للدخل وسبل العيش، بل تُعدّ جزءًا أساسيًا من الصمود، مما يجعل الاستمرار في هذا المكان ممكنًا.
يصعب في مكان مثل جنوب لبنان فصل الحرب عن الحياة؛ فهما متلازمتان ومتعايشتان. تتجلى الحرب في الجنوب من خلال تداخل مواضيعها، بنيتها التحتية، اقتصادياتها، تقنياتها، وجغرافيتها، لتشكّل بيئات معيشية فريدة في هذه المنطقة الزراعية الحدودية، التي هي أيضًا ساحة معركة. فالزراعة والحصاد، بما فيها من أرباح ومخاطر، تتداخل بشكل دائم مع حالة الحرب المستمرة، حتى في فترات الهدوء المتقطعة. هذا التداخل ليس خيارًا، بل مسألة بقاء وصمود.
في هذه الساحة، تتشابك المواسم الزراعية مع مواسم الحرب؛ فبينما تعتمد سبل العيش على مواسم زراعية معروفة ويمكن التنبؤ بها، تستمر وتتأقلم هذه الأنشطة مع مواسم الحرب وحصادها. في جنوب لبنان، تتجذر الحياة والحرب في الأرض، وبالتالي في المشهد الطبيعي، حيث تصبح البيئة بوابة وأساسًا لفهم الحياة في ظل الحرب.
ويحدّد هذا المقطع بوضوح العلاقة بين الجنوبيين وأراضيهم، وما تمثله البيئات المقاومة، كما توضّح فاطمة، إحدى مزارعات التبغ في الجنوب، والتي قابلتها الباحثة أثناء إعداد الكتاب:
" كانوا في السابق يقتلون الناس أساسًا، أما الآن فيستهدفون الأرض، وهذا أسوأ بكثير! هذه المرة (أي خلال حرب 2006)، بدا واضحًا أن آلة الحرب الإسرائيلية مصمّمة على تدمير النظم البيئية التي تجعل الحياة ممكنة هنا. ومع ذلك، لم تمنع الحرب من بقي حيًّا من التمسك بالحياة. فقد عثرت فاطمة على قنبلتين صغيرتين معلّقتين في شجرة المشمش في بيتها، فالتقطتهما بيديها العاريتين. كان محصولًا غريبًا وقاتلًا، لكنها لم تتردد ولم تخشَ. وبهدوء عميق قالت وهي تنحني على التبغ: 'من لا تزال فيه حياة لن يموت'. ثم أضافت، قابضة على أصابعها المتفحمة: 'نحن، أهل الجنوب، مهما حدث، نتشبث بالأرض. ليس لدينا شيء سواها'".[5]
خاتمة
يقدّم هذا الكتاب شرحًا عميقًا لمعنى الصمود في جنوب لبنان، من خلال عيون وأصوات الجنوبيين أنفسهم. وهو ليس مجرد عمل بحثي، بل فعل مقاومة بحد ذاته. فمن بين صفحاته نتعرّف على يوميات أهل الجنوب وطرائق تكيّفهم مع دوائر العنف المتواصلة: عنف داخلي نابع من النظام السياسي اللبناني والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وعنف خارجي مصدره الدائم الكيان الصهيوني. ومع ذلك، يواصل هؤلاء الناس حياتهم اليومية، مصرّين على البقاء في بيوتهم وعلى أرضهم.
وأختم بما اختصرته كلمات جوليا بطرس في أغنيتها الشهيرة "غابت شمس الحق"، التي لامست ما أرادت الكاتبة إبرازه:
"منرفض نحنا نموت قولوا لهن رح نبقى
أرضك والبيوت والشعب ال عم يشقى
هو إلنا يا جنوب يا حبيبي يا جنوب"