يُقدّم كتاب ثريا التركي "حياتي كما عشتها: ذكريات امرأة سعودية من عنيزة إلى كاليفورنيا"، نافذة فريدة على التحوّلات الاجتماعية في السعودية منذ أربعينيات القرن العشرين، عبر سرد تجارب شخصية لامرأة سعودية تخطت التقاليد. تستعرض الكاتبة محطات حياتها ورحلتها التعليمية، مسلطةً الضوء على التحديات التي واجهتها كامرأة تسعى إلى التعليم والتحرّر في مجتمع محافظ. ورغم أن نوافذ السياسة تظل مواربة، فإن الكتاب يبيّن جذور التغيّرات التي مهّدت لتحولات ما بعد عام 2017.
يمكن الاستماع إلى نقاش مع خالد منصور ودينا عزت حول هذه المراجعة عبر هذا الرابط.
خالد منصور [1]
في مايو 2017، وفي مشهد يحمل أجواء أفلام "حرب النجوم"، وقف الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واضعين أيديهم على مجسّم كرة أرضية مضاءة، وبدت الوجوه مفعمة بالدهشة والتهديد، مع قليل من الاستعراضية المكشوفة. بعد ثمانية أعوام، في أيار/ مايو 2025، وفي الرياض أيضًا، أعيد المشهد بصورة مختلفة: وقف ترامب مجددًا في منتصف الصورة، بين ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وعلى يساره الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، لكن هذه المرة بابتسامات عريضة، وملامح تنبض بالحيوية والثقة.
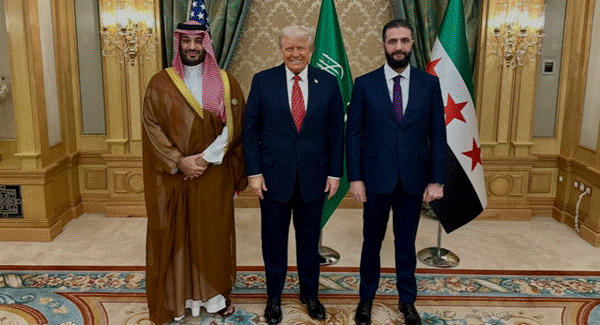
المصدر: Middle East Eye, 14 May 2025
لا شكّ أنّ ترامب وداعميه في الولايات المتحدة يسعون إلى إعادة تشكيل وجه بلادهم والعالم. فمنذ عودته إلى السلطة مطلع هذا العام، بعد أن صوّت له نحو نصف الناخبين، بدأ باتخاذ خطوات قد تبدو جنونية للبعض. وفي المقابل، أطاح الشرع بالحكم الأسدي "الأبدي" في أقل من أسبوعين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في مفاجأة سياسية قلبت المعادلة في سوريا. لكنّ إنجاز محمد بن سلمان قد يفوق الاثنين، على الأقل من ناحية التأثير الإقليمي، وبالتأكيد داخل السعودية، منذ أن أزاح أمراء نافذين، وبليونيرات مؤثرين، ومؤسسات دينية عتيقة عن طريقه، ليصبح الحاكم الفعلي للبلاد فاتحًا بذلك الباب لتحوّلات اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة غير مسبوقة في المملكة، بينما انسحب والده، الذي يقارب التسعين، من المشهد العام ليقضي شيخوخته بعيدًا عن الأنظار.
لطالما سارت السعودية، منذ تأسيسها عام 1932، على وتيرة بطيئة وثابتة، مثل كثبان الرمال الضخمة التي تتحرك بصمت. غير أنّها، منذ عام 2017، تحوّلت إلى شلّال من التغيرات المتلاحقة التي لا تهدأ. في هذا السياق المتحوّل، تفتح لنا ثريا التركي، في كتابها "حياتي كما عشتها: ذكريات امرأة سعودية من عنيزة إلى كاليفورنيا"،[2] نوافذ على تلك الكثبان، عائدة بنا إلى أربعينيات القرن العشرين، لتساعدنا -إلى حدّ ما- على فهم البُنى الاجتماعية التي أسهمت في نشأة هذه التحوّلات. لكن تبقى نوافذ أخرى كثيرة مواربة، أو مغلقة، لا سيما تلك التي تُطلّ على التحوّلات السياسية، والتي ما زالت أسئلتها المعلّقة تبحث عن إجابات.
وجه الرياض الجديد
في طريقي من مطار الرياض إلى قلب العاصمة السعودية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، توالت أمامي لوحات إعلانية ضخمة تصطف على جانبي الطريق، تعرض أجسادًا راقصة لنجمات أجنبيات قادمات إلى الملكة لإحياء حفلات موسيقية. وقد غنّت في المملكة، في السنوات الأخيرة، نجمات عالميات مثل شاكيرا وبيونسيه وجنيفير لوبيز. لم أكن قد زرت السعودية منذ عشرين عامًا، ورغم اطلاعي على التحوّلات الجارية التي يقودها محمد بن سلمان، بدا لي المشهد غريبًا، وربما صادمًا. في الطريق، لفتني عدد كبير من النساء اللاتي يقدن السيارات بثقة، في مشهد لم يكن واردًا قبل سنوات قليلة. تذكّرت فورًا الناشطة السعودية لُچَيْن الهذلول، التي عانت من السجن ولا تزال ممنوعة من السفر بسبب قيادتها حملات مطالبة بحق النساء في قيادة السيارات. كنت أتأمل السيارات من حولنا، تلك التي تجاوزناها وتلك التي مرّت بنا، وعددٌ كبير منها تقوده نساء. تداخل هذا الخاطر مع مشهد موظفة الجوازات في المطار، التي تأكدت من تأشيرتي وختمت لي الدخول، ثم أشارت إلى المسافر التالي بالتقدّم. في الفندق، كانت من أنهت إجراءات تسجيلي شابة سعودية، وفي صباح اليوم التالي، على هامش مؤتمر عن "حوكمة الإنترنت"، التقيت برلمانية سعودية تحدّثنا عن حقوق المرأة، وأكّدت من وجهة نظرها أهمية مواصلة العمل التدريجي من داخل النظام لتحقيق مزيد من الحقوق للنساء، نحو مساواتهن بالرجال — خطوة بخطوة، وببطء.
في اليوم نفسه، وفي ذات المؤتمر، حضرت ورشة عمل شاركت فيها — عبر الفيديو — الناشطة الحقوقية لينا الهذلول، شقيقة لجين، ونددت بسجلّ السعودية في قمع أصوات المعارضة. وقد مثّل هذا الحضور الافتراضي خطوة نادرة في بلد ما زالت فيه أصوات النقد تتعرّض للتضييق، حيث يقبع عشرات من سجناء الرأي خلف القضبان، وتحت أنظار أجهزة أمنية لم يتردّد بعض منتسبيها، قبل سنوات، في اختطاف الصحفي والكاتب المعارض جمال خاشقجي من قنصلية بلاده في إسطنبول، وقتله وتقطيع جسده.
وفي الجلسة التي شاركت فيها الهذلول، والتي نُقلت مباشرة عبر موقع الأمم المتحدة، حضرت أيضًا سيدات أخريات مثّلْنَ منظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. لكن الموقع الأممي حذف لاحقًا بعض تعليقات الهذلول الناقدة للانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان.
ومع قلة حالات القمع السياسي الصارخ نسبيًا، فإنها وجّهت، بلا شك، رسائل واضحة وناجعة في إسكات أي معارضة سياسية، داخل البلاد وربما خارجها. ويلقي هذا القمع بظلال قاتمة على المشهد السعودي المعقّد، الذي يشهد في الوقت نفسه انفتاحًا اجتماعيًا على عدة أصعدة. فمثلًا، تشهد الحفلات الموسيقية إقبالًا واسعًا، خاصة من الشباب، وتتواتر الإعلانات الصارخة لنجمات البوب والممثلات، ودعايات موسم الرياض الغنائي. كما يترسخ دخول النساء العلني والمتزايد إلى سوقَي العمل والسياسة، في حين يغيب ما يُعرف بـ"حراس الفضيلة"، أي منتسبي هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عن شوارع البلاد. وتمثل هذه التحوّلات مظاهر متنوعة لوجهٍ علني من تغيّر محسوب، بدأت المملكة في تنفيذه منذ سنوات، بقيادة بن سلمان.
إعادة تأسيس المملكة
يقوم نظام الحكم في السعودية على ملكية مطلقة أسّستها أسرة آل سعود، القادمة من منطقة نجد وسط البلاد، بعد أن أطاحت بحكم أشراف مكة في الحجاز، وسيطرت على إقليمي الأحساء شرقًا وعسير جنوبًا. لتعلن تأسيس كيان سياسي جديد يحمل اسم الأسرة نفسها، بعد أن توصلت لتفاهمات عقدتها مع الإنجليز، الذين كانت إمبراطوريتهم في طور التآكل في العالم. وعلى مدى امتداد عمر الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز (من مواليد 1935)، ارتكز النظام على سيطرة سياسية مطلقة بيد العائلة الحاكمة، وعلى احتكار المؤسسة الأمنية والعسكرية، بينما مُنح الفضاء العام، وخصوصًا أجساد النساء وسلوكهن، لمؤسسة دينية تقوم على أيديولوجيا وهابية، تعود جذورها إلى منتصف القرن الثامن عشر، حين عقد مؤسسها محمد بن عبد الوهاب تحالفًا مع مؤسس الدولة السعودية وجدّ العائلة الكبير.
وفي ضوء هذا السياق التاريخي، يمكن فهم ما يقوم به محمد بن سلمان اليوم، ومعه نخبة شابة تحظى بتأييد اجتماعي ملحوظ ودعم إقليمي ودولي، بوصفه محاولة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي في المملكة، وفي قلب هذا العقد: موقع المرأة. تشمل هذه التحولات تعديل نظام انتقال السلطة في البلاد؛ إذ كان جميع ملوك البلاد منذ نشأتها من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز، أما اليوم، فقد أصبح هو ذاته وليًا لعهد والده، ما يفتح الباب أمام نقل السلطة إلى جيل جديد وربما إلى ذرية سلمان مباشرة. لكن التحولات تتجاوز مسألة التوريث، فقد شملت أيضًا تقليص النفوذ الأيديولوجي والرقابي للوهابية ودعاتها ومنتسبيها من المطوعين على الفضاء الاجتماعي، والذي كان جسد المرأة وسلوكها فيه مركزًا لعمل هذه المؤسسة مفرطة الذكورية والمحافظة.
يقود ابن سلمان، الذي لم يتجاوز الأربعين من عمره، هذه التحولات الاجتماعية لضمان دعم مجتمعي واسع، لا سيما بين الشباب، وذلك من أجل فتح البلاد تدريجيًا خاصة اقتصاديا أمام العالم، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والانتقال تدريجيًا نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على النفط. فرغم أن السعودية تنتج نحو برميل من كل تسعة براميل نفط في العالم، إلا أن التحولات الجارية في قطاع الطاقة عالميًا، والاتجاه نحو المصادر المتجددة، تجعل من الواضح أن النفط لن يستمر للأبد. ولتحييد المؤسسات والفئات المستفيدة من وضع كان يتغير ببطء شديد في السعودية، كان لا بد من التحالف مع فئات أخرى، في مقدمتها الشباب والنساء- أي نصف المجتمع، أو أكثر. وقد ترافق ذلك مع وعود بالاستجابة لتطلعات الشعب السعودي، الذي كان أكثر من 18% منهم يعانون من الفقر في عام 2010، فيما بلغت نسبة البطالة الرسمية 11% في عام 2015.
وباتت مشاركة النساء في سوق العمل والفضاء العام، خاصة في المناطق الحضرية، ضرورة تفرضها الضغوط التحديثية، والرغب في رفع القيود العتيقة التي تثير حنق وغضب معظم الشباب، الذين صاروا منذ سنوات طويلة يتحايلون عليها في بلد يبلغ عدد من تقل أعمارهم عن 25 عامًا ما يقرب نصف السكان. غير أن هذه الضغوط الاجتماعية لم تكن السبب الرئيسي في هذه التحولات التي نشأت، على الأرجح، بسبب الصراعات السياسية.
"الاستثناء الحقيقي هو أبي"
في أول سطر من سيرتها الذاتية، تقول ثريا التركي: "إذا كان لشخص واحد فضل عليَّ، وكان سببًا في كل ما وصلت إليه، حتمًا، فسيكون ذلك الشخص هو أبي، محمد السليمان التركي." وكان هذا الفضل يتمثل في تخلّي والدها عن حقوق أبوية تقليدية في مجتمع محافظ، ظل يفتقر حتى مطلع ستينيات القرن العشرين إلى مدارس رسمية لتعليم البنات.
ترى ثريا أن دور بعض الرجال و"تفضّلهم" في منتصف القرن العشرين كان السبب الرئيسي في خروج نساء قليلات من الطبقات العليا، مثلها، من خلف أسوار بيوتهن المرتفعة إلى شمس الحياة العامة، في تحدٍّ واضح لتقاليد راسخة. تقول: "إذا كان الكثيرون يعتبرون أنني كنت استثناءً في الانتصار على التقاليد السائدة في مجتمع شبه الجزيرة، غير المتحمّس لتعليم الفتيات حتى العقد السابع من القرن العشرين، فإنني اعتبر أن الاستثناء الحقيقي هو أبي بسماحه لي بالانخراط في التعليم، سواء في مدارس لبنان أو مصر ثم دخولي الجامعة الأمريكية في القاهرة، وصولًا إلى سماحه لي بالسفر إلى الولايات المتحدة لنيل الدكتوراه، على الرغم مما تعرض له من حرج وانتقاد من مجتمعه وأوساطه في المملكة."
ويمكن النبش في ثنايا الكتاب عن تفسيرات لسلوك والدها المتحرّر في النصف الأول من القرن العشرين. فرغم أن محمد التركي وُلد في منطقة القصيم المحافظة في نجد في وسط شبه الجزيرة، قبل نحو عشرين عامًا من تأسيس المملكة، فإنه هجرها إلى الحجاز الأكثر تمدّنًا وانفتاحًا، حيث انتقل إلى مدينة جدة ليعيش الفترة الأخيرة الفاصلة بين حكم عائلة الشريف حسين ودخول آل سعود الحجاز منذ نحو قرن.
كان محمد تاجرًا ينقل البضاعة على ظهور الجمال من ميناء جدة إلى البادية حيث يبيعها. وقد تأثر، مثل كبار التجار في جدة، بالصراع الدائر آنذاك، لا سيما بعد هزيمة الأشراف وفرارهم من مكة. ومارس التجار ضغطًا على الشريف حسين للتخلي عن السلطة، وأرسل بعضهم عائلاتهم إلى الهند والسودان ومصر وإريتريا خلال الحصار الذي دام أكثر من عام على جدة، إلى أن دخلها ابن سعود في كانون الأول/ ديسمبر 1925، معلنًا نفسه ملكًا على الحجاز، وبادئًا عهدًا جديدًا بتغيير اسم البلاد وإطلاق اسم عائلته على الكيان الجديد. وفي إطار التوازنات البريطانية المعتادة في مرحلة الأفول الإمبراطوري، نُصِّب أبناء الشريف حسين على عروش في مستعمراتها العربية في بغداد ودمشق وعمّان، وبعد عقود قليلة لم يتبقَ من الملكيات الهاشمية إلا مملكتهم المستقرة في الأردن.
بعد تأسيس السعودية، تمتع النجديون بوضع متميز، إذ "عمل انتماؤهم لصالحهم هذ المرة، وسعوا للحفاظ على هويتهم كنجديين والتمتع بما كانت تتيحه من فرص، بعد سنوات من الاضطهاد على أيدي الحجازيين، الذين تسيطر عليهم صورة ذهنية نمطية مفادها أنهم أكثر تقدمًا وانفتاحًا من سكان نجد". وكان الزواج بين النجديين والحجازيين نادرًا قبل صعود آل سعود، حتى لو أقام النجديون في جدة سنوات طويلة. ومن هنا يكتسب زواج محمد التركي من السيدة نور فكهاني (والدة ثريا)، وهي حجازية، دلالة رمزية على التحول التاريخي الناتج عن الهيمنة السياسية الجديدة. استفادت عائلة التركي من علاقاتها مع أسر ذات نفوذ مثل الحمدان (التي ينتمي إليها عبد الله السليمان، أول وزير مالية سعودي)، والخريجي (عائلة تجارية ذات علاقات نسب واسعة)، وجميعها تعود بأصولها إلى عنيزة في القصيم. بفضل هذه الروابط، ازدهرت تجارة محمد التركي، ثم التحق بوظيفة مرموقة في وزارة المالية.
لكن صورة هذا الأب المتحرر في كتاب ثريا تتقاطع مع مشاهد شديدة التقليدية: فزوجته نور، والدة ثريا، لم تكن سوى طفلة حجازية في الحادية عشرة من عمرها عندما انتقلت لبيت محمد التركي. وتنقل ثريا عنها في حوار دار بعد أعوام طويلة قولها: "كنت متحمسة جدًا للزواج ... لأني عرفت أن كل الملابس التي تعدها أمي قبل العرس لي ولأختي الكبرى بديعة ... كان ذلك فقط هو ما يحمسني للزواج." وفي صباح اليوم التالي للزفاف وجدها أهلها باكية لأن زوجها كما شكت لهم "يبغي يسوي معايا كلام العيب!" ولا يوضح الكتاب رد فعل الأسرة، ولا كيف عاشر الرجل زوجته الطفلة، التي عاشت "أوقاتًا عصيبة في بيت زوجها، ووجدت صعوبة في التعامل" مع جارية زوجها، التي كانت أمًا لطفل من الرجل نفسه. وقضت الزوجة الجديدة وقتها تلعب مع ابن الجارية، الذي كان يقاربها في العمر " كما أنها لم تتعلم، (فهي) لا تقرأ ولا تكتب، وكذلك أخواتها جميعهن." وأسفر الزواج عن أحد عشر طفلًا وطفلة، لم يعش منهم سوى خمسة (أربعة منهم بنات).
من غير الواضح كيف تحوّل هذا الزوج إلى والد متفتح لتعليم بناته. ومن مظاهر هذا "التحرر" أنه كان يصطحب أسرته، ومعظمها نساء، إلى مصر ولبنان، حيث يتخففن من قيود الملبس الصارمة والخروج دون محرم، من دون أن يشكل هذا "قلقًا كبيرًا له." ولا تفسر ثريا هذا "التسامح" من الأب لبناته سوى بـ"اتساع أفقه مع كثرة أسفاره واهتماماته". لكن هذا "الأفق المتسع" وحده لا يفسر سماحه لثريا بالالتحاق بالجامعة في الستينيات، أو سماحه لشقيقتها خديجة بقيادة السيارات خارج المملكة. إذ جلب عليه القرار الأول انتقادات واسعة من مجتمعه لأن "البنت ممكن تفلت"، ولم يكن هو ذاته يقبل بالاختلاط بين الجنسين، ولكنه غضّ النظر.
حتى أربعينيات القرن العشرين، لم يكن هناك من مجال لتعليم الفتيات في جدة سوى في كتاتيب نسائية تدرّس القرآن والخياطة والتطريز حتى البلوغ، قبل إجبار الفتيات على ارتداء الحجاب والمكوث معظم الوقت في البيت. ولا تنتهي تناقضات الوالد، فهذا الرجل الذي قبل بإرسال ابنته لجامعة مختلطة خارج البلاد، كان وهابي الهوى، يحرّم الغناء في البيت. وكانت الأم تلتقي سرًا مع صديقاتها للغناء وهن يشربن القهوة ويأكلن التمر ويدخن بعضهن الشيشة، ويقوم حارس المنزل بتحذيرهن حال وصول سيارة الوالد للتوقف عن الغناء وإخفاء الأسطوانات والجرامافون. وعندما اكتشف الوالد ما يجري ثار غضبه وحطم كل هذه الممنوعات المهربة من مصر.
كان محمد التركي محافظًا سياسيًا، شديد الولاء لآل سعود، حريصًا على انتمائه القبلي لفئة الشيوخ في نجد (وهم من يتأكد نسبهم لقبيلة عربية عكس من يُعتقد أنهم موالي أو عبيد معتقين). وأدى هذا لخلافات مع ابن الوحيد، الذي درس الهندسة في إنجلترا في الخمسينيات واقترب من الأفكار الاشتراكية والقومية الناصرية، كما فعل عدد من النخبة السعودية آنذاك، ما خلق بعض الجفاء بين الرجلين.
لم يكن الفصل بين الرجال والنساء وندرة وجود النساء في سوق العمل أمرًا سائدًا في المملكة وخاصة خارج المراكز الحضرية الكبرى. وفي كتابها المشترك مع دونالد كول عن عنيزة[3]، تقدم ثريا فصلًا غنيًا عن النساء البائعات وعملهن في تجارة التجزئة في الثمانينيات، إذ كن يدخلن في شراكات تجارية وائتمانية ومساومات مالية في السوق في عنيزة، رغم صرامة تغطية الوجه أثناء التعامل مع التجار الرجال. وكانت النساء العاملات في الزراعة أكثر تساهلاً مع الحجاب لحد ما. أما في الطبقات الوسطى، فقد عملت النساء في التدريس والتمريض والصحافة، شرط أن يكون العمل في "أوضاع لا تؤدي إلى الاتصال بالرجال."
نشرت ثريا التركي في عام 1986 دراسة عن وضع النساء السعوديات في الثمانينيات، عنوانها "النساء في المملكة العربية السعودية: الأيديولوجيا والسلوك بين النخبة".[4]تقدم السيرة تطبيقا عمليا لهذا السلوك عندما تستعرض ثريا دور أمها، المنتمية لهذه النخبة، في بناء علاقات وتحالفات تجلّت في عمليات الزواج والنسب بين الأسر، وفي تأثيرها على زوجها في قرارات تتعلق بتعليم البنات، وإرسال ثريا إلى مدرسة داخلية في بيروت، ثم سفرها إلى أمريكا، بعد أن استعانت في ذلك بأحد أزواج بناتها.
على صعيد شخصي، تقرّ ثريا بأنها كانت تخجل من أمها لأنها لم تكن متعلّمة بشكل لائق ولا تجيد لغات أجنبية مثلها مثل أمهات زميلاتها المصريات في الجامعة الأمريكية، بل وكانت تفصل بينها وبين عالمها الاجتماعي مع صديقاتها عندما تزورها في القاهرة. واستمرّ معها هذا الشعور بالعار تجاه أمّها، إذ كانت تقارنها بأمهات من تتعرّف إليهن، ومنهم أم زوجها الثاني، حيث نظرت إليهما على أنهنّ: "أمي الأمية، وأمه التي تعزف البيانو." وكانت ثريا تخشى من التعرض للسخرية من جانب صديقاتها "العصريات" بسبب عائلتها "التقليدية"، ما يعكس صراعً داخليًا في شخصيتها بين جذورها العربية التي استمرت في التمسك بها، ورغبتها في أن تكون جزء من المجتمع الحديث وأن تتحرر هي ذاتها. وتقول ثريا أنها أُعجبت بزوجها الثاني شاه رخ، وهو إيراني قضى معظم حياته في الغرب، إذ "وجدته مختلفًا عن أولئك الرجال الذين يصادرون الجلسة لحسابهم في محاولة لتأكيد رجولتهم، خصوصًا في حضرة امرأة، كما هو السائد في ثقافتنا العربية."
لا تذكر ثريا في كتابها وجود متمردات سعوديات في محيطها، باستثناء شقيقتها لطيفة، التي كانت تعاني من زيادة مفرطة في الوزن. وفي سن العشرين، فرت من البيت إلى منزل مجاور تسكنه عائلة الأمير فيصل (الملك لاحقًا)، ما جلب عارًا كبيرًا لرجال الأسرة. على إثر ذلك، حُبست في غرفة داخل المنزل، ثم نُقلت إلى مصحات نفسية في مصر، حيث خضعت لجلسات كهربائية لفترات طويلة نسبيًا، خرجت منها "مشوهة نفسيًا وجسديًا". توفيت لطيفة لاحقًا بمرض في القلب، بعد سلسلة من الزيجات الفاشلة، وظلت معظم الأسرة تتجنبها أو تسعى فعليًا إلى كسر تمردها وإجبارها على الدخول في قالب يُعد مقبولًا نسبيًا لدى الأسرة.
التحولات الاجتماعية
مثل كثير من العائلات البرجوازية في جدة، انتقلت عائلة ثريا من قلب البلد العتيقة إلى الضواحي الجديدة، حيث شُيّدت بيوت أضخم من طابقين أو ثلاثة، وسط حدائق تحيط بها أسوار عالية تصل إلى أربعة أمتار، لتوفير "غطاء يحجز النساء عن أنظار" المارة والجيران. خصص الطابق الأرضي للرجال والاستقبال، بينما كانت الأسرة تعيش وتنعزل النساء في الطوابق العلوية. وعلى عكس جدة القديمة، التي اتّسمت بأزقتها الضيقة وبيوتها المتلاصقة، ما أتاح للنساء مجالًا نسبيًل للحركة والعيش في فضاء اجتماعي يمتدّ خارج الأسرة، جاءت أحياء جدة الجديدة بنمط عمراني أمريكي الطابع: بيوت ضخمة مسوّرة، وشوارع واسعة متعامدة، مهيئة للسيارات. هذا التحوّل قطع صلة الفضاء بالعابرين سيرًا، وقيّد حركة النساء، التي باتت مرهونة بوجود سيارة وسائق من الرجال. وهكذا، تعمّقت عزلة النساء عن الفضاء العام.
رصدت الأنثروبولوجية الفرنسية أميلي لورونار تحوّلًا مشابهًا في الرياض، في كتابها "النساء والفضاءات العامة في المملكة العربية السعوديّة"، محتجة أن ما جرى لم يكن من باب الفصل القائم على التقاليد القبلية أو التعاليم الوهابية، بل نتيجة لسياسات الحكومة العامة التي كرست هذا الفصل المكاني وجعلته واقعًا ماديًا يصعب تجاوزه. وتتقاطع هذه الرؤية مع ما طرحته الأنثروبولوجية السعودية مي يماني في كتابها "مهد الإسلام: البحث عن الهوية الحجازية". وتتفق معهما الأكاديمية السعودية مضاوي الرشيد في كتابها "الدولة الأكثر ذكورية: الجندر والسياسة والدين في المملكة العربية السعودية"، إذ ترى أن تهميش المرأة يرتكز على سياسات اجتماعيّة وثقافيّة ودينيّة وضعتها السلطات السعودية، وليس على النفوذ الوهابي وحده، الذي لم يكن ليتمكن من فرض كل هذه القيود دون دعم السلطات وقهرها. فقد أصبحت المرأة، في نظر الرشيد، حجر ارتكاز في تنفيذ المشروع القومي السعودي الجديد.
وعندما قرر نظام الحكم التراجع عن بعض مظاهر الانفتاح النسبي عقب أحداث عام 1979 المزلزلة، من احتلال الحرم المكي، وثورة الخميني، والغزو السوفيتي لأفغانستان، كانت المرأة والفضاء العام من أوائل الضحايا. فقد عملت الحكومة بالتعاون مع العلماء على إعادة "أسلمة" الفضاء العام، فشُددت قواعد حجاب المرأة، وتكرّس الفصل بين الجنسين، وروّجت البدائل الترفيهية ذات الطابع الإسلامي، كما حُظرت كتب ومجلات وغيرها. وبعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، ومع سعي النظام السعودي إلى تبييض صورته، بدأت الرياض بانتهاج سياسات جديدة ضد الصحوة، ترافقت مع انفتاح تدريجي، وضغوط ومناشدات من جانب النساء من أجل نيل بعض المساواة في الحقوق. وبلغت هذه التحوّلات ذروتها مع وصول الملك سلمان ونجله محمد إلى السلطة في عام 2015.
وعلى عكس ما فعله الملك عبد العزيز المؤسس في عام 1929، حين هاجم الأجنحة المتشددة المسلحة داخل معسكر السلطة، وهم تنظيم إخوان من أطاع الله أو "الإخوان" وهم غير منظمة الإخوان في مصر وسابقون عليهم، ووهابيون في التوجه، ألزم محمد بن سلمان المطاوعة ومنتسبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيوتهم ومكاتبهم، يتقاضون رواتبهم من دون أي سلطة أو حضور فعلي في الفضاء العام. كما أرسل بعضًا من منتقديه من المحافظين، ولا سيما الإسلاميين مثل سلمان العودة، إلى السجون، في حين تراجع بعض أبرز رموز التيار المحافظ علنًا واعتذروا عن سنوات الصحوة. وقد فُتح المجال أمام منح المرأة حقوقًا أوسع في مجالات العمل والسفر والمشاركة في الفضاء العام. ومع ذلك، فإن هذا التحول لم يكن في جوهره ثقافيًا أو فكريًا في المقام الأول، بل انطلق، في الحالتين، من دوافع سياسية بحتة.
كان السفر إلى القاهرة وبيروت، ثم إلى أوروبا، عادة سنوية لعائلة ثريا والعائلات المشابهة لها منذ الأربعينيات. وبالنسبة إليها، كان ذلك انفتاحًا على عالم يتحدّث العربية، لكنه أكثر ترحيبًا بالنساء في الفضاء العام والحياة الاجتماعية. تتذكّر ثريا انبهار والدتها وشقيقتها منيرة عندما سافرتا إلى هناك في أوائل الأربعينيات بسبب مرض الأخيرة، فأقامتا في حيّ جاردن سيتي بجوار منزل السياسي المصري البارز آنذاك مصطفى النحاس. وتحكي كيف كنّ يتحدثن عن الأضواء الحمراء والخضراء التي كانت تلفّ واجهات المحال والبنايات بعد غياب الشمس.
ومع تدفّق عوائد النفط في الخمسينيات، تمتّعت العائلات الأكثر ثراء في جدة بنمط حياة جديد ومترف، شمل امتلاك عقارات خارج البلاد، لا سيّما في القاهرة وبيروت. في تلك المرحلة، بدأ السعوديون يتقبّلون بعض التغيّر في سلوك "نسائهم"، ومنه تعديل شكل وطريقة ارتداء الحجاب، حيث "أخذن بالتدريج يضعن وشاحًا على الوجه بدلًا من الطرحة ... كما انفتحن على المغنى والطرب وارتياد السينما والمسارح ... وكذا عادة التسوق من المحلات الكبرى مثل شيكوريل وعمر أفندي، والانخراط في نمط استهلاكي جديد." وتعرفت شقيقة ثريا على مغنية مصرية من الصف الثاني تُدعى حفصة حلمي، فتحت الباب أمام سيدات الأسرة للتعرف على حياة الفنانين المصريين ولارتياد المسارح وحفلات الغناء، كما دخلن عوالم الموضة والحياة "العصرية". وترصد ثريا بعض هذه التحولات في جدة بشكل أكاديمي في كتابها "جدة: أمّ الرخا والشدّة، تحوّلات الحياة الأسرية بين فترتين".
ولا تتحرّج ثريا من الإشارة إلى ثراء عائلتها، فتذكر كيف كان لديهم عبد وجواري في جدة أثناء طفولتها، أو كيف كانت والدتها، خلال مرضها، تقيم في منزلها في لندن برفقة ممرضة وثلاث مساعدات وطباخ، ذهبوا معها للقاهرة، حيث كان ثلاثة من أكبر الأطباء المتخصّصين يزورونها أسبوعيًا.
جواز سفر بلا صورة
في السابعة من عمرها، وفي مطلع الخمسينيات، التحقت ثريا بمدرسة إنجليزية داخلية (مسيحية تبشيرية) في لبنان، بعد أن اقتنع والدها فجأة بأهمية تعليمها. كان وداع الأم لحظة لا تُنسى في ذاكرة ثريا، إذ انطبع في ذهنها بكاء الأم الحار وتمزقها العنيف بين الدفع لهذا القرار والحزن العميق على فراق ابنتها. وصفت ثريا المدرسة بأنها كانت مكانًا غريبًا، حيث كانت كل الطالبات تقرأن الإنجيل وتصلين قبل النوم، بل ودرست في مدرسة الأحد واجتازت اختبارات في القصص الدينية المسيحية وسير القديسين. وقد أدركت لاحقًا أن والدها "المسلم المتدين لو كان يعلم ما أعيشه في تلك المدرسة ما تركني ساعة واحدة فيها، ولم يكن ليسامح نفسه على تركه لي في لبنان." ورغم إقرار ثريا بأن تعرّفها المبكر على التعاليم المسيحية منحها "انفتاحًا على أتباعها"، فإن التجربة تركت في أعماقها أثرًا خفيًا من الشعور بالنقص حيال مَن استطاعوا تقبّل حضارة الآخر دون عناء.
حتى ذلك الوقت، لم تكن الحكومة السعودية قد افتتحت بعد مدارس للبنات، وهو ما بدأ فعليًا في عام 1960. ولم يكن أمام العائلات المقتدرة والراغبة في تعليم بناتها سوى إرسالهن إلى مدارس داخلية في بيروت والقاهرة، أنشأها رجال أعمال سعوديون. لكن افتتاح مدارس للبنات داخل السعودية لم يكن أمرًا سهلاً؛ ففي مدينة بريدة في إقليم نجد، قوبل القرار باحتجاج الأهالي، فأرسل ولي العهد الأمير فيصل قوات مسلحة لفضّ الاحتجاجات. وتأجلت الدراسة هناك لعامٍ كامل، بعد أن زار وفد مكوّن من 800 رجل لتقديم اعتراضاتهم للديوان الملكي. وعلى النقيض، طالبت عنيزة، ضمن الإقليم نفسه، بفتح مدرسة للبنات.
وإذا كانت تلك المرحلة قد شهدت مقاومة شرسة من المعسكر الأصولي، انتهت بمساومة على شروط دقيقة تتعلق بالعزل والمراقبة، فإن ما نشهده اليوم من انفتاح اجتماعي وثقافي واسع يمرّ في ظل معارضة أصولية تكاد تكون متلاشية. فقد وافق الأصوليون آنذاك على فتح المدارس مقابل شروط من بينها أن تكون أسوارها عالية، وأن تُوضع "ستائر حاجبة خلف مدخل كل باب"، وأن يُعيَّن شخصان يتراوح عمرهما بين 50 أو 60 عامًا للإشراف على هوية كل من يدخل المدرسة، ولحراسة الطالبات حتى يحضر إخوتُهن أو آباؤهن لاصطحابهن.
وقد فُصل تعليم البنات عن التعليم العام، وأُخضع تمامًا لإشراف رجال الدين، بل إن الملك سعود في مرسومه الصادر عام 1959 برّر الخطوة قائلًا: "فلقد صحت عزيمتنا على تنفيذ رغبة علماء الدين الحنيف في المملكة في فتح مدارس لتعليم البنات العلوم الدينية من قرآن وعقائد وفقه، وغير ذلك من العلوم التي تتماشى مع عقائدنا الدينية، كإدارة المنزل وتربية الأولاد وتأديبهم مما لا يخشى منه عاجلًا أو آجلًا أي تغيير على معتقداتنا ... وقد أمرنا بتشكيل هيئة من كبار العلماء الذين يتحلون بالغيرة على الدين لتشرف على ... تنظيم هذه المدارس ووضع برامجها." وهكذا، أسهمت النخبة الحاكمة في خلق فضاء اجتماعي محدود للنساء، يقتصر على ما يُعرف بـالمجالات "النسائية".
كغيرها من بنات العائلات الكبيرة في السعودية والبلدان العربية المحافظة آنذاك، واصلت ثريا الدراسة في كلية داخلية للبنات كانت في الإسكندرية، حيث كانت ضمن مجموعة ضمت فتيات من عائلة الغانم الكويتية وعائلة النقيب العراقية. بعد مرور عام من تخرجها من المدرسة الثانوية بتقدير منخفض نسبيًا، لجأت ثريا إلى زوجي شقيقتيها - وهما دبلوماسيان- لإقناع والدها بالسماح لها بالالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة. ورغم التحاقها بها، ظلت متحفظة في تعاملها مع الرجال، وكأنها استبطنت القواعد الاجتماعية المحافظة، وخشت من الانزلاق في عوالم متحررة، كما كان يحذرها محيطها الاجتماعي. بقي هذا التحفظ ملازمًا لها طوال سنواتها الجامعية، حتى قررت بعدها العيش كما تشاء -أي، الخروج مع صديقاتها والذهاب للسينما!. لكن هذا التغير واجه عقبات متعددة منها رفض نساء المنزل لأسلوب حياتها الجديد، وهكذا صارت الأم وشقيقتيها منيرة وخديجة يوبّخنها على السهر والخروج المتكرر، خشية من تأثير سلوكها على أبنائهن، وهددن بإبلاغ رجال العائلة. وعندما لم تتراجع، استنجدت الأم بالشقيق الذي حضر إلى القاهرة، فاعتدى عليها بالضرب المبرح. وهكذا تعرضت ثريا لعنف بدني شديد علّقت عليه قائلة: "أخي المتعلم المتنور، الذي درس في بريطانيا وصاحب الأفكار التقدمية ... (الذي) لم يفلت من ازدواجية المثقف العربي، بين التمسك بتقاليد بالية حينًا، والتحرر منها حينًا آخر."
المفارقة أن العائلة نفسها وافقت، بعد مفاوضات وتدخلات من جانب بعض رجال العائلة، على سفر ثريا بمفردها بعد ذلك بفترة قصيرة إلى الولايات المتحدة لدراسة الدكتوراه في جامعة بيركلي في كاليفورنيا. بالنسبة لها، كانت الدكتوراه أيضًا وسيلة للهرب من العودة إلى جدة، حيث كان زواج تقليدي ومعد من جانب العائلة ينتظرها. "والحياة في كنف زوج يتحكم في شؤوني وأصبح ظلًا له ولقراراته؟! لا أريد ذلك على الإطلاق، ومن ثمَّ كان عليّ أن أتمسك بفرصة السفر وبداية حياة أكاديمية وعلمية ومهنية." وبفضل دعم والدتها ووساطة زوج شقيقتها، الدبلوماسي عبد الرحمن، وافق الأب. آنذاك، كان لدى ثريا جواز سفر سعودي لا يحمل صورتها الشخصية، ما أثار دهشة ضابط الهجرة في مطار بوسطن في أحد أيام كانون الثاني/ يناير 1967، واضطرت إلى الانتظار خمس ساعات ريثما سُمح لها بالدخول بعد عدة اتصالات.
مثل كثير من النساء العربيات اللواتي ذهبن إلى الخارج، بدأت ثريا تنظر إلى حياتها والعلاقات بين الرجال والنساء بشكل مختلف، وتزوجت من رجل أجنبي - كلاوس كوخ، أستاذ أنثروبولوجيا ألماني كان يدرّس في جامعة هارفارد. غازلها كلاوس لفترة ليست بالقصيرة في الولايات المتحدة وأبدى اهتماما شديدًا بدراستها ودعمها لأنه، وفقًا لها، كان "يريد أن يراني ناجحة ومتفوقة ... ولا أظن أن تلك سمة أصيلة في الرجل العربي، الذي لا يعير أمر نجاح زوجته أو حبيبته الاهتمام الكافي في الأغلب الأعم." تزوجا رغم رفض عائلتها، الذي لم يكن لأسباب دينيةـ إذ أشهر كلاوس إسلامه وأدى مناسك العمرة قبل طلب الزواج بفترة طويلة، ولكن النظام القبلي النجدي لا يبيح بسهولة زواج النساء من غير أبناء القبائل. بل إن الملياردير محمد بن لادن لم يتمكن من الزواج من امرأة نجدية ذات نسب قبلي، واضطر إلى الزواج من حضريات أو أجنبيات (والدة ابنه أسامة كانت سورية). غاب عن حفل زفاف ثريا في لندن شقيقتاها منيرة وخديجة المقيمتان في المدينة، وحتى والدتها، التزامًا بقرار الأخ الرافض للزواج. ولم يدم الزواج طويلًا؛ إذ توفي كلاوس في حادث عبثي في القاهرة، حين حاول النزول من شرفة الطابق العلوي إلى شرفتهم بعدما نسوا مفتاح المنزل، فسقط الرجل الأربعيني من الطابق الثالث وتوفر على الفور.
تُشير ثريا إلى أولوية السياسة على الثقافة، بل وعلى الشريعة نفسها، من خلال حادثة مذهلة تعرّضت لها، حين رفض مأذون في المركز الإسلامي في واشنطن تزويجها لغياب موافقة وليّ الأمر. جنّ جنونها، وصرخت في وجهه مؤكدة أنها ولية نفسها وفقًا للشرع، وأنها أرملة بالغة وعاقلة وأستاذة جامعية في الخمسينيات من عمرها. ومع ذلك، لم يتزحزح الرجل، واضطرت إلى مهاتفة أخيها، الذي أرسل لها موافقة موقعة، مدعومة بشاهدين من الرجال، إلا أن رئيس المركز رفض تلك الورقة، قائلًا إن الفاكس لا يُعد "دليلًا قطعيًّا على موافقة الأهل"، وإن تلك الأوراق مفروضة عليهم من السفارة السعودية، وإذا خالفوها "ستخرب السفارة بيوتهم." وربما كانت تلك المرة الوحيدة التي تنتقد فيها ثريا السياسات السعودية بصراحة، حين قالت: "لو كنت امرأة مسلمة غير سعودية، أو لو كنت رجلًا سعوديًا، لما كنت واجهت أيًّا من هذه المصاعب ... فمهما علت مكانة المرأة (في السعودية) ... فإنها تظلّ قاصرًا غير قادرة على اتخاذ قرارات تخصّها مثل قرار الزواج."
في الحقيقة، لو كانت ثريا رجلًا سعوديًا، لاحتاج أيضًا إلى موافقة الدولة، وذلك بموجب قرار حكومي صدر في منتصف السبعينيات، يفرض الحصول على تصريح للزواج، ويَحظر في الوقت ذاته زواج النساء السعوديات من خارج البلاد. وقد ارتبط هذا القرار جزئيًا بضغوط قبلية ومناطقية محافظة كانت ترفض الزواج "الأباعِدي"، أي الزواج من خارج القبيلة أو المنطقة. وقد اختبرت ثريا بنفسها في زواجها الأول، الذي قاطعته أسرتها بأكملها، ولم ينعقد إلا في لندن، على الأرجح كزواج مدني، لم يكن بحاجة إلى موافقة مؤسسة دينية خاضعة لهيمنة سعودية، كما هو حال المركز الإسلامي في واشنطن في حالة زواجها الثاني.
عالم خال من السياسة
على الرغم من أن ثريا كانت تزور مصر ولبنان في الخمسينيات والستينيات، إلا أنها لم تتعرف على الصهيونية كأيديولوجيا سياسية، ولا على أبعاد القضية الفلسطينية، حتى التقت بطلبة عرب في جامعة بركلي في كاليفورنيا عام 1967. وتورطت مجموعة الطلاب العرب المحيطة بها في نقاشات حادة حول ما إذا كان عليهم جميعًا مغادرة أمريكا والعودة إلى بلدانهم للمشاركة في الصراع، أم الاستمرار في دراساتهم. وفي النهاية، فوّضوا أحد الزملاء ليزور بلدان المنطقة ويعود لهم بتقرير وافٍ. دفعوا لزميلهم كل نفقات السفر، ولم يعد الرجل الذي تولى لاحقًا منصبًا مهمًا في حكومة بلاده. حاول الطلاب العرب تنظيم مظاهرة في مواجهة مظاهرة أخرى مؤيدة لإسرائيل، فانقضّ عليهم الصهاينة وأوسعوا المتظاهرين الثلاثين ضربًا مبرحًا، نُقل على إثره عدد منهم إلى المستشفى.
ربما كانت التعليقات والتحليلات السياسية أضعف جوانب كتاب ثريا، واقتصرت على عروض خبرية وحديث عن مشاعر بالذهول والمفاجأة، ومساعٍ للتعبير عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. وتقول إنها داومت على قراءة هيكل وكتبه في السبعينيات لأنه كان يذكرها بالفترة الناصرية وتعلّقها بالزعيم الراحل، وتسخر من تلك الفترة قليلًا بقولها: "كم كنا بائسين في تلك الفترة أو حالمين طوباويين." ولا حديث في الكتاب عن السعودية والدول العربية رغم تطورات عديدة في العقود التي يتعرض لها الكتاب.
في الخمسينيات، ظهرت في السعودية تنظيمات يسارية وقومية عربية، ونُظّمت إضرابات من جانب عمال شركة أرامكو لأسباب نقابية، بينما ازداد الوعي والاهتمام الشعبي بالقضية الفلسطينية، في ظل لا مبالاة حكومية دشّنها الملك سعود المهتم حصريًا بتوطيد دعائم ملكه.
وكانت المعارضة السياسية معنية في تلك الفترة بالسؤال الاجتماعي وبنية السلطة، لكنها لم تمثل قط تهديدًا جديًا لسلطان آل سعود. ومع ذلك، لجأ النظام إلى قمع شرس شمل الاعتقال والإخفاء معارضين أو استمالة وتدجين عدد كبير من المثقفين المناوئين في مؤسسات الدولة ثم الجامعات لاحقًا. وبعد غزل وتحالف قصير بين الملك سعود وعبد الناصر، تباعدت المملكة عن الخط القومي العربي، وتبنّى الملك فيصل أيديولوجيا إسلامية في مواجهة القومية العربية والناصرية في الستينيات وأوائل السبعينيات، بالتوازي مع تبنّي سياسة تحديث جادة لمؤسسات الدولة. وتحولت السعودية في عهده، بسبب عائدات النفط الضخمة، إلى دولة ريعية تشتري ولاء فئات المجتمع ماديًا. وجرى كل هذا دون أن تغيير في طبيعة الملكية المطلقة، وهو النهج الذي استمر عليه معظم من خلفه، وإن قل كثيرًا دعم التيارات الإسلامية المحافظة خارج السعودية عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.
شهدت المعارضة السعودية تحوّلاً في الثمانينيات، مع صعود الصحوة الإسلامية الجديدة، وثم في التسعينيات عقب صدمة شعبية بسبب الاضطرار لاستقدام مئات الآلاف من الجنود الأمريكيين للدفاع عن البلاد ضد تهديد الغزو العراقي. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، قادت النساء أول مظاهرة احتجاجية مطالبات بحق قيادة السيارة، تزامنًا مع توافد هؤلاء الجنود والجنديات الأمريكان على أراضي المملكة.
ارتفعت أصوات المعارضة مطالبة بالإصلاح السياسي؛ فبرز دعاة إسلاميون محافظون، مثل سفر الحوالي وسلمان العودة، وتمتّعوا بشعبية واسعة، بينما دعا معارضون علمانيون لتأسيس مجلس شورى، وتحقيق المساواة بين المواطنين، وتوسيع مشاركة المرأة. ومع مرور الوقت، تراجع التيار التحديثي إلى هامش يركز على الهوية ونمط الحياة والقيم، فيما انقسم السلفيون بين من دان بالطاعة والولاء للحكّام (السلفية المدخلية والعلمية)، ومن عارضها علنًا لأسباب شرعية (السلفية الجهادية).
بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، انتهى دعم الدولة للصحوة الإسلامية، ضمن مسعى قادته الأسرة الحاكمة لطمأنة الولايات المتحدة التي غضبت بعض دوائرها نظرًا لأن معظم منفذي الهجمات كانوا سعوديين. وبالرغم من أن التحولات كانت بطيئة للغاية، فإنها ركّزت على مهاجمة السلفية الجهادية وتجفيف منابع الدعم المادي للمنظمات المتطرفة، دون أن تحاول تغيير قواعد الحياة العامة في البلاد، وهو ما لم يتحقق فعلاً إلا مع زلزال الربيع العربي في المنطقة ووصول محمد بن سلمان إلى مسرح السياسة في العقد الماضي.
الخيط الناظم لكل هذه التحوّلات كان مساعي الأسرة أو المهيمنين على مقاليد السلطة فيها من أجل الاحتفاظ بالعرش واستقرار المملكة دون مساس بجوهر النظام السياسي القائم على الملكية المطلقة. وقد تطلّب ذلك توازناً دائمًا بين الالتزام الشكلي بقواعد إسلامية من جهة، وتحديث المجتمع من جهة أخرى، عبر تصدّعات متراكمة في بنيته القبلية والثقافية والدينية. ومنذ السبعينيات، بدأ دور الإسلام الوهابي في إضفاء الشرعية على الدولة يتضاءل تدريجيًا، ليحلّ محله النفط والريع وتوزيع العطايا، محليًا وإقليميًا ودوليًا. وفي الحالتين، لم تكن القوة وحدها هي ما يحفظ الحكم، بل اقتناع قطاع مؤثر من السعوديين بشرعيتها وأفضليتها على أنظمة أخرى مجاورة، وخاصة منذ الانتفاضات العربية المجهضة في عام 2011.
ولكن كل هذه التحوّلات لا تجد لها مكانًا، ولو بالتلميح، في كتاب ثريا. لا شك في أن الكتاب يفتح نوافذ متعددة على تاريخ السعودية، إلا أن نوافذ أكثر ظلت مغلقة المصاريع أو مواربة، للأسف.
الكتب لا تكفي
خلال إحدى زياراتها إلى لندن، تلقّت ثريا نبأ موافقة جامعة أمريكية على طباعة كتابها. غمرتها السعادة، إذ كان ذلك يعني ترقيتها في الجامعة الأمريكية في القاهرة. لكنّ هذا الإنجاز لم يُقابل بأي اهتمام من والدتها أو أهلها؛ فلم تجد من تشاركه فرحتها سوى محمد، طباخ الأسرة، الذي لم يدرك بدوره معنى ومغزى ما حققته. وعندما حصلت بالفعل على الترقية إلى أستاذ مساعد، أبلغت أمها بفرح، لكنها تلقت ردًّا بالردًا مثل "دش بارد نزل على رأسي: وقالت: "لست أدري إلى متى ستستمرين في الفرحة بالكتب يا ثريا؟"
قبلت ثريا عروضًا للعمل في جامعات سعودية، لكنها كانت تجارب مزعجة انتهت سريعًا. وتقترب ثريا في وصف إحباطاتها خلال تلك التجارب من انتقاد للمؤسسات في السعودية. ففي عام 1971، دعتها جامعة الملك عبد العزيز لتدريس العلوم الاجتماعية. غير أنها لم تُكلّف بتدريس أي مادة في سنتها الأولى، بينما شكّك البعض في "الشرعية الدينية" لتخصصها في الأنثروبولوجيا. أما خارج الجامعة، فواجهت قيودًا عديدة على المرأة، بما فيها بنات الطبقة العليا مثلها، في التعامل مع الهيئات الرسمية والمصارف. لم تختلف الجامعة عن المدارس الثانوية، كما تقول، إذ عانت من "نفس المناخ المتشدّد والمنغلق، (حيث) تتتابع المحاضرات مثل تتابع الحصص المدرسية، توجد مكتبة لكن لا وقت لدى الطالبات للذهاب إليها، في نهاية اليوم يركبن الباصات إلى بيوتهن مثل التلاميذ الصغار. كان كل شيء في قسم الطالبات يخضع لمراقبة قسم الطلاب ... وكان من رابع المستحيلات السماح أن تطأ قدما رجل قسم الطالبات ... كان الأمر أشبه بالحرملك."
واللافت أن ثريا تقول بعد هذه الفقرة أنها فوجئت حيث "لم أكن أعرف شيء من هذا قبل حضوري من أمريكا." وهو أمر مذهل أن تكون باحثة سعودية في موقعها لا تعرف وضعية مؤسسات ومدارس تعليم المرأة في بلادها. لم تمكث هناك طويلًا؛ استقالت بعد أشهر قليلة. وبعد سنوات، عادت إلى السعودية أستاذة زائرة في جامعة الرياض، لكنها تحمّلت القيود لأسابيع فقط، بما فيها أنها كانت عاجزة عن تناول وجباتها في مطعم الفندق لعدم وجود "محرم" يرافقها.
نساء في قلب التحوّل السعودي
منذ نجاحه في تأمين شبه سلطة مطلقة في السعودية، يسعى ولى العهد محمد بن سلمان إلى بناء قاعدة دعم مجتمعية لا تعتمد على الأسرة الحاكمة، التي تمرّ بمرحلة انتقال، ولا على المؤسسة الدينية المحافظة التي كانت شبه شريك غير معلن في إقامة المملكة منذ بداية مساعي أسرة آل سعود في وسط البلاد في القرن الثامن عشر. لطالما شكّلت الوهابية، التي تتسم بالسلفية المفرطة والهيمنة الأبوية والذكورية، حليفًا مهمًا في تأسيس سلطة آل سعود وهيمنتهم، خاصة وأنهم، افتقروا في بداياتهم إلى العمق القبلي أو الديني مقارنةً بمنافسيهم من آل الرشيد في نجد، أو أشراف مكة في الحجاز، أو تجار الأحساء في الشرق.
ما يقوم به ابن سلمان هو انقلاب واسع النطاق وهادئ في طريقة توزيع الثروة والسلطة في المملكة، مع تركيز متزايد للقرارات الرئيسية في يد الملك الحاكم، وبناء قاعدة شعبية واسعة داعمة دون أن تشارك في السلطة، وإن كانت تُظهر التأييد له. ومن أبرز وجوه هذا التحوّل: عودة النساء إلى الفضاء العام، وللعمل العام والخاص، ومشاركتهن المتزايدة في المجتمع. ولا يعود هذا التغيير فقط إلى تحجيم نفوذ المؤسسة الدينية أو تراجع هيمنة الرجال، بل يرتبط أيضًا بعوامل اقتصادية. ففي كتابها عن عنيزة، رصدت ثريا التركي كيف كان دخل النساء من العمل عاملًا مهمًا في دخولهن سوق العمل، وكيف أدّت الطفرة النفطية، وما صاحبها من إفراط الدولة في الإقراض عديم الفائدة، إلى تراجع هذا العامل، فانخفض معدل توظيف النساء في الثمانينيات. وتوقعت التركي حينها أن تعود مساهمة النساء في ميزانية الأسرة لتصبح عاملًا مهمًا في توظيفها وفتح مجال العمل أمامها، إذا تغيرت الظروف الاقتصادية. ربما يكون هذا بالفعل أحد الأسباب الثانوية لما يجري اليوم في المملكة.
وفي أحد مولات الرياض، حيث تعمل نساء كثيرات، لخّصت شابة تحمل صورة ابن سلمان على شاشة هاتفها شعور جيل الشباب، وخاصة الشابات، بالامتنان لهذا الرجل الذي فتح المجال العام أمامهن. فعندما سُئلت عن سبب وضعها للصورة، أجابت بالإنجليزية: "He's my hero"- "إنه بطلي". وغالبًا سيصير هذا "الفضل"، المرتبط بدوافع كثيرة اقتصادية واجتماعية مع الوقت، أمرًا واقعًا يستحيل عكسه، وسيكون دور ابن سلمان هو أنه فتح بابًا كان على وشك التصدّع. فما يجري في السعودية ليس تنازلًا ولا مِنّة من رجل بعينه، بل تحوّل حقيقي في بنية نظام حكم ورقابة مجتمع برمته، وقطيعة مع عرف ساد المملكة منذ تأسيسها، حيث كانت النساء، طوال عقود، تحت رحمة الرجال ونزواتهم، وخاصة رجال أسرهن.
المراجع التي اعتمد عليها النص في رصد تحوّلات المجتمع السعودي وتحليل السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية:
دراسات:
مضاوي الرشيد (2002)، "تاريخ العربية السعودية بين القديم والحديث"، لندن: دار الساقي.
-------------- (2005)، "مأزق الإصلاح في السعودية في القرن الحادي والعشرين"، لندن: دار الساقي.
-------------- (2016)، "الدولة الأكثر ذكورية: المرأة بين السياسة والدين في السعودية"، كولونيا: منشورات الجمل.
ثريا تركي (2024)، "حياتي كما عشتها: ذكريات امرأة سعودية من عنيزة إلى كاليفورنيا"، القاهرة: دار الكرمة.
--------- ودونالد كول (1991)، "عنيزة: التنمية والتغيير في مدينة نجدية عربية" بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية.
--------- وأبو بكر باقدر (2006)، "جدة أم الرخا والشدة: تحولات الحياة الأسرية بين فترتين"، القاهرة: دار الشروق.
كيم غطاس (2023) الموجة السوداء: المملكة العربية السعودية وإيران"، بيروت: جسور للترجمة والنشر.
أليكسي فاسيلييف، (1995)، ""تاريخ العربية السعودية"، بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.
ستيفان لاكروا (2012)، "زمن الصحوة: الحركات الإسلامية المعاصرة في السعوديّة"، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث.
مي يماني (2005) "مهد الإسلام: البحث عن الهوية الحجازية"، لندن: دار الساقي.
--------- (2010)، "هويات متغيرة: تحديات الجيل الجديد في السعودية"، لندن: دار رياض الريس للكتب والنشر.
أعمال أدبية:
تركي الحمد (1995-1999)، ثلاثية أطياف الأزقة المهجورة "العدامة" و"الشميسي" و"الكراديب"، لندن: دار الساقي.
رجاء الصانع (2005)، "بنات الرياض"، لندن: دار الساقي.
عبده خال، (2009)، "ترمي بشرر"، كولونيا: منشورات الجمل.
عبد الرحمن منيف (1984 حتى 1989)، خماسية مدن الملح "التيه" و"الأخدود" و"تقاسيم الليل والنهار" و"المُنْبَتّْ" و"بادية الظلمات"، أصدرت الخماسية عدة دور نشر منها المدى والساقي والآداب المؤسسة العربية للدراسات والنشر .




