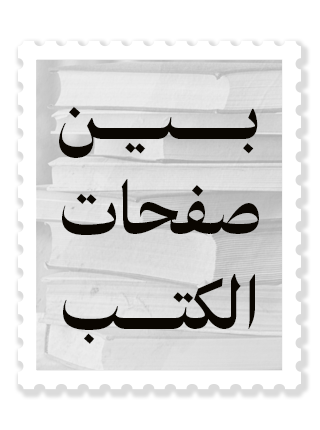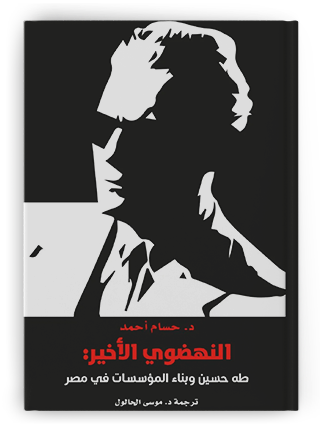يستعرض خالد منصور في هذا النص "مذكرات عزة فهمي: أحلام لا تنتهي"، من خلال قراءة تبيّن هشاشة الادعاء المتوارث بتفوّق الذكور تاريخيًا. تستعيد عزة مراحل حياتها: طفلة، وشابة عاشت الستينيات والسبعينيات، وامرأة كسرت الحواجز في حرفة يهيمن عليها الذكور، ثم رائدة أعمال حملت علامتها إلى العالمية. من خلال هذا النص، تُقرأ سيرتها بوصفها نموذجًا يقوّض ادعاءات تفوّق الذكور، ويضيء على تقاطعات الهُوية والفرصة والجهد والدعم الاجتماعي في تشكيل التجربة الإنسانية والمهنية.
يمكن الاستماع إلى نقاش مع خالد منصور ودينا عزت حول هذه المراجعة عبر هذا الرابط.
خالد منصور [1]
يدّعي كثير من الذكور أن جنسهم فاق النساء طوال التاريخ، والدليل الذي يرونه دامغًا وقاطعًا هو أن الغالبية العظمى من الحكّام والأنبياء والفلاسفة والموسيقيين هم من الرجال، ناهيك عن التجار والرأسماليين والجنود. التاريخ ووقائعه في عرفهم ثابتة، بغضّ النظر عمّن كتبه ولماذا وتحت أيّ معايير. يمكن أن نقبل الوقائع الإحصائية أو نجادلهم بتقديم أمثلة على حاكمات ونبيّات وفيلسوفات وموسيقيات، إلخ، لكن هذا مضيعة للوقت؛ فالمشكلة الكامنة هنا أن هذا الادعاء لا يقدم أي تفسير مقنع لظاهرة التفاوت التاريخية هذه بين الذكور والإناث، ويكتفي بالقول إن هناك جنسًا متفوقًا على ما عداه، بدليل أنه متفوق! وهكذا يفسرون الماء بعد الجهد بالماء. ينتبهون أحيانًا إلى المفارقة المذهلة في مقولاتهم عندما ينقلب السحر على الساحر، فيصبح الرجل الأبيض الغربي "متفوقًا چينيًا" على الرجل الأسمر الشرقي، لأنه هزمه وتسيّد عليه معظم التاريخ، وهذا ثابت أيضًا!
هذا جدل عقيم لن يغيّر الكثير، لأن الدافع وراءه هو في النهاية الدفاع عن مصالح فئة أو مجموعة معينة، ووضع تفسير أبدي يتسربل بالعلمية لمكانتهم المتميزة. الدافع، سواء كان واعيًا أو دفينًا، هو إبقاء الحال على ما هو عليه، أو دفع النساء بعيدًا عن المجال العام، بدلًا من التبصّر الجاد في كيفية إسهام الظروف التاريخية والاجتماعية، وإلى حدّ ما البيولوجية، في خلق هذه التفاوتات وتعميقها.
وتصير هذه التفاوتات مفيدة حتى لمن لا يؤمن بها بالضرورة، إذ يستعملها الرأسماليون الليبراليون في العصر الحديث لتحويل الفئات "الأدنى" من النساء والأطفال إلى يد عاملة أرخص بكثير من الرجال، أو لاستعمال الرجال المهاجرين أو المستضعفين بأجور شديدة التدني مقارنة بالرجال البيض.
في كل الأحوال، على المرأة أن تعمل أكثر من الرجل بكثير كي تنال معاملة مشابهة في السوق أو مكان العمل، وأن تكون محظوظة بانتمائها إلى طبقة معينة أو امتلاكها شبكة اجتماعية مساندة تساعدها على الصعود.
المرأة التي صارت فنانة حُلِيّ عالمية!
لا يمكن تفادي مثل هذه الأفكار – أو على الأقل لم أتمكن من طردها بعيدًا – وأنا أقرأ "مذكرات عزة فهمي"[2] الصادرة في القاهرة عن الدار المصرية اللبنانية عام 2021، والتي تروي كيف ناضلت في حرفة كانت وما تزال – باستثناءات قليلة- مقتصرة على الرجال، خصوصًا في مصر، لتصنع لنفسها مكانة محلية ثم إقليمية، قبل أن تكتسب شهرة عالمية بوصفها فنانة وحرفية في صناعة الحُلي.
تلمّح سيرة عزة، من دون أي نزعة للتفاخر، إلى أن نجاحها المبهر كان حصيلة دأب وعمل يفوق بأضعاف ما قد يضطر له الرجال لنيل المكانة نفسها. كما تُظهر كيف كان لدعم الأسرة، المعنوي والمادي، دور كبير في مسيرتها، إلى جانب إصرارها المستمر على العمل في حرفة شُغفت بها، رغم صعوبة الطريق الذي سارت فيه معظم الوقت وحيدة، كامرأة تولّت رعاية ابنتيها بمفردها بعد الطلاق. وأخيرًا تشير السيرة إلى دور خلفيتها الثقافية والطبقية في صعودها، إذ استفادت من دعم مادي معقول وأسري قوي، ثم من شبكة علاقات اجتماعية واسعة لاحقًا.
لقد أسهم دعم الأسرة منذ طفولتها في أربعينيات القرن الماضي في تكوين شخصية قوية، مُحاطة بالحب والاهتمام والتنوع الثقافي، داخل عائلة من الطبقة الوسطى العليا في سوهاج بصعيد مصر، من أب ذي أصول سودانية وأم ذات أصول تركية. لم تعانِ عزة كثيرًا كونها فتاة في ما يتعلق بالتعليم والعمل، لكنها فرضت على نفسها لاحقًا قيودًا، خاصة في ما يتعلق بالجسد والعاطفة، وهي قيود تتحدث عنها باقتضاب في كتابها البالغ نحو 400 صفحة.
وتَرِد في مذكراتها إشارات محدودة إلى جذورها السودانية، التي تعود إلى جدتها حوّا الضو، التي تزوّجها الجد المصري محمد فهمي في ولاية كردفان بوسط السودان، عندما كان يخدم في الجيش الإنجليزي- المصري المختلط في مطلع القرن الماضي.
في فصول النشأة الأولى، يبدو العالم الذي عاشت فيه عزة استعماريًا وبعيدًا، لكن عالم أبيها عندما كان في مثل عمرها كان أشدّ غرابة، بمعنى انقطاعه الكبير عن حاضرها وعن حاضرنا. الأب، الذي سيصير لاحقًا محاسبًا في شركة إنجليزية للقطن في صعيد مصر، قضى بعض سنوات طفولته في مدينة چوبا، العاصمة الحالية لجنوب السودان. ويحكي الأب أن الخوف تملكه عندما مرّ أسد أمام منزلهم هناك، فغضبت أمه خشية أن يغدو ابنها جبانًا، ودَفعت الزوج إلى صيد أسد واستخراج قلبه وطهيه وإطعامه للصبي الذي أصبح -كما تقول- "طول عمره رجل شجاع، مش عارفة لأنه كل قلب الأسد ولا لأن طبيعته كدة؟". وبغض النظر عن واقعية القصة وما إذا كانت قد حدثت بالفعل، فهي تشير إلى عالم بات سحريا وغرائبيًا.
ينسى معظم المصريين اليوم تلك العلاقة المتشابكة مع السودان حين كانت مجرد ولاية تابعة بعد أن فتحها الوالي الألباني العثماني محمد علي سنة 1820 لجلب العبيد والذهب، وظل حكمها بيد جيش مصري تركي حتى سيطرتْ إنجلترا على مصر سنة 1882. وقد حكمت السودان فعليًا، مستغلة وجود الجيش المصري تحت قيادة ضباط إنجليز، كان منهم في فترة ما ونستون تشرشل الذي أصبح رئيسًا لوزراء إنجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية. وبقي السودان مرتبطًا بمصر حتى استقلاله عنها وعن الحكم الإنجليزي الفعلي والمصري الاسمي، في منتصف خمسينيات القرن الماضي.
بين نار المدفأة وأعمدة النور في الشوارع
نشأت عزة في فيلا بها حمّام سباحة وملعب إسكواش وحديقة كبيرة بها غرف للضيوف وحوض أسماك ملوّن. وكان لأبيها مكتبة، معظم كتبها بالإنجليزية، في غرفة تحتوي على مدفأة. كانت الكتب تصلهم شهريًا في صندوق خشبي بالبريد من لندن. وتتذكر عزة أن "الوقت المفضل للقراية عنده هو المساء قدام المدفأة، أشوفه أحيانًا قدامه كوب ويسكي بالثلج وهو يقرأ". تتذكر أنه أهداها كتاب رسائل الزعيم الهندي نهرو إلى ابنته أنديرا. وكان الأب ينظّم حفلات يحضرها كبار المهنيين في المدينة من الأجانب والمصريين وزوجاتهم، "ولا واحدة منهم كانت ترتدي الحجاب، وكان تقديم المشروبات الكحولية يتم دون أي حرج".
ترسم الكاتبة ملامح نمط حياة أقلية صغيرة موسرة في مصر الأربعينيات التي كانت تمور بحراك اجتماعي وسياسي بين العمال والطلبة والقوميين وغيرهم من التيارات السياسية، احتجاجًا على الفوارق الاجتماعية الحادة، والنظام السياسي النخبوي المتمسك بإقطاعيته، والاحتلال الإنجليزي. لا تتحدث عزة عن هذه الجوانب السياسية مباشرة، غير أنها لا تتفادى وصف كيف كان معظم المصريين يعيشون في تلك الفترة؛ فتتطرّق إلى شيوع الحفاء بين عموم الناس، وغياب الكهرباء، حيث كان الأطفال يذاكرون تحت أعمدة النور العمومية في الشوارع، بينما كانت عائلتها تذهب في رحلة صيف منتظمة لشاطئ البحر أو خارج البلاد.
ورغم أن الأم أدت دورًا أكبر بكثير من الأب، الذي توفي وعزة لا تزال مراهقة في الثالثة عشرة من عمرها، فإن حضورها في الكتاب محدود. ففي الإهداء تُذكر بصفتها صاحبة التجربة التي تعلمت منها عزة، لكنها لا تظهر بالقوة نفسها التي يظهر بها الأب، ولا بالقدر ذاته من تفاصيل حياته ومكتبه وأصدقائه. كانت الأم من الجانب الفقير من عائلة أرستقراطية ذات أصول تركية؛ فوالدها كان موظف حكومة بسيطًا مات مبكرًا، تاركًا للأم سبعة أطفال، من بينهم زبيدة أم عزة. وستتكرّر هذه القصة مع زبيدة التي صارت حياتها وتربية أطفالها مهمة شاقة للغاية بعد وفاة الزوج و"رب الأسرة" ومصدر دخلها. وستتكرر أيضًا مع عزة نفسها التي انفصلت عن زوجها وربّت طفلتيها بمفردها.
يبرز التنوع العرقي والجغرافي والديني كأحد ملامح حياة الطبقات الوسطى والعليا في مصر اعتبارًا من أواخر القرن التاسع عشر وحتى خمسينيات القرن العشرين. ففي محلج القطن الذي عمل فيه الأب في صعيد مصر، ثم في حياتهم في القاهرة بعد وفاته، كان هناك مهندسون وفنيون وتجار فرنسيون وإنجليز وشوام، وجيران يهود وأرمن وروس ويوغسلاف. غير أن الكتاب لا يتحدث كثيرًا عن علاقات أسرة عزة بهذا التنوع، سوى في إشارات قصيرة، لعل أهمها إشارتها إلى قصة الجار الطفل منير ليشع الذي غادر مع عائلته اليهودية في أواخر الخمسينيات، وانتهى به المطاف مجنّدًا في الجيش الإسرائيلي عام 1967. وهناك، وفي مصادفة ميلودرامية، التقى في ميدان القتال أستاذه فايق المغازي، مدرس التربية الرياضية في المدرسة التي تخرّج منها، "فأرشد الأستاذ فايق واللي معاه من المجموعة (الجنود) إلى طريق العودة لمدن القناة" أثناء انسحابهم من سيناء مع بقية الجيش المصري المغدور بسبب رعونة قياداته.
ربَّ صدفة خير من ألف خطة!
التحقت عزة بكلية الفنون الجميلة بالمصادفة، بعد أن أقنعها عمّها -المتخرّج من الكلية نفسها- بأنها مناسبة لها. وتخرّجت دون أي أحلام فنية واضحة، ثم عملت في مصلحة الاستعلامات الحكومية في منتصف الستينيات لتصميم النشرات السياسية، وهناك بدأت تشعر بالملل وغياب الشغف بعملها اليومي. عندها بدأ البحث، ومعه بدأت دائرة علاقاتها -التي ستواصل تأدية دور مهم في حياتها كلها- بالتحرّك. جرّبت الرسم للأطفال بسبب علاقتها مع الرسام الشهير إيهاب شاكر، ثم خاضت تجربة صناعة الخزف مع الفنانة السويسرية إيفلين بواريه المقيمة في الفيوم، لكنها لم تثابر في تلك المحاولات التي لم تستولِ على ما يكفي من اهتمامها: "كنت بزهق بسرعة".
وأدت صدفة ثانية دورًا حاسمًا في اكتشاف الشغف، عندما زارت معرض القاهرة الدولي الأول للكتاب في 1969، حيث تعثرت في كتاب ألماني عن الحُلّي. لا تعرف عزة اللغة الألمانية، ولكن صور الحُليّ على الغلاف وداخل الكتاب جذبتها بشدة، لدرجة أنها أنفقت تقريبًا راتب شهر بأكمله على شراء كتاب يانا نيورت[3] عن "الحُليّ الصغيرة في العصور الوسطى". عزة، التي ستحدثنا لاحقًا عن دور القدر والسماء والنجوم في تحديد مسار الإنسان، أدركت وهي تتصفّح الكتاب أنها وجدت طريقها، وأن صناعة الحُليّ "هي المهنة التي هبطت عليّ من السما في لحظة قدرية ... من قوى عليا".
وتمضي عزة بعيدًا في وصف علاقتها بالمهنة/الفن الذي سيستغرق بقية حياتها، قائلة: "هي علاقة حب وعشق، وفعلًا علاقة مماثلة لعلاقة الحب بين الرجل والست ... حالة إدمان غير مفهومة. مفتكرش يوم عدى عليّا في حياتي معملتش فيه حاجة خاصة بمهنتي: فكرة، قراءة شعر أو حكم، تصميم، إلهامات تيجي وأنا ماشية، مشروع جديد... متهيألي لو قطعت شراييني هينزل منها خواتم وأساور".
وهكذا كانت تنهي عملها بعد ظهر كل يوم في مصلحة الاستعلامات في وسط القاهرة الخديوية، ثم تذهب إلى الأسطى رمضان في حي خان الخليلي، قلب القاهرة الإسلامية، بجوار الجامع الأزهر ومسجد الحسين، ليعلمها أصول حرفة "الصيّاغ" وهم من يقومون بصهر وتشكيل المعادن النفيسة ويحوّلونها لحليّ ترتديها النساء. علمتها دراسة الفنون الجميلة مبادئ التصميم وطرقه، لكن "الأسطوات" المتتالين في خان الخليلي علموها كيف تحوّل تصميماتها من خطوط لحُليّ فعلية، أي علموها "الحرفة".
وهنا نرى الدأب الشديد؛ فهي تعمل في هيئة حكومية صباحًا، وبعد الظهر تمضي ست ساعات أخرى في محترف/ورشة الحُليّ. ومن أسطى إلى آخر، ومن مهارة لأخرى، صارت الشابة الجامعية والموظفة الحكومية "صبي" متدرب في ورشة تتعلم صياغة الحُليّ بالطرق التقليدية، مستعملة مقصًا وطريقة لحام تشبه ما تعرضه المتاحف والنقوش من العصر المصري الفرعوني القديم، خاصة من الألفية الثانية قبل الميلاد، وكلمات لوصف طرق الصنعة وأجزاء الحُليّ تعود بعضها للعصر المملوكي من القرون الوسطى.
كانت عزة تدفع ثلاثة جنيهات أسبوعيًا -ربما نصف راتبها آنذاك- للأسطى كي تتعلم الصنعة، مما كان يضطرها أحيانًا إلى المشي مسافات طويلة لتوفير ثمن المواصلات العامة. ومنحها هذا التجوال معرفة دقيقة بشوارع وحارات وأزقة مصر الإسلامية المملوكية، وبمن يعملون فيها في دق النحاس وصناعة المنسوجات وغيرها من الحرف. وفي هذه الأحياء اختلطت مع الصنايعية وعائلاتهم، وذهبت مع نسائهم إلى الحمام العام، وهو أمر غير معتاد في طبقتها.
وتجلّى شغفها وحبها للصنعة في عقد علاقات كثيرة مع مختلف الحرفيين: من يصهرون المعادن، ومن يطلّونها، ومن يدقونها ويشكلونها، ومن يصنعون خيوط الذهب الرقيقة المستخدمة في التطريز (التقصيب). وهكذا، صقلت روحها الفنية وتعليمها الأكاديمي بمعرفة حدود وإمكانيات الواقع الحرفي والخامات التي تعمل عليها. كما أنها صارت خبيرة بالمدارس الفنية المختلفة والتطبيقية، وأدوات الزينة اليومية واستعمالاتها على مر عصور تاريخية متنوعة، ومن خلفيات تاريخية وثقافية مختلفة، حيث صادقت صنايعية وتجارًا من مختلف أنحاء مصر، بعضهم من أصول أرمنية وإيرانية أو يهودية. ولأنها كانت تمشي كثيرًا، فقد كانت تستهلك أحذيتها بسرعة، مما جعلها تداوم على زيارة إسكافي يصلح النعال على الرصيف في وسط القاهرة، فتجلس بجواره حتى يجعل نعل حذائها صالحًا للمشي مرة أخرى.

مصدر الصورة: الموقع الرسمي، "قصة عزة فهمي"
تستلهم عزة في تصميمات حليّها العديد من الموتيفات[4] المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، إضافة إلى ثقافات فرعية متنوعة من مصر المعاصرة، من سيناء إلى سيوة وحلايب وشلاتين. وهي بذلك تعيد إنتاج الماضي ليصبح رائجًا ومعاصرًا، خاصة بين الطبقات العليا القادرة على دفع مبالغ طائلة. تتذكر كيف كانت تقضي وقتًا طويلًا بين تجار النحاس القديم في الأسواق، تشتري صينيات وأواني وأكوابًا ولمبات وأباريق، ثم تعود بها فرحة إلى المنزل، فتسألها أمها: "إيه يا بنتي الكراكيب اللي عمالة تلملميها دي؟ إحنا في بيت جدتك بعناهم لبتوع الروبابيكيا لما بقوا مش موضة." ولكن هذه القطع صارت "موضة" ليس للاستعمال اليومي فحسب، بل لتزيين البيوت والأجساد لدى القادرين ماديًا والمتعلقين بالتاريخ، بينما صار الفقراء والطبقات المتوسطة يفضلون خامات مصنوعة من الألومنيوم أو البلاستيك أو معادن أرخص ومعتمدة على الآلات وليس العمل اليدوي وتأتي من الصين أو تُصنع محليًا، لأنها في الغالب أرخص على المدى القصير.
وتستظهر عزة في صفحات كتابها كيف طوّرت معرفتها العميقة بالحُليّ المصرية المعاصرة والتاريخية، وأيضًا بتنوعاتها الجغرافية، من خواتم وأقراط وأساور وسلاسل وخلاخيل، وصولًا إلى الحليّ التي تغطي الوجه أو تتدلى على الصدر. ومع الوقت، توسّعت معارفها بفضل زياراتها لصنّاع الحُليّ في مدن عربية كثيرة، ثم في أوروبا حيث زارت متاحف عديدة ودرست صناعة الحُليّ وتاريخها في لندن. كل هذه الأسفار والدراسات صنعت نقلة كبيرة في قدراتها الحرفية، ومكّنتها من نقل تصميماتها من الورق إلى المعادن النفيسة التي تعمل عليها.
وهكذا، صارت عزة أول امرأة مصرية تحصل على ترخيص من مصلحة الدمغة والموازين الحكومية المصرية للعمل كصائغة أو شخص من حقه تقديم حُليّ صنعتها والحصول على ختم من المصلحة يؤكد نسبة الذهب أو الفضة فيها.
وكانت دوائرها من المشتغلين بالفن والثقافة بابًا فتحته على اتساعه، فقدمت الحُليّ والملابس في التسعينيات في مسرحيات للفنانة اللبنانية نضال الأشقر، وفي أفلام المخرج المصري يوسف شاهين. ومرة أخرى، تقدم عزة مثالًا على الجدية الفائقة عندما اشتغلت على مسرحية "طقوس الإشارات والتحوّلات" للكاتب السوري سعد الله ونوس، إذ أمضت عامًا كاملًا في دراسة وزيارة أماكن المسرحية الأصلية في سوريا، وتفقدت أعمال الكثير من تجار وصنّاع النسيج التقليدي في أسواق دمشق، كل ذلك من أجل تصميم الحُليّ والملابس.
هذا الإصرار على الدقّة جعلها لا تبدأ في تصميم أي حُليّ مستلهمة من التصميمات والطرق المصرية القديمة (الفرعونية) إلا في عام 2012، بعد أن أمضت سنوات طويلة في الدراسة والتنقيب والتصوير بين المتاحف والمقابر والآثار المصرية القديمة، من الأقصر إلى لندن.
وتتحدث عزة عن علاقاتها القوية بكتّاب وشعراء وفنانين، منهم الرسام عبد الغني أبو العينين وزوجته رعاية النمر، والمخرجة عطيات الأبنودي وزوجها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، والكاتب الصحفي أحمد بهاء الدين، وغيرهم من الرعاة والمؤثرين في تقاطعات الثقافة والسياسة في مصر خلال الستينيات والسبعينيات، حينما كانت في بداية شق طريقها. وأسهمت شبكة العلاقات الاجتماعية في دعم مبيعاتها في مستهل حياتها العملية؛ فمثلًا، كلفها صناعة أول خمسة خواتم ثلاثة جنيهات ونصف، لكنها عرضتهم في محل بحي الزمالك القاهري كانت صاحبته زينب سليم، زوجة نجم الكرة صالح سليم، عن طريق معارف مشتركين، فحصلت مقابلهم على 45 جنيهًا.
من خان الخليلي إلى دبي ولندن
لا تقدّم عزة نفسها كسيدة أعمال، رغم نجاحها الواضح في عالم العلامات التجارية لمنتجات الرفاهية. وقد ساعدها في الانتقال من شغف فردي والعمل بالقطعة في ورشة صغيرة بجوار بيتها عدد كبير من الأصدقاء والمعارف، وفي مقدمتهم ابنتاها فاطمة وأمينة.
بدأت في ورشة صغيرة للغاية حيث كانت تقيم في حيّ حلوان جنوب القاهرة، ثم انتقلت إلى ورشة أكبر في حيّ بولاق الدكرور الشعبي شمال محافظة الجيزة، إلى أن صار لديها اليوم مصنع ضخم نسبيًا في ضاحية 6 أكتوبر غرب القاهرة، إضافة إلى معارض بيع في الأحياء والبلدات الراقية في مصر، وكذلك في دبي والرياض والدوحة ولندن. تحوّلت من صانعة حُليّ بموتيفات محلية وعربية وتقنيات مستلهمة من مدارس متعددة، إلى شركة تجارية دولية تتعامل بأساليب تسويق منتجات الرفاهية، ويعمل لديها نحو 250 موظفًا. بذلك، انتقلت من حرفية شغوفة وصاحبة مصنع صغير ومهووسة بالفضة والأحجار إلى "براند" معروف بفضل ابنتها فاطمة التي اقنعتها هي وفرق التسويق بدخول سوق الذهب، ثم سوّقوا الحُليّ خارج مصر حتى صار "الخليج يطلب عزة فهمي كماركة عربية ... وافتتح لنا محل في مول الإمارات ... إحنا خلاص بقينا في الملعب الإقليمي الكبير ... دخلت ماركة عزة فهمي ... وأصبحت على أبواب الملعب الدولي."
وهكذا، دخل فريق العمل بقيادة الابنة "في تفاصيل كل الحاجات الصغيرة اللي الشركات العالمية ماشية عليه، من توحيد شكل المحلات، اختيار موظفي الفروع وتدريبهم بشكل لائق على طريقة التعامل مع الزبائن وقواعدها، شكل الفتارين والتغليف وأهميته، طريقة تقديم القطع للزبون للعرض، كان عليهما في الآخر تقديم المانيوال اللي نمشي عليه."

مصدر الصورة: الموقع الرسمي لعزة فهمي
لا سياسة، ولا عواطف!
هناك جانبان لا تقترب منهما في سيرتها الذاتية: حياتها العاطفية الخاصة، والأوضاع السياسية في مصر أو في أي بلد زارته أو أقامت فيه. وهو تحاشٍ غريب في كتاب عن السيرة الذاتية، خصوصًا في منطقة تتداخل فيها السياسة العامة بالحياة الخاصة بقوة. فلا ذكر للحروب المتعددة التي خاضتها مصر، ولا لأنظمة الحكم فيها، ولا للتحوّلات الاقتصادية، ولا حتى للحروب التي كانت دائرة في البلدان التي زارتها. وتتجلى هذه المسافة بوضوح عندما وصفت زيارتها لسوق حلب الذي تحبّه كثيرًا وتذكره في أكثر من موضع، بعد أن دُمّر جزء كبير منه بسبب قصف قوات بشار الأسد. فهي تكتفي بالقول: "سمعت أن مؤسسة الأغا خان سوف تُرمّم هذا السوق بعد أن هدمته الحرب."
تخصّص عزة صفحات كثيرة لاستعراضات ذات طابع أنثروبولوجي حول القبائل في حلايب وشلاتين أو في واحات الصحراء الغربية، ولتفاصيل فنية عن صناعة الحُليّ في قبائل ومدارس متعددة، لكنها تكتفي بكلمة واحدة، هي "الحرب"، لتتحدث عن أكبر انهيار لدولة عربية منذ الاستقلال.
وعلى صعيد حياتها الخاصة، تتناول علاقاتها العاطفية والزوجية بسرعة نسبية، بدءًا من الجار الشاب الذي تحكّم في حياتها وهي شابة جامعية: "كان الحب عندي على التليفون ... ناخد المترو أنا وهو في نفس المواعيد على قد ما نقدر، والنظر من بعيد مع المسح على الشعر (ده علامة على إرسال السلام) .... لأ وإيه؟ الخروج كان باستئذان، لازم أستأذن من ابن الجيران لو حابة أروح أزور بيت عمي اللي جنبنا ... مرة معرفتش آخد الإذن ، وعمي كان تعبان كان لازم أروح أساعد طنط توتو مرات عمي في حاجة، هو شافني في الشارع ومخلصتش، خاصمني شهر ..."
ولا نعرف سوى في كلمات مقتضبة كيف أفلتت من سجن هذا الحب القروسطي[5] العجيب، سوى أنها تركته بعد رحلة إلى إيطاليا مع طلبة وطالبات من الجامعة. تصف تلك الرحلة قائلة بأنها كانت: "مرحلة تفتيح عقل وفهم ونظرة مختلفة ... علاقتي بالشباب اللي كانوا معانا قد إيه تغيرت وجهة نظري للعلاقة بين البنت والولد وشفتها من منظور الصداقة اللذيذة.... بعدها قررت أن أتحرر من علاقات التليفونات وأن أعيش حياة الكلية اللذيذة ببساطة، وبدأت مرحلة جديدة من حياتي." ثم ارتبطت بعد ذلك برجل تذكر لنا أنه ناشط يساري، سافر للدراسات العليا في إيطاليا، ثم خطط للسفر للقتال مع تشي جيفارا في أمريكا اللاتينية.
ثم ظهر الملحن المصري الأشهر في القرن العشرين في حياتها، التقت ببليغ حمدي، الذي يكبرها بثلاثة عشر عامًا، بعد أن طلبت منها أسرته أن تصمم الديكورات الداخلية لشقته في حيّ الزمالك. وأهم ما تتذكره من هذه الفترة موقفان: الأول، عندما هاتفتها أم كلثوم لتهنئها بالخطوبة ثم حضورها لحفلة للست بعد ذلك. والثاني، مشوار سيارة قصير عندما كان بليغ يوصلها لمقر عملها وأبلغته أن ارتباطهما لن يستمر، لأن العلاقة الشخصية بينهما لم تتطور كما يجب. ويبدو أن بليغ كان مثلها تمامًا: مولعًا ومهووسًا بعمله وحرفته وفنه، ولا مساحة عاطفية له للارتباط بشخص آخر.
وأخيرًا، تزوجت عزة شخصًا لا تتحدث عنه في الكتاب، وبعد سبع سنوات بدون أطفال قررت الإنجاب، فأنجبت بنتيها فاطمة وأمينة. وتعاملت معهما بنفس طريقتها الدؤوبة في صناعة الحُليّ: "قرأت كل ما يتعلق بتربية الأولاد من اليمين إلى اليسار: أغذية، نفسية، تطوير وتنمية الشخصية في الطفل" ثم تضيف: "استمر هذا الزواج حوالي 17 سنة، في الآخر الأمور ما مشيتش لأسباب كثيرة، لم ينجح الزواج وانفصلنا." علاقة زوجية 17 سنة أخذت أقل من فقرتين في كتاب من 400 صفحة.
وهكذا ربت أطفالها بمفردها وهي امرأة عاملة، وواجهت ذلك الشعور المستمر بالذنب: "مشكلة النساء ممن لهم حياة مماثلة لحياتي هي دائمًا ... الشعور بعقدة الذنب عندهن، وإحساس مستمر أنهن مقصرات ومش بيدوا كفاية لأولادهم."
وتستطرد: "بصحى الصبح بدري وأصحّي البنات وألبسهم وأفطرهم وأعمل لهم سندوتشات، نزول الشارع وانتظار أوتوبيس المدرسة، وبعدها البيت وطلباته، ثم الورشة بكل تفاصيل دولاب العمل ... أجري يمين وشمال من الصبح لآخر النهار ... حقيقي مش فاكرة دلوقتي آخر اليوم كنت ببقى عاملة إيه؟ والله بأمانة اللي أنا عارفاه وفاكراه إني كنت ببقى مطحونة".
وهكذا صارت حياتها محسوبة بالدقيقة، وهي تعدو بين الشركة التي تنمو وبيتها في ضواحي القاهرة، والملحق بمزرعة، وتربية وتدريس البنات. ومع هذا العدو المستمر تقول: "حسيت إن حتة جوايا نشفت ... إني فقدت الطراوة الإنسانية... أصبحت جادة" أكثر من اللازم.
ورغم أن عزة تقول إنها في إعداد هذا الكتاب كانت تتعامل " كأني قدام دكتور نفساني ... وأنزل للمخزن اللي اسمه الذاكرة واللي تفتكر أحيانًا إنه إتمحى باستيكة". لكن الحقيقة أنها لم تنزل إلى القسم العاطفي من المخزن، ولم تبصرّنا كيف تحوّلت مشاعرها مع الوقت، ولماذا صارت تشعر بالجفاف في داخلها، حيث اقتصر معظم الكتاب على نضالها المهني المهم، ومشاهداتها في الأسفار والمتاحف، ومعلومات غزيرة عن الحُليّ والحرف والتصميم والدراسة.
الحرفية بين الحُليّ واللغة
كان على عزة، وهي العارفة بأصول الحرف وأهمية التقنيات للفنان، أن تلجأ لمساعدة محرر يعاونها في هيكلة الكتاب، وترتيب سرده، ودفعها للبوح والحديث أكثر عما سكتت عنه. ولكن من الواضح أنها لم تفعل، فصارت تحكي كثيرًا مثل أبيها، كما تتذكره وتقر أن أطفالها "ساعات كتير بيزهقوا وأنا بحكيلهم".
كان يمكن للكتاب الفخم، المطبوع على صفحات سميكة نسبيًا ومصقولة، والمبذول فيه جهد فني واضح في الإخراج واختيار الخطوط والرسوم، أن يتخلص من استطرادات الأنثروبولوجيا والحشو في الوصف، أو "الحواديت" عن أسفار لا تخدم السيرة الذاتية، لو كان هناك محرر جيد.
وبالنسبة لقارئ مصري، لن تكون قراءة كتابها بالعامية المصرية مسألة صعبة أو حتى غريبة؛ فهناك سوابق مهمة، منها كتاب نادية كامل "المولودة" أو كتاب لويس عوض الفريد "مذكرات طالب بعثة".
حققت عزة فهمي الأحلام التي قادتها بحزم طوال حياتها لتصبح امرأة مستقلة ومهنية وفنانة وحرفية وناجحة. وربما لهذا تجاهلت في كتابها عالم السياسة والاجتماع الخارجي، وعالم النفس والعاطفة الداخلي، هذه العوالم التي تبدلت وتحوّلت عدة مرات على مدى أعوامها الثمانين. ويبدو في الظاهر أن معظم أحلام عزة تحققت، رغم عنوان الكتاب، ولكن أحلام العوالم التي عاشتها تحطمت وتكسرت على صخور عديدة لم تتحدث عنها عزة كثيرًا.