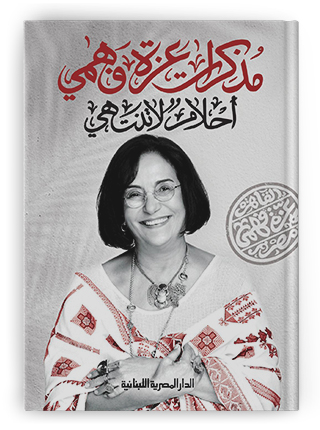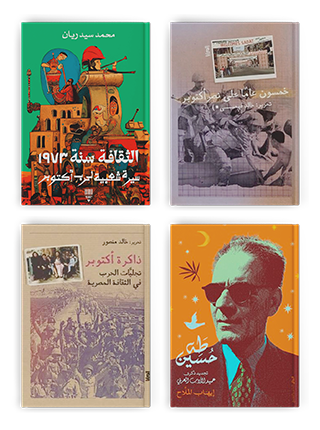يقدّم حسام أحمد في كتابه "النهضوي الأخير: طه حسين وبناء المؤسسات في مصر" قراءة جديدة في سيرة طه حسين، تتجاوز الصورة النمطية التي استقرّت عنه، عبر ما يسميه المؤلف "السيرة الاجتماعية". يتتبع الكتاب فكره وعلاقته بتطور التعليم والجامعة المصرية ومجانية التعليم، ومعاركه الثقافية والسياسية في الداخل والخارج، كاشفًا عن ملامح "النهضوي" الذي سعى لبناء دولة حديثة قائمة على المعرفة والعدالة رغم البيروقراطية والاستبداد.
أحمد عبدالحليم[1]
يستنقذ حسام أحمد في كتابه "النهضوي الأخير: طه حسين وبناء المؤسسات في مصر"[2] سيرة طه حسين التي مزّقتها التناولات الأيديولوجية، ويحرّرها من القوالب التي صُبّت فيها على مدار عقود من الزمن، حين كان "العميد"، وهو جدير بذلك، مالئ الدنيا وشاغل الناس. في هذه السيرة التي ترجمها مشروع "كلمة"، وجاءت في خمسة فصول إلى جانب المقدمة والخاتمة، لا نقف أمامه كما عهدناه إما "مثقفًا فرانكفونيًا" أو "برجوازيًّا لِبراليًّا"، أو في صورته "الكليشيهية" الأكثر ترديدًا كـ "عدوٍّ للإسلام". وكذلك لا يتوقف هذا الكتاب عند نتاجه الثقافي والأدبي بالضرورة، بل يتتبع مسيرته في سلك الوظيفة العامة، حيث التقت المثالية الثقافية التي جسّدها بالقرار السياسي، المتعثّر في كثير من الأوقات.
بالاعتماد على الأرشيف العائلي الذي أمدّته به العائلة، يحاول الكاتب التعرّف أكثر على طه حسين بوصفه رجلَ مجتمع، من خلال الاطّلاع على مجموعة من الأوراق الخاصة وألبوم صور لم يُتح للباحثين من قبل. ولا يحاول حسام أحمد في كتابه القبض على تلك السيرة في ترتيب كرونولوجي، ولا حتى بوصفها سيرة ذاتية يصبح فيها تاريخ الميلاد والممات محطات مهمة، بل يركّز على اللحظة التاريخية التي تتجاوز تناول شخصيته ومسيرته السياسية المثيرة للجدل، لتقدّم قراءة أوسع للمؤسسات الثقافية والتعليمية في مصر بين عشرينيات وخمسينيات القرن العشرين، تلك العقود الثلاثة الحافلة بالتحوّلات الكبرى والعواصف.
شهدت مصر الاستقلال السياسي عام 1922، وارتفع معها شأن الصحافة والرواية والصالونات الأدبية التي شكّلت ملتقى لتبادل الأفكار والنقاش حول مواضيع مثل العلمانية وفكرة القومية والإصلاح الاجتماعي والتعليم والدين ومكانة المرأة في المجتمع والسياسة. وقد أدّت الجامعة المصرية الوليدة دورًا محوريًا في رفد المجتمع بشخصيات مؤثرة، من بينهم صاحب "الأيام"، المثقف الفرانكفوني الذي عاش تلك الحقبة وكان أحيانًا صانعًا لها. كل تلك الأحداث شكّلت ملامح العقود الثلاثة، ومن هنا اعتمد حسام أحمد منهجية تتناول سيرة طه حسين من منظور السيرة الاجتماعية لا من منظور السيرة الذاتية التقليدية.
في معنى السيرة الاجتماعية وأهميتها
يذكر الكاتب في مقدّمة كتابه، مستشهدًا بمُحاجَّة ظهرت مؤخرًا في الحقل الأكاديمي، أنّ مفهوم "السيرة الاجتماعية" يُقدَّم بوصفه محاولة لمعالجة إشكاليات المنهج التقليدي في تناول السيرة الذاتية. فما المقصود إذن بـ "السيرة الاجتماعية"، ولماذا تبرز الحاجة إليها؟
تكمن المخاوف في تناول سيرة ذاتية بالأسلوب التقليدي في أن المؤرخين اعتادوا النظر إليها بوصفها صورةً مصغّرة للتاريخ، يُقسَّم فيها الزمن إلى مراحل محدّدة سلفًا بحياة الشخص موضوع السيرة، من المهد إلى اللحد. أمّا الخشية الثانية، فهي أن التركيز المفرط على فاعلية الفرد قد يحجب السياق التاريخي الأوسع وتُطمس القوى المؤثّرة الأخرى. في المقابل، لا تتخذ السيرة الاجتماعية الجيدة من الفرد وحده موضوعًا لها، ولكنها تضعه في سياقه التاريخي. ويقتبس الكاتب عن المؤرخ نِك سالفتور قوله: "كيف يتفاعل فرد مع ثقافة ما ومجتمع ليس من صنعه، بل من جملة موروثاته عمومًا، وبأي الطرائق يتفاعل معهما، وإلى أي مدى ينجح، ويخلف حياة منهما، وربما يغيّرهما؟"[3]
إنّ هذا المنهج يُجنّب المؤرّخ التماهي مع الشخصية موضوع السيرة، وإسباغ هالة رومانسية عليها وعلى تجربتها، أو كيل الثناء للسبل التي نهض بها الفرد فوق التحديات المجتمعية المختلفة. وبدلًا من ذلك، يركّز المنهج على استجابة الفرد للخيارات المتاحة له وللتحوّلات الجارية من حوله، وهكذا يمكننا أن نكتسب فهمًا أعمق للمؤسسات ولأنماط التغيير الاجتماعي، من خلال تحليل الكيفية التي فهم بها الأفراد تلك المؤسسات وتفاعلوا معها.
معارك "الفرانكفوني" الثقافية مع فرنسا
كان طه حسين واعيًا بالدور العروبي لمصر، بينما كان جمال عبد الناصر ما يزال يخطو خطواته الأولى في الكلية العسكرية. ففي مقالٍ نشره عام 1938 في مجلة الرسالة بعنوان "مصر والعروبة"، رثى الدور الذي تقاعست مصر عن أدائه، متمنّيًا لو أنها تنهض بتصدير ثقافتها ومدارسها إلى الأقطار العربية المجاورة، فهذا – في نظره – قدرها إن قُدّر لتلك المنطقة نهضة وقيام.[4] وبعد اثنيّ عشر عامًا على نشره ذلك المقال، تبوّأ طه حسين منصب وزير المعارف في حكومة الوفد الأخيرة قبل ثورة يوليو (1950–1952)، فاستغل موقعه لإنفاذ مشروعه الثقافي الطموح. يتناول الفصل الأول من الكتاب هذا المشروع بتفصيل، موضحًا الأدوار التي اضطلع بها في توسيع النفوذ الثقافي المصري في شمال أفريقيا، وكيف واجهت فرنسا تلك المساعي بمحاولات مضادّة للحفاظ على نفوذها.
في الفترة التي أعقبت معاهدة عام 1936 وإلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937، تمتعت مصر بهامشٍ واسعٍ من استقلال سياستها الخارجية، وأضحت أكثر ثقةً في تنامي دورها المتجه غربًا، خلافًا للاتجاه المشرقي التقليدي. وكان لا بد لتلك الطموحات أن تصطدم بالعلاقة الدافئة التي ربطت مصر بفرنسا، في مواجهة النفوذ البريطاني. رأى طه حسين أن "رسالة مصر" رسالةٌ ذات طابعٍ ثقافي في المقام الأول، وأن نهضتها الحديثة أهلتها لاستئناف ما اعتقد أنه دورها التاريخي عربيًا وإسلاميًا.[5]
أسّس طه حسين معاهد لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية في مدريد وأثينا ونيس، ولم تتوقف رحلاته المكوكية عند ضفاف البحر المتوسط؛ ففي طنجة والرباط وتونس والجزائر، سعى إلى افتتاح مدارس ومعاهد مصرية، لكنه اصطدم هناك بفرنسا. وهنا تصرف كرجل دولة، لا كمثقفٍ فرانكفونيٍّ طالما عُدّ مقربًا من فرنسا، فأمر بتعليق الحفريات الأثرية الفرنسية في مصر، وتعهّد باتخاذ إجراءات صارمة بحقّ المؤسسات الثقافية الفرنسية العاملة فيها.
ورغم ذلك، يُورد الكاتب في هذا الفصل آراء الباحث الأدبي أبي القاسم محمد كرو، الذي يرى أن أدوار طه حسين في شمال أفريقيا لا تنبع بالضرورة من موقفٍ مناهضٍ للاستعمار الفرنسي. فكما لاحظ كرو، لم يهاجم الاستعمارَ الفرنسيَّ أو يشجبه إلا في عهد جمال عبد الناصر، متّخذًا موقف مصر الرسميّ آنذاك. ويُقرّ كرو بفضله في مقارعة الاستعمار البريطاني في مصر، غير أنّه لا يُعرف له أيّ موقفٍ صريحٍ ضدّ الاستعمار الفرنسي قبل العهد الناصري.[6]
ومن خلال هذا الاستشهاد، يشير الكاتب إلى أنّ وجود طه حسين في شمال أفريقيا كان مقرونًا باتهامٍ فحواه "فصل الثقافي عن السياسي"، إذ كان العميد يؤكد دائمًا أنّ الثقافة عالمية ولا ينبغي أن تكون ذات دوافع سياسية. غير أنّ الكاتب يخالف هذا الرأي في ختام الفصل، معتبرًا أنّ جهود العميد وإصراره على تأسيس المعهد المصري في الجزائر، وخوضه غمار تلك المعركة البيروقراطية الطويلة مع الفرنسيين، لم تكن سعيًا إلى "ثقافة من أجل الثقافة"، بل كانت في جوهرها سعيًّا سياسيًّا لدعم حركات مناهضة الاستعمار في تلك الأقطار العربية.
على الرغم مما يحفل به الفصل من وثائق أرشيفية تبحث في ما يشبه الحرب الثقافية الباردة بين مصر وفرنسا في شمال أفريقيا منذ منتصف الأربعينيات حتى عام 1952، وعرضٍ لصورة طه حسين في نظر الفرنسيين الذين باتوا مرتابين في فرانكفونيّته وغير مرتاحين للعمل معه، إلا أنّه يقدّم القليل مقارنة باتساع عنوان الفصل الذي يتحدث عن دور القوة الناعمة المصرية في شمال أفريقيا. إذ تُكرَّس معظم الصفحات لكواليس افتتاح "معهد فاروق الأول للدراسات الإسلامية" في إسبانيا، ولحكاياتٍ عن إرهاصات التفكير في التوجّه غربًا داخل السياسة الخارجية المصرية ونخبتها الثقافية. وبسبب هيمنة هذه المحاور، تبرز مشكلةٌ واضحة تتمثل في غياب الإجابة عن سؤالٍ جوهري: إلى أيّ مدى لاقت جهوده في المغرب العربي قبولًا وصدى جماهيريًا، أم أنّها لم تتجاوز كونها معركةً نخبويةً ذات حدودٍ بيروقراطية؟
"ثالوث النهضة" في مواجهة البيروقراطية والميزانية
تُمكننا مواضيع الفصول الثاني والثالث والرابع من إعادة تشكيلها في مثلث واحد متكامل؛ فهو يمثل ثالوث النهضوي الذي اعتمد عليه في نظرته الاجتماعية البناءة، ويتجلى في مفاهيمه عن الجامعة المصرية، ونضاله من أجل التعليم ومجانيّته، ومحاولته كسر احتكار مؤسسة الأزهر للغة العربية من خلال تحديثها وعصرنتها.
لم يكن طه حسين من مؤسّسي الجامعة المصرية، ولم ينضمّ إليها طالبًا أو أستاذًا عند تأسيسها، غير أنّ المحطة الأهم في تاريخها جاءت حين أصبح جزءًا منها في عشرينيات القرن الماضي؛ إذ جسّد، من موقعه كعميد لكلية الآداب، النموذج الأول لعالِم الإنسانيات العربي.[7]
آمن طه حسين بالدور السيادي الذي يُمكن للجامعة أن تؤديه في الحفاظ على الاستقلال الثقافي لمصر وحمايتها من التبعية لأوروبا. فقد كانت الجامعة بالفعل بوتقة ضمّت رموز النضال الوطني لثورة 1919، كما آمن بدورها في إنتاج معرفة "علمانية" مستقلة، والكف عن الاعتماد على استيراد الأفكار الغربية. وكغيره من مجايليه من المثقفين في أنحاء العالم، رأى أنها المكان الوحيد القادر على إنتاج نخب تدير الدولة بشكل كفء وعلمي وتقدمي، وأصر على أن كل ذلك لا يمكن أن يتحقيق إلا في إطار استقلالية البحث العلمي وتحييد السيطرة الحكومية المباشرة عليها، أي أنه حاول تنظيم دور الدولة لا إلغاؤه. ومع ذلك، لم تتحقق تلك المنظومة الفكرية المتكاملة، إذ ظلت الجامعة رهينة للتحكمات المباشرة من القصر، فطُرد طه حسين من عمادة كلية الآداب عام 1932، وظلت أيضًا ضحية الموازنات السياسية والمالية.
في مسألة التعليم المجاني، يساعدنا الكتاب على فهم مقاربته لمعنى الديمقراطية، التي ظلت عنده رهينة بحق الجميع في التعليم المجاني، وكونه الشرط الأساسي للنهوض والحرية. من خلال التعليم، يفهم المصريون حقوقهم ومسؤولياتهم، ولذلك كانت معركة الاستقلال الكامل في نظره جوهرها ثقافي وسياسي. ورأى أن تحقيق ذلك لا يمكن إلا في ظل برلمان حر ومراقب وديمقراطي. بلغ تفاؤله ذروته بين عاميّ 1942 و1944 في ظل حكومة الوفد، رغم الأحداث الساخنة التي ميّزت تلك الفترة، فاختار أن يخوض معركة التعليم المجاني بعزم وتصميم، ووصل إلى أوج التفاؤل حين تولى وزارة المعارف بين عاميّ 1950 و1952.
وقد بلغ فخره ذروته في بداية عام 1950-1951 حين أبلغ مجلس الوزراء أنه لم يرفض أي متقدم من المدارس الثانوية أو الفنية، بعد أن افتتح رئاسته للوزارة بتصريح شديد اللهجة بأن أي مدير مدرسة يرسل طالبًا إلى المنزل لعدم دفع الرسوم سيتعرض للفصل الفوري لرفضه الامتثال لتعليمات الوزارة، لأن المجانية كانت التزامًا حكوميًا وواجبًا على الجميع التنفيذ.[8] وكان من المناسب دعم هذه الفقرة بعرض رقمي وإحصائي يوضح مدى فعالية مشروع التعليم المجاني، إلا أن الكاتب اكتفى بالاستشهاد بتصريحات نُشرت في الصحف، حيث شكر الإعلام على مساعدته في الترويج للتعليم المجاني وترغيب العديد من الأسر فيه، وقيّم التجربة بأنها "نجاح حسن، وإن لم يكن باهرًا".[9]
كانت اللغة العربية امتدادًا لمشروعه التعليمي، ومن أجلها خاض معارك أخرى، سواء في الجلسات الخاصة أو الندوات العامة. فقد تصدى بشدة لفكرة عبد العزيز فهمي حول إحلال الأبجدية اللاتينية بدلًا من العربية كلغة للتعليم، مؤكدًا أن الأمة من خلال لغتها وحدها تستطيع فهم تراثها واستيعابه، لذا كان من الضروري الحفاظ على هذه اللغة لا دفنها.[10]
في هذه الفصول بالتحديد، نتأمل عن قرب وعيه وتصوره للدولة والدور الذي ينبغي أن تضطلع به، حيث رأى أن "الدولة هي المسؤولة عن عدم حمايتها للغة العربية حماية كافية، وعدم تدريسها تدريسًا صحيحًا، كانت الدولة أيضًا مسؤولة عن تجاهلها بناء مدارس لفترة طويلة، ما دفع الآباء لإرسال أبنائهم مدارس أجنبية"[11]. وفهم هذا التصور يساعد على تفسير وقوفه فيما بعد إلى جانب جمال عبد الناصر وحرصه على الدفاع عنه حتى بعد نكسة 1967 ووفاته، رغم الاستبداد والتسلط الذي ساد عصره.
سنفهم أيضًا مكامن الضعف في مشروعه النهضوي في العصر الليبرالي، إذ لم تكن الميزانيات المخصصة لمشاريع التعليم ومجمع اللغة العربية والجامعة المصرية أبدًا على قدر همة الرجل وطموحاته. كما أدت البيروقراطية دورها المعهود في عرقلة المشروعات، ففي عام 1955 عبّر عن خيّبة أمله عندما قدم المجمع توصية لتيسير قواعد النحو للطلاب عام 1944 إلى وزارة المعارف، إلا أن تلك التوصيات ما بقيت "نائمة" في أدراج الوزارة.[12] رغم هذه الإحباطات، لم ينثنِ عزمه إطلاقًا، والمُستخلص الأهم من سيرته في هذا الكتاب، في هذه الفصول الثلاثة بالتحديد، هو قوته في التصميم على التبشير بثقافة علمانية مجانية ذات طابع ديمقراطي.
"النهضوي في متاهته": كيف وازن علاقته بالاستبداد
يشرح الفصل الخامس والأخير علاقة طه حسين بالسلطة في مصر منذ عام 1952. فقد مثلت حقبة جمال عبد الناصر (1954-1970) الكثير من الأفكار التي نادى بها "النهضوي"، مثل الاستقلال، ومجانية التعليم، والقومية العربية. وبرغم الاتفاق على هذه الخطوط العريضة، يُوضح الفصل أن العلاقة بينه وبين نظام يوليو 1952 لم تكن "سمنًا على عسل"، إذ اندلع الخلاف في الكثير من الأوقات، وفي بعضها كان مخدوعًا في إدراك الأمور بشكل صحيح.
يمثل طه حسين نموذجًا للعلاقة المركبة التي نشأت بين مثقفي الجيل الليبرالي، الذين تربوا سياسيًا في ظلال ثورة 1919 ومآلاتها، انتصاراتها وإحباطاتها، حتى وصلت الأحداث ذروتها في تموز/ يوليو 1952. وكانت لديّه الكثير من الآمال في العهد الجديد، وعبّر عنها عند استقباله خبر استيلاء الجيش على مقاليد الحكم أثناء تواجده في إيطاليا، حيث أُغمي عليه من الفرح. وفي صباح اليوم التالي، كتب إلى جريدة الأهرام أنه من خلال هذا "الانقلاب" وجدت مصر نفسها. وسيكون أول من يُسمي هذا الحدث، الذي تنوعت أسماؤه في الأيام الأولى بين حركة مباركة أو انقلاب، باسم "ثورة"، في مقالة مبكرة احتفى فيها برقيّ الحركة التي أرسلت الملك إلى منفاه دون إراقة نقطة دم واحدة.[13]
لذلك كان حماسه للمشروع الناصري كبيرًا، لا سيما في الأيام الأولى التي شهدت كسر احتكار السلاح، والصراع من أجل إجلاء الإنجليز وتأميم قناة السويس. دفعته هذه الحماسة إلى الصمت حيال عدد من القضايا، منها حل الأحزاب السياسية، وتجاهل الضباط للدستور الذي أعده هو ومجموعة من المثقفين لمدة عام ونصف لصالح دستور 1956. كما لم يُدِن الوحدة مع سوريا عام 1958 علنًا، رغم أنه أسرّ لأحد الوزراء بأن تلك الوحدة كانت سابقة لأوانها، ولم يُعلق على تأميم الدولة للصحافة والقوانين الاشتراكية، ولم يشارك في الرد على الهجوم الذي شنّه عام 1961 محمد حسنين هيكل، صوت النظام على المثقفين، حين اتهمهم بالتقصير في أداء أدوارهم.
في أحيان أخرى، دفعته هذه الحماسة إلى خوض معارك دفاعية، مثل مواجهته مع درية شفيق عام 1954 وإضرابها احتجاجًا على إقصاء المرأة من اللجنة المشكلة حديثًا لصياغة الدستور الجديد. ردًا على ذلك الموقف، هاجمها في مقالة بجريدة الجمهورية تحت عنوان "عابثات"، مبررًا موقفه بأن هذا الوقت الحساس من تاريخ البلاد لا يحتمل مثل هذه المواقف التي قد يستغلها البريطانيون.[14]
التفافه حول القضايا التي طرحها الزعيم الجديد لمصر، جمال عبد الناصر، ووقوفه ضد الغرب والإمبريالية، أسهم في تغيير فكرة طالما آمن بها ودأب على ترديدها في مقالاته، وهي "الحضارة الإنسانية المشتركة" التي يجب على جميع الدول أن تُسهم فيها من خلال الثقافة والتعليم. وفي ظل ما رآه من عداء الغرب المتواصل تجاه مشاريع التحرر العربية وضد بلاده، وانقسام العالم بين شرق وغرب، اختار طه حسين المشروع الوطني على الوعيّ الكوزموبوليتاني.
من ناحية أخرى، يُظهر الكتاب كيف كان تقديره للدور الذي سيؤديه في بناء المجتمع الجديد وجيله من المثقفين أكبر بكثير من الدور الذي رسمته لهم دولة يوليو. فقد اعتبر أنّه وجيله مهّدوا الطريق لثورة 1952، إذ عكف الشعب على قراءة العديد من مقالاتهم عن العدالة الاجتماعية والحرية السياسية وغيرها من القضايا التي ألقوا فيها كلمتهم بحرية، ورأى كثيرون آنذاك أن استمرار هؤلاء الكتّاب في قول ما يؤمنون به يشكّل نوعًا من المشورة الصادقة والدعم المعنوي للنظام الجديد. في المقابل، لم يرَ الضباط الأحرار الأمور على نفس الشاكلة، وانبرى عبد الناصر للهجوم على مثقفي عهد ثورة 1919 في "ميثاقه الوطني"، مؤكدًا أن تلك الثورة ونخبتها لم تحقق شيئًا يُذكر للبلاد والعباد. في هذا السياق، لم يكن الرجل مثقفًا وابنًا لهذا الجيل فقط، بل كان وزيرًا للتعليم في بعض الفترات ضمن حكومة الوفد قبل ثورة يوليو، واعتبر الهجوم إجحافًا في حق نضاله من أجل التعليم ونشر الثقافة، وطالب بالإنصاف لجهود جيله.
كان هذا أول خروج علني بالنقد الموجّه إلى جمال عبد الناصر من قبله، وقد عوقب عليه بإبعاده عن جريدة الجمهورية بعد عاميّن (أي في عام 1964)، وتعرض لما يمكن وصفه بقمع ناعم متمثل في تهمشيه. أحد الأمثلة على ذلك زيارة الأديب الفرنسي جان بول سارتر إلى مصر؛ فعلى الرغم من أنه قدّم سارتر وأدبه عربيًا للمرة الأولى، لم يعلم بزيارته ولا بندوته في جامعة القاهرة عام 1967 إلا من خلال الجرائد، إذ لم يُدع إليها من الأساس. ومع ذلك، ظل محافظًا على تقديره لجمال عبد الناصر ومشروعه الذي ناصر الفقراء، وقطع شوطًا كبيرًا في توسيع فرص التعليم أمام المصريين.
بعد خمسين عامًا.. لماذا يظل طه حسين حاضرًا؟
صدرت ترجمة هذا الكتاب عام 2023، أي بعد مرور خمسين عامًا على رحيله، الذي غيّبه الموت في خضم صخب حرب أكتوبر 1973. خمسون عامًا لم تكن كافية لتخطي مشروع "النهضوي"، بل لجعله أكثر إلحاحًا، وهذا ما تمثّل في كتاب "النهضوي الأخير"، على الرغم مما يعتريه من بعض الملاحظات والمشكلات.
ورغم أن نضاله ومعاركه كانت تسعى إلى توظيف الثقافة، على ما فيها من نخبويّة، في خدمة الشعب، والسعي إلى دمقرطة التعليم ومجانيّته، وأن التزامه الأساسي انطلق من إيمان عميق بصالح المجتمع عمومًا، فإن طرح حسام أحمد في هذه السيرة يكاد يخفت فيه صوت الشعب تمامًا، إذ يغيب رصد التفاعل الشعبي مع مشاريعه وتلقّيها، إلى درجة توحي بأن تلك المعارك كانت حكرًا على النخبة فقط، بينما الواقع أنها كانت بعيدة عن ذلك.
من جانب آخر، فإن الفائدة التي يأتي بها الكاتب في طرحه كبيرة إلى حدٍّ تكاد تطغى على بعض المشكلات والنواقص؛ فمن ناحية السيرة، جاء بشيء مهم وجديد ظل غائبًا عن معظم الدراسات السابقة، هو إبراز شخصية طه حسين بوصفه صاحب قرار سياسي، لا مجرد مفكر ومثقف عام. ومن ناحية الراهنية، ما زال هذا الكتاب بقضاياه موضوعًا على طاولة النقاش، خصوصًا في ظل التراجع المتزايد لمجانية التعليم، وتخلّي الدولة تدريجيًا عن دورها في نشر الثقافة ورعايتها، وتحوّل المشهد الثقافي والعلمي بأكمله إلى مبدأ السلعية، وغياب مفهوم الاشتباك عن مثقفي العصر الحالي، وانهيار مفهوم المؤسّسات والساسة الفاعلين تحت وطأة حكم الفرد واستبداده. لذلك، يظل "النهضوي الأخير" كتابًا نابضًا بالعديد من الأسئلة، بل والإجابات، التي تعيننا على فهم واقعنا المعيش ومحاولة التأثير فيه.