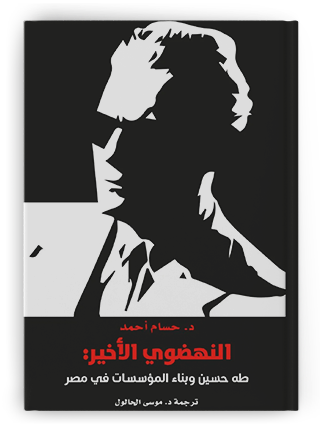يُحتفى في يوم 9 آذار/ مارس من كل عام بذكرى يوم الشهيد، دون أن يدرك كثيرون من المصريين أن هذا اليوم مرتبط بذكرى استشهاد عبد المنعم رياض في عام 1969، أثناء ملحمة حرب الاستنزاف التي كانت عنوانًا لجسارة الحرب في خضم الهزيمة. يُصادف في ذات اليوم احتفاء الجامعيين بذكرى استقلال الجامعة، في غيابٍ لمعرفة الكثير من طلاب وطالبات جامعة القاهرة أن هذا اليوم مرتبط بانتفاضة أساتذة وطلاب كليتي الآداب والحقوق في الجامعة المصرية (القاهرة لاحقًا) تضامنًا مع طه حسين على خلفية إزاحته عام 1932 من موقعه كعميد منتخب لكلية الآداب، وذلك تنكيلاً به على مجاسرته الفكرية. تعرض دينا عزت بعض الكتب الجديدة التي تسلط الضوء على الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر ولرحيل طه حسين، والتي صدر بعضها عن معرض القاهرة الدولي للكتاب.
دينا عزت[1]
"في يوم 8 مارس 1969، قامت المدفعية المصرية بقصف عميق ومركّز على المواقع الإسرائيلية شرق قناة السويس، استمر لمدة خمس ساعات بغرض تدمير دشم خط بارليف. ردت إسرائيل على هذا القصف بقصفٍ مضاد يوم 9 مارس، في الوقت الذي تصادف فيه زيارة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية عبد المنعم رياض فأصيب إصابة مباشرة. تحولت الجنازة سريعًا إلى مظاهرة شعبية تطالب بالثأر. وبالفعل، لم تتوقف المدفعية المصرية عن دك المواقع الحصينة لخط بارليف".
حرب أكتوبر: إعادة رواية التاريخ
يُلخص المؤرخ المصري خالد فهمي في هذه السطور منطق ومشاعر الشعب المصري في واحدة من أهم السنوات الفاصلة بين هزيمة يونيو 1967 وعبور أكتوبر 1973، والتي احتُفي بذكراها الخمسين في عام 2023. يخصص فهمي الفصل الثاني من كتاب "خمسون عامًا على نصر أكتوبر"، الصادر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير من العام الجاري عن دار المرايا، لمروية "حرب الاستنزاف"، في واحدةٍ من أهم مرويات الصراع العربي الإسرائيلي التي لم تحظَ بالمكانة الملائمة. يمثل طرح المرويات غير المطروقة عنوانًا مهمًا من عناوين أحدث كتب دار المرايا عن ذكرى أكتوبر، والتي حرر الجزء الأول منه خالد فهمي، بينما قام خالد منصور بتحرير الجزء الذي صدر بعنوان "ذاكرة أكتوبر: تجليّات الحرب في الثقافة المصرية".
تقدم القراءة المباشرة للنصوص المشمولة في الكتابين، اللذين شارك في كتابتهما أكثر من 20 من الكتّاب والكاتبات، قصة متكاملة الشخوص والأحداث التي لا تقتصر على حرب أكتوبر ذاتها، بل تتجاوز في مضمونها العميق قصة لا تقل أهمية، وهي ما أطلق عليه أول فصول السير الصعب والممتد من الهزيمة إلى النصر. إنها كما يذكر فهمي في مروية الاستنزاف، قصة العزيمة ورفض الاستسلام من قبل الشعب والجيش، ونظام سياسي أدرك على الأقل بعض خطاياه الكبرى وسعى لتصحيحها من خلال حرب أكتوبر. يقر فهمي أن عبور أكتوبر، وإن لم يؤدّ إلى تحرير الأرض المصرية المحتلة من قبل إسرائيل في يونيو 1967 بالقوة العسكرية، إلا أنه بالتأكيد مثّل "إنجازًا عسكريًا.. تمكن المصريون "من خلاله" من عبور القناة والاستيلاء على خط بارليف... محطمين إيمان الإسرائيليين بأن جيشهم لا يقهر... بعد أن برهن المصريون... في هذه الحرب قدرتهم على القتال بنفس كفاءة الإسرائيليين".
استخدم وعرض فهمي شهادات ولقاءات صحفية تجسد رحلة المصريين من الهزيمة إلى العبور، في ظل استمرار تغييب الوثائق الرسمية للحرب رغم مرور أكثر من خمسة عقود على تلك الأحداث. ويقدم بذلك مروية سياسية وعسكرية، ولكنها في جوهرها تُسلط الضوء على العقيدة الفكرية الحاكمة للمصريين عمومًا في ذلك الوقت. ويؤكد فهمي في حديثه عن سنوات الاستنزاف أن هزيمة يونيو دفعت البعض إلى التوجه بشكل مكثف للشعائر الدينية، بعد أن فسرت الهزيمة كعقاب إلهي سببه الابتعاد عن الدين. بينما استدعت أصواتًا أخرى الحديث عن تبعات غياب الديمقراطية وتفرد الحكم بالرأي. لكنه يُشير بنفس التأكيد والوضوح إلى أن الإيمان الاستثنائي بقيمة العمل دون تردد، مهما كانت التضحيات، هو ما مكّن مصر من الوصول إلى يوم السادس من أكتوبر، وعبور القناة، وتحطيم خط بارليف.
بحسب فهمي، كان الإصرار على التضحية حاسمًا في رأي عبد المنعم رياض، إذ ذكر أنه كان يرفض التسوية السلمية، حتى مع انفتاح جمال عبد الناصر عليها في وقت مبكر. بل أراد رياض حربًا تعيد ثقة الجيش بنفسه وتستعيد ثقة الشعب. وينقل فهمي عن ناصر قوله إن الجنود الذين ماتوا في حرب يونيو "ماتوا بشرف ولم يهربوا من الموت"، وهي ذات الفكرة التي تؤكدها كلٌّ من نيرة عبد الرحمن وعلا السيد في الفصلين السادس والسابع من الكتاب في روايتهما عن تعامل أهالي السويس وبدو سيناء مع واقع الهزيمة، وصولاً إلى يوم العبور وما تلاه.
لم تقتصر التضحيات على العسكريين فقط، بل قدمها أيضًا مجندون وفنيون ومهندسون بلا تردد وبجسارة منقطعة النظير. ينقل فهمي عن أحد المشاركين في بناء حائط الصواريخ قوله: "إن آلاف الأطنان من الرمال التي حملتها أكتاف الشباب المجند تنطق بعدد حبات الرمل بكل آيات الشكر والتمجيد لجهودهم الخارقة وسط قيظ الصيف اللافح على رمال الصحراء الشرقية، ووسط ظروف عمل شاقة تمتد ساعاتها للطاقم الواحد إلى أكثر من 12 ساعة عمل يوميًا، ووسط أحوال معيشية جد صعبة من حيث قوتهم الهزيل ومياههم القليلة". ويؤكد فهمي أن نجاح المصريين في بناء منظومة دفاع صاروخية متكاملة جاء بتكاليف باهظة في الأرواح، ضمن ملحمة من التضحيات والعزيمة جعلت من حرب الاستنزاف "إنجازًا عبقريًا بكل المقاييس".
في الوقت نفسه، تذكر مروية الاستنزاف التي يقدمها فهمي مساحة أخرى من الإصرار لدى المصريين، وهي الإصرار على كسر حاجز الصمت والخوف من انتقاد النظام الناصري الذي أبدى وحشية لا تغفل تجاه معارضيه. يشير هنا إلى مظاهرات العمال والطلبة في فبراير 1968 ضد الأحكام القضائية المخففة الصادرة بحق قادة الطيران، الذين حملهم ناصر بالأساس مسؤولية الهزيمة. وتحت ضغط واتساع رقعة التظاهرات اضطر ناصر إلى إعادة المحاكمات لتأتي العقوبات مُغلظة. ويرى فهمي أن تظاهرات رفض تنحي عبد الناصر عن منصبه لم تكن مجرد دعم شعبي لزعيم سياسي في أسوأ ظرف، ولكن أيضا كتذكرة بضرورة تحمله المسؤولية ومطالبته بالقيام بما ينبغي لتجاوز الهزيمة والتعافي من آثارها.

السيرة والثقافة الشعبية لحرب أكتوبر
جاءت العناوين الرئيسية للمسلك المصري في إبداء العزيمة والتمسك بالعمل واضحة بجلاء في الكتاب الصادر عام 2023 عن دار المحرر، للاحتفاء بذكرى مرور خمسين عامًا على حرب أكتوبر، تحت عنوان "الثقافة سنة 1973: سيرة شعبية لحرب أكتوبر"، دون ربطه حتمًا بالسياق الديني أو إغفال لأهمية وازع الإيمان. يرصد المؤلف محمد سيد ريان، معتقدات وأفكار المصريين بقطاعاتهم الواسعة قبل وأثناء الحرب من خلال أرشيف مجلات وصحف تلك الفترة. فينقل على سبيل المثال عن محمود خليفة، العامل في أحد مصانع النسيج، حديثه عن التفاني في العمل بغية زيادة الإنتاج لتقوية موقف الدولة، ما ساهم في زيادة القدرة على مواجهة العدو. كما ينقل عنه أيضًا اعتزاز العمال وتفانيهم في العمل ومشاركتهم في المجهود الحربي مع اعتبار أن ما يقدمونه من تبرعات مالية، "حاجة بسيطة" مقارنة بما يقدمه المجندون والضباط.
لم يكن الالتزام بالعمل هو السبب الوحيد المؤدي للانتصار في حرب أكتوبر، بحسب الكتاب، سواء في رأي قادة الجيش أو في رأي الشعب. فبينما ينقل ريان عن فهيمة محمد، العاملة في شركة مصر الجديدة، قولها إن "الجندي المصري انتصر بفضل تدريبه". كما ينقل فهمي عن ناصر قوله في عدد من الاجتماعات والأحاديث أن الرئيس المصري أدرك بعد الهزيمة أنه في حاجة ليس فقط لإعادة بناء الجيش، ولكن أيضًا لرفع مستوى التدريب، لأن من أكبر الثغرات العسكرية في رأيه كان ضعف تدريب الجنود والضباط المصريين، خاصة في سلاح الطيران مقارنة بنظرائهم الإسرائيليين.
لقد كانت الواقعية عنوانًا واضحًا في سنوات السعي للعبور. ومن ذلك ما ينقله فهمي عن زيارة سرية قام بها ناصر للاتحاد السوفيتي عند احتدام حرب الاستنزاف ليطالب السوفييت برفع مستوى إمداد السلاح للجيش المصري وبإرسال عسكريين روس لتقديم الدعم والتدريب العسكري. كان الإدراك لما قدمه الاتحاد السوفيتي من دعم للجيش المصري يبدو جليًا في أحاديث المصريين. يشير ريان إلى شهادات عطية عبد المنعم عامل البوفيه، ومحفوظ محمد عامل البناء، بخصوص دور السلاح السوفيتي في تحقيق "نصر أكتوبر". إذ يعبر محمد عن رأيه في مسببات النصر بقوله إنها "السلاح الروسي والبترول العربي والعناية الإلهية". وينقل ريان شهادة الفلاح محمد السيد، الذي كان يرى أسباب العبور في زيادة الإنتاج، التبرع بالدم، والإيمان بأن الحق المنهوب لا يعود إلا بالحرب، بقوله "كان معانا ربنا ومعانا روسيا".
يشير خالد منصور في مقدمة كتاب "ذاكرة أكتوبر: تجليّات الحرب في الثقافة المصرية"، إلى "أن الحرب التي جرت بين السادس والرابع والعشرين من أكتوبر عام 1973 لم تكن مجرد حدث استمر حوالي أسبوعين وغيّر الميزان العسكري والأفق السياسي بين مصر (والعرب) من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى، بل صارت لبنة مهمة في تصوّر الشعب المصري عن نفسه، وقيمه، وتحدياته، وقدراته". ووفقًا لما رصده نجيب محفوظ ونقله عنه ريان المشكلة كانت "أن التصور الخاطئ الذي تم ترديده هو أن أكتوبر هي نهاية، لأن الحقيقة هي أن أكتوبر كانت بداية وليست نهاية".
ومن أبرز مشاهد التعامل مع حرب أكتوبر باعتبارها نهاية وليست بداية، ما ترصده نيرة عبد الرحمن في الفصل السادس من كتاب "خمسون عامًا على نصر أكتوبر"، حول ما حل بمدينة السويس بعد انتهاء سنوات التهجير والحرب، قائلةً إن وعود إعادة البناء التي طرحتها الدولة لم تتحقق ... وانتشر الفساد في النصف الثاني من السبعينات وبداية الثمانينات، خاصة في عمليات التعمير.
طه حسين: خمسون عامًا على الجسارة الفكرية
شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب لعامي 2023 و 2024، الاحتفاء بذكرى حرب أكتوبر، واحتفاءً موازيًا بالذكرى الخمسين على رحيل طه حسين، والذي يوافق تاريخ وفاته يوم 28 أكتوبر 1973، أي بعد أربعة أيام من نهاية الحرب. وبهذه المناسبة، صدرت العديد من الكتب، تكريمًا لــ"التنويري الأكبر" و"النهضوي العظيم"، كما تشير إليه الكثير من هذه الإصدارات.
صدر كتاب طه حسين "في الشعر الجاهلي" في مارس عام 1926، والذي وصفه إيهاب الملاح في كتابه "طه حسين: تجديد ذكرى عميد الأدب العربي،"[2] بأنه كتاب مثير للجدل. ولا ينكر الملاح، في كتابه الواقع في أكثر من 300 صفحة، وكذلك كثيرون غيره ممن صدرت لهم مساهمات في ذكرى طه حسين الخمسين، أن الرجل الذي ارتبط اسمه بأنماط مختلفة من الجدل، ما زال حتى بعد مرور نصف قرن على رحيله، يقع في مرمى سهام الدوائر الدينية التقليدية، سواء كانت مؤسسية أو سياسية. الضغوط أجبرت طه حسين على إعادة نشر الكتاب تحت اسم "الأدب الجاهلي" بعد حذف الفصول المثيرة للجدل، والتي وازنت لغويًا بين الشعر الجاهلي واللغويات النصية في القرآن، والذي قال طه حسين إنه لا يمكن أن يكون قد كتب قبل نزول القرآن.
كما يذكر الملاح في كتابه أن طه حسين نُقِل من عمادة كلية الآداب بالجامعة المصرية (التي أصبحت فيما بعد جامعة القاهرة) في مارس 1932، بعد أن جرى انتخابه في وقت أسبق ليتولى مهمة متوسطة في وزارة المعارف، وذلك على خلفية نفس المشاحنات الدينية. ويضيف أنه بعد عام من نقله، واجه حسين تنكيلاً وظيفيًا آخر، قوبل بحالة من المقاومة والدفاع من قبل طلابه ورفاقه، بل حتى من مخالفيه سياسيًا وفكريًا، وعلى رأسهم عباس محمود العقاد. ويؤكد الملاح على أن هذه المقاومة دفعت إلى عدم النيل من طه حسين، سواء قانونيًا في مسار أزمة "في الشعر الجاهلي" أو إداريًا في مسار أزمة عمادة كلية الآداب بجامعة القاهرة، مما أدى إلى عودته إليها ثانية.
تعد انتفاضة أساتذة وطلاب الجامعة دعمًا لطه حسين جزءًا من سياق أوسع من مقاومة الظلم الذي تعرض له. فمن قبلها، انتفض رئيس النيابة محمد نور مدافعًا عن نص حسين " في الشعر الجاهلي"، ومؤكدًا أنه نص في النقد الأدبي ويجب النظر إليه بهذه الصفة، ما أدى إلى حفظ التحقيق في مارس 1927، أي بعد أقل من عام على بداية الأزمة. وجاءت أزمة كتاب طه حسين بعد عام واحد فقط من أزمة مماثلة، كان بطلها أيضًا أزهري التعليم، هو الشيخ علي عبد الرازق، الذي جرى فصله من عمله كقاض شرعي من قبل هيئة كبار العلماء في الأزهر بعد وقت قصير من صدور كتابه "الإسلام وأصول الحكم" في عام 1925.
وقد واجه طه حسين أزمة أخرى في وقتٍ أسبق، بسبب كتابه "ذكرى أبي العلاء"، الذي صدر عن أطروحته التي نال عنها درجة الدكتوراة في عام 1914 من الجامعة المصرية. وقد تمكن الزعيم الوطني سعد زغلول، رئيس الجمعية التشريعية آنذاك، من حل هذه الأزمة بإقناع أحد أعضاء الجمعية الذي اتهم طه حسين بالكفر بناءً على كتابه، بسحب الاتهام الذي جاء مصحوبًا بمطالبة الأزهر والجامعة المصرية بسحب درجاتها العلمية من طه حسين. ويقول الملاح إن سعد زغلول قال لصاحب الدعوى: "إن هكذا اتهام وهكذا مطالب تنال من قيمة الجامعة المصرية والأزهر قبل أن تنال من قيمة طه حسين".
بحسب ما ينقل الملاح عن نجيب محفوظ، كان السياق بعد سنوات من ثورة 1919، هو ما جعل كتابات طه حسين جزءًا من كل ثوري بلا تردد. ولا يفوت أن يذكر أنه بعد أزمة "في الشعر الجاهلي" بثلاثة عقود، اضطر محفوظ، الذي ولد في بداية العقد الثاني من القرن العشرين، أن يحذو حذو طه حسين، المولود عشية العقد الأخير من القرن التاسع عشر، في التعامل مع أزمة روايته "أولاد حارتنا".
يروي الملاح، نقلاً عن محمد سلماوي، أن "المجاسرة" التي أطلقها طه حسين "كانت الثورة الفكرية" التي أثرت في جيل محفوظ ومن بعده جيل سلماوي نفسه. وكما تعرض طه حسين للتشكيك في مدى التزامه العقائدي بالدين الإسلامي، تعرض نجيب محفوظ لهجمات عاتية من الدوائر التي تعامل الإسلام كنص جامد ولا تنظر إليه كما ينظر إليه طه حسين من منظور "العقل والروح والسمو والسماحة... والعدالة الاجتماعية". وهذا ما وضحه طه حسين في كتابيه "على هامش السيرة" و"الوعد الحق". ولا يفوت الملاح ذكر أن زمن طه حسين، وحتى زمن نجيب محفوظ، شهد مساحات من التشدد ومساحات من طرح أفكار مثيرة للجدل، ما سمح لتوفيق الحكيم بنشر مسرحيته "محمد" التي تروي نزول الوحي على نبي الإسلام.
رؤى طه حسين في مقدمات كتب الآخرين
جمع الباحث علي قطب قرابة 80 مقدمة كتبها طه حسين لعدد من الكتب، التي نُشر بعضها باللغة العربية والبعض الآخر باللغة الفرنسية، وذلك في كتاب بعنوان "مقدمات طه حسين" الذي صدر عن بيت الحكمة للثقافة في يناير من العام الجاري. وبحسب ما يشير إليه قطب في مقدمة الكتاب، المكون من قرابة الـ 400 صفحة، فإن الإلمام بمدى التنوير وفتح آفاق التفكير العقلاني الذي ينتمي إليه طه حسين، لم يكن فقط بقراءة ما ورد في كتبه ومقالاته، بل أيضًا من خلال النظر في العناوين التي اختار أن يكتب لها مقدمات، وفيما جاء في هذه المقدمات التي خطت في معظمها في عشرينات القرن الماضي.
ومن ذلك ما يشير إليه طه حسين من ضرورة إنهاء الجهل العام بالتاريخ المصري، ولكنه أيضًا يطرح فكرة تماهي مسار التاريخ المصري مع التاريخ اليوناني. ويصر على الحديث عن حاجة الشرق لتطوير أدوات ومناهج التعليم والنظر إلى الإسلام ليس فقط بوصفه دينًا له شعائر وطقوس، إنما بوصفه منتجًا لحضارة قامت على مساحة جغرافية واسعة جعلت من اللغة العربية، التي هي لغة القرآن، رابطًا حتميًا بين أطراف المنطقة.
وبينما كان الغرض من الاحتفاء بذكرى حرب أكتوبر وذكرى رحيل طه حسين استدعاء لحظة وطنية مشرقة وتكريم قامة فكرية متميزة، طرحتْ عناوينُ ما أُنتج في سياق هاتين المناسبتين نقاشًا تجاوز مجرد الاحتفاء إلى التفكير العميق فيما كان عليه الحال وفيما أصبح.