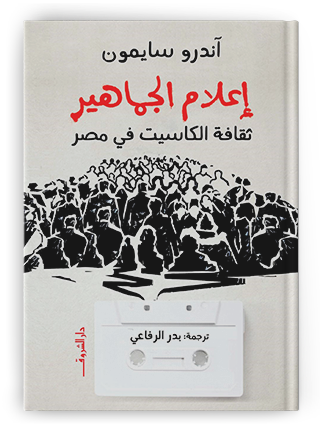يقدّم كتاب "الثقافة والثورة في اليمن" لعبد الله البردوني قراءة فكرية وتاريخية لمسار اليمن الحديث، بوصفه نتاجًا لجدل طويل بين الثقافة والسياسة. يتعامل البردوني مع الثورة بوصفها صيرورة ثقافية تشكّل الوعي الجمعي عبر عقود من التحوّل والصراع. وعبر منهج نقدي، يرسم الكتاب لوحة بانورامية للعلاقة المعقّدة بين المثقف والسلطة، وبين التراث والحداثة، مقدّمًا أحد أهم المفاتيح لفهم جذور التحوّلات في التاريخ اليمني المعاصر.
فوزي الغويدي[1]
يُعدّ كتاب "الثقافة والثورة في اليمن"[2] لعبد الله البردوني وثيقة فكرية وتاريخية استثنائية، تتجاوز في أهميتها رصد مسار اليمن الحديث لتنفذ إلى جوهر التحوّلات الثقافية والسياسية التي أسهمت في تشكيل وعي المجتمع طوال القرن العشرين. في نحو خمسمائة صفحة موزعة على سبعة عشر فصلاً، يقدّم البردوني رؤية شاملة؛ فيبدأ من ملامح الحراك الثوري والثقافي مطلع القرن، مروراً بتجليات العمل الحزبي والسياسي بوجوهه السرية والعلنية، وصولاً إلى المنعطف التاريخي للوحدة عام 1990. وضمن هذا السياق، يتقصى المؤلف أبعاد الثورة تاريخيًا وواقعيًا، كاشفاً عن صلتها الوثيقة بفعل الكتابة، وبالحركة الطلابية، وبمآلات أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر تحت مجهر الأسئلة الجديدة.
أمّا الفصول اللاحقة، فتتجه إلى استقصاء المشهد الثقافي في شموليته، إذ تقف عند جذور الثقافة الحديثة وتطوّراتها الجدلية، وتجارب الشعراء والكتّاب والوجوه الثقافية البارزة. كما تخصّص مساحات لمؤسسات المعرفة والإذاعة واتحاد الأدباء والكتّاب، وللبواكير النقدية والمعالم الكبرى في الثقافة اليمنية، وصولًا إلى قضايا اجتماعية وفنية مثل استخدام القات، والتأليف العلمي، وأطوار الفن الغنائي والنشيد الوطني. وبهذا البناء المتدرّج، لا يغدو الكتاب سجلًا تاريخيًا للأحداث أو الأسماء فحسب، بل مشروعًا ثقافيًا يربط بين الثورة بوصفها فعل تغيير سياسي واجتماعي، والثقافة بوصفها وعيًا جمعيًا ومسارًا طويلًا تشكّل عبر عقود من التحوّل والتجربة.
يرى البردوني في الثورة حصيلة صيرورة ثقافية طويلة ومعقّدة، تتجاوز كونها مجرّد حدث سياسي عابر، مؤكداً على وجود علاقة جدلية يغذي فيها كل طرف الآخر ويعيد تشكيله. وباتكاءٍ على لغة أدبية رفيعة ورؤية نقدية ثاقبة، يمضي القارئ في رحلة عبر منعطفات التاريخ اليمني، مستعرضًا الصراعات الكبرى بين التراث والحداثة، وبين السلطة والمثقف، وصولاً إلى التجاذب بين الهوية الوطنية والولاءات الضيّقة. وفي هذا المسار، لا يكتفي البردوني بسرد الوقائع، وإنما يستنطق النصوص الأدبية، ويحلّل الخطابات السياسية، ويستحضر الشخصيات الفاعلة من شعراء ومفكرين ورجال دين وسياسيين؛ ليقدم لوحة بانورامية غنية بالدلالات، تقرأ التاريخ بعيون ثقافية، وتفهم الثقافة في سياقها التاريخي، مما يمنح العمل عمقًا يندر وجوده في الكتابات التاريخية التقليدية.
ولا ينفصل هذا المنهج عن الموقع الفكري لمؤلفه؛ إذ يمثّل عبد الله البردوني أحد أبرز العقول الأدبية والفكرية في اليمن الحديث، لا باعتباره شاعرًا مجدّدًا فحسب، وهو الوصف الذي اختُزل فيه طويلًا، وإنما برز بوصفه مفكّرًا امتلك رؤية مستقلة للعالم وللثقافة وللوطن. فقد جاءت كتاباته مختلفة عن المألوف في لغتها ومنهجها وزاوية نظرها، متحرّرة من القوالب الجاهزة، ومشحونة بحسّ نقدي ساخر وقدرة لافتة على التقاط المفارقات الكامنة في الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي. وفي هذا السياق يبرز هذا الكتاب، الصادر عن مطبعة الكاتب العربي بدمشق عام 1991، عملًا كاشفًا عن أحد أعمق وجوه مشروعه الفكري؛ إذ يتجاوز تسجيل وقائع ثورة السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر 1962 أو توصيف مظاهرها، ساعيًا إلى تفكيك صلتها بالثقافة والوعي والذاكرة الجمعية.
تسعى هذه المراجعة إلى استكشاف ثلاثة أبعاد جوهرية في هذا العمل الرائد، وهي: المثقف، والسلطة، والثورة؛ بوصفها ركائز أساسية تكشف عن عمق فكر البردوني ورؤيته النقدية. ومن خلال تفكيك هذه المحاور وربطها بالسياق الكلي للكتاب، نطمح إلى إبراز القضايا المركزية والجدليات الفكرية التي يتبناها المؤلف، في محاولة لفتح حوار مع هذا النص الثري، واستلهام رؤاه في قراءة الحاضر اليمني؛ الذي لا يزال يرتدّ في جنباته صدى التحولات التي أرّخ لها البردوني وحللها بعين بصيرة وعقل نافذ.
المثقف والسلطة: جدلية الصراع والتواطؤ
يفتتح البردوني كتابه بتشريح المشهد السياسي والثقافي لليمن في مطلع القرن العشرين، في لحظة ارتبطت بأفول الحكم العثماني وبروز سؤال البديل السياسي. ففي نظره كان الجدل حول الأتراك تعبير مبكر عن تشكّل وعي سياسي هشّ لا مجرد خلاف فقهي أو إداري، واصفًا تلك المرحلة بأنها كانت تمثل "طفولة الوطنية في فجر القرن العشرين".[3] ويكشف هذا الوصف عن إدراكه المبكر لطبيعة العلاقة المتوترة بين السلطة والوعي الناشئ؛ حيث انقسم المجتمع بين قيادة إمامية رأت في الحكم التركي "بغيًا على الحق الإمامي"، وبين فئة أخرى اعتبرت الأتراك "ولاةً مسلمين ارتضاهم المسلمون".[4]
ويلاحظ البردوني أن الموالين للسلطنة العثمانية في تلك العقود لم يكونوا امتدادًا فكريًا للمدافعين عنها في القرن السادس عشر، مثل الموزعي في كتابه "الإحسان في دخول اليمن في ظل عدالة آل عثمان"، ممن شرعنوا الوجود التركي باسم العدل الإسلامي، وإنما كانوا في الغالب منتفعين بمواقع إدارية ووظيفية داخل بنية الحكم، دون رغبة في مواجهة مباشرة مع الإمامة. ولهذا يشير إلى أن هؤلاء "لم يكونوا ورثة مؤرخي العثمانيين، بل أصحاب امتيازات في جهاز الحكم"[5]، مما يبرز ملامح علاقة ملتبسة بين المثقف والسلطة، لا هي معارضة صريحة ولا ولاء كامل، بل حالة تكيّف مع المصالح القائمة.
ومع خروج الأتراك في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين، يرصد البردوني حالة الانفلات الأمني واتساع دائرة التمرد، معتبرًا أن غياب السلطة السابقة، وعجز السلطة اللاحقة (الإمام يحيى) عن تثبيت أركانها، كشف هشاشة البناء السياسي؛ إذ اختلّ الأمن لأن الحكم الأول رحل "ولم يستكمل الحكم التالي أسباب قوته"[6]. وقد أورث هذا الوضع حنينًا لدى بعض النخب إلى زمن الإدارة العثمانية، لا دفاعًا عن الاستبداد بقدر ما هو خوف من الفوضى، حتى إنهم صاروا يتذكرون "الرخاء الذي كان سائدًا في عهد محمود نديم آخر والي عثماني على اليمن".[7]
تتجسد هذه الجدلية أيضًا في موقف المثقفين من القضايا الكبرى، مثل حرب تهامة، حيث انقسمت النخبة بين دعاة الدفاع ودعاة الهجوم. ولم يكن هذا الانقسام عسكريًا محضًا، بل كشف عن رؤى سياسية متباينة؛ فبينما رأى البعض في الحرب وسيلة لتعزيز الهوية الوطنية والاستقلال، خشي آخرون التدخلات الأجنبية، وظل فريق ثالث يترقب مكاسب سياسية ضيقة. وفي خضم ذلك، بدا المثقف اليمني ممزقًا بين ولاءات متعددة، مترددًا بين مقتضيات الوطنية وحسابات السلطة ومخاوف التدخل الخارجي.
ضمن هذا السياق تتبلور مواقف الإصلاحيين، الذين لم يواجهوا السلطة مواجهة سياسية مباشرة، بل عبّروا عن اعتراضهم بلغة دينية وأخلاقية عبر الشعر والخطاب الوعظي. فقد انصبّ نقدهم على الاستبداد الفردي وعلى الاستنزاف المالي باسم الزكاة، وهو ما يرصده البردوني في قصائد المؤرخ محمد بن محمد زبارة وأحمد الوريث وعلي يحيى الإرياني. ويحلل قصيدة زبارة التي استهلها بقوله:
تناهوا تناهوا عن عموم التظالم وتهوين أمر الظلم عن كل ظالم[8]
كما يتوقف عند قصيدة الوريث بوصفها استجابة مباشرة لها، في حين يرى أن قصيدة الإرياني تمثّل طورًا أرقى من حيث الحس الاجتماعي، لأنها عبّرت عن الضيق الاقتصادي وكثرة الهجرة، وكانت، بحسب تعبيره، "عمر بالهم الشعبي" والشعري والتي بدأ مطلعها بقوله:
قف للخليفة موقف النصّاح لا موقف الشاني له واللاحي[9]
ويميز البردوني بين خطابين داخل هذا الشعر الإصلاحي؛ خطاب ديني تحريضي عند زبارة والوريث، وخطاب أكثر تركيبًا عند الإرياني، الذي جمع بين الوعي الاجتماعي والتمكن الشعري والمعرفة الفقهية والأدبية. وهنا يظهر الشعر بوصفه وسيلة المثقف للاحتجاج الأخلاقي على السلطة، حين تغيب أدوات السياسة المباشرة.
ويمتد هذا التوتر إلى مجال النقد الأدبي، حيث يشير البردوني إلى أن الطلائع الثقافية في تلك المرحلة كانت تتوق إلى الشعر الأجود بغض النظر عن موضوعه، كما تتطلع إلى نقد صارم يهزّ السائد، متأثرة بكتب مثل "الديوان" لعباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني الذين نقدا أحمد شوقي وحافظ إبراهيم و"على السّفود" لمصطفى صادق لرافعي في نقد العقاد. غير أن ردّ الفعل المحافظ تجسّد في موقف أستاذ الأدب بدار العلوم بصنعاء علي عقبات في تلك الفترة، الذي أجاب عن سؤال حول كتاب الديوان للعقاد بالنصيحة بالرجوع إلى نهج البلاغة وديوان المتنبي ومقامات الحريري[10]. ويكشف هذا الموقف عن صراع آخر بين سلطة التراث وسلطة النقد الجديد، في صورة موازية للصراع بين المثقف والسلطة السياسية.
ولا يحصر البردوني هذه الجدلية في السياق اليمني وحده، بل يربطها بأفق عربي وإسلامي أوسع، مستدعيًا نماذج تاريخية مثل أبي ذر الغفاري في احتجاجه على سياسات عثمان بن عفان، ليؤكد أن الصراع بين المثقف والسلطة ليس طارئًا، وإنما ممتد في التراث الإسلامي ذاته. وفي هذا الإطار تغدو قصائد الشعراء نصيحة واجبة لولي الأمر، وصوتًا أخلاقيًا يعبّر عن ضمير الجماعة.
من خلال هذه القراءة المركبة، يقدم البردوني صورة غير تبسيطية للمثقف اليمني؛ إذ يتجاوز في تصويره ملامح البطل الثوري المثالي أو الضحية الصامتة، ليظهره في هيئة فاعل تاريخي معقّد، تتجاذبه الولاءات المتناقضة، وتتحكم في مواقفه اعتبارات دينية واجتماعية وسياسية متداخلة. لكنه، ومع كل هذا التعقيد، يظل عنصرًا لا يمكن تجاوزه في فهم تشكّل الدولة اليمنية الحديثة، ومسار الصراع بين الثقافة والسلطة في تاريخها المعاصر.
صراع الأفكار: بين التجديد والتقليد
لا يقلّ صراع الأفكار في مشروع البردوني الفكري أهمية عن صراع السياسة؛ إذ يرى أن الثورة الحقيقية تبدأ في الوعي قبل أن تتحقق في الواقع، وأي تغيير سياسي لا بد أن تسبقه تحوّلات عميقة في منظومة القيم والرؤى. ومن هذا المنطلق، يولي في كتابه اهتمامًا واسعًا بالجدليات الفكرية التي شهدها اليمن في القرن العشرين، ولا سيما الجدلية بين التجديد والتقليد، وبين الأصالة والمعاصرة. وتتجسد هذه الجدلية بوضوح في استشهاده بقصيدة أحمد بن أحمد الوريث التي يقول فيها:
أفقنا أفقنا بعد طول سباتنا
فها نحن نسعى في نموّ التفاهم
عسى أن نرى الأفكار تنهض نهضة
تعيد لنا من مجدنا المتقادم[11]
تختصر هذه الأبيات، في قراءة البردوني، حلم النهضة لدى النخبة اليمنية؛ ذاك التوق للخروج من السبات التاريخي مع التشبث في الوقت نفسه بـ "المجد المتقادم". إنها معادلة صعبة تجمع بين نزعة التغيير وهاجس المحافظة، مما أبقى المثقف اليمني يتأرجح طويلًا بين استلهام الماضي والبحث عن أفق جديد.
وتتعمق هذه الجدلية في نقاشه حول مصادر الثقافة، إذ ينتقد اعتماد بعض المثقفين على مرجعيات تقليدية خالصة مثل نهج البلاغة وديوان المتنبي ومقامات الحريري، ويرى في ذلك مظهرًا من مظاهر الانغلاق الثقافي، داعيًا إلى "اختيار ثقافي وتجريبي" يرتكز على الدراسة الموضوعية وبعد النظر. غير أن هذا الانفتاح في تصوره يتجاوز فكرة الارتماء في أحضان التغريب، ليصبح انطلاقًا من الواقع المحلي واستلهامًا للتراث الوطني، وهو ما يفسر احتفاءه بالشعر الشعبي والأشكال الثقافية المحلية بوصفها تعبيرًا عن روح المجتمع وأصالته.
ويعرض البردوني مثالًا دالًا على هذا الصراع من خلال الجدل حول مكانة أحمد شوقي في اليمن في أربعينيات القرن العشرين، حيث انقسموا إلى ثلاث تيارات: من يراه بعد المتنبي، ومن يفضّله عليه، وتيار سلفي يراه "مبتدعًا في الدين والأدب"، كما في كتاب حسن السقاف "النقد الذوقي في تكفير شوقي". ويحلل البردوني هذا النقد مبينًا أن السقاف لم يفطن إلى التشبيه في بيت شوقي: دمشق روح وجنات وريحان، ما يكشف، في رأيه، عن قصور في التذوق الفني لا عن غيرة دينية خالصة. في إشارة إلى ذهنية تقليدية تحاكم الشعر والفن بمعايير فقهية ضيقة، وتنظر إلى الإبداع بعين الريبة. وفي المقابل، يدافع عن شوقي بوصفه امتدادًا للشعر العربي الأصيل، لكنه امتداد متجدد، لا يقوم على القطيعة مع التراث، وإنما على استلهام روحه الخلّاقة.[12]
ثم ينتقل إلى نقد العقاد لشوقي في كتاب "الديوان"، الذي انصبّ على ثلاثة محاور: وحدة القصيدة، والتشبيه، واتباع القدماء إلى حد المحاكاة. غير أن البردوني يشكك في دوافع هذا النقد، متسائلًا إن كان صادرًا عن مشروع أدبي فعلي أم عن حسد خفي، كما يتوقف عند كتاب الرافعي "تحت راية القرآن" ردًا على طه حسين، و"على السفود" في نقد العقاد، ويرى أن هذه الكتب، رغم أهميتها، كانت عند المثقفين الذين توسعت معارفهم "رديئات المُجيدين". ويمتد صراع الأفكار إلى المجال السياسي، حيث يبيّن البردوني أن الأدب كان غطاءً للنشاط السياسي السري؛ فقد تحوّل طلاب دار العلوم إلى جنود في انقلاب 1948، وظل الشعر نشاطًا علنيًا يوازي العمل السياسي الخفي[13]. وهكذا، يرسم البردوني صورة لصراع فكري متعدد الأبعاد، يتجاوز الثنائية السطحية بين الدين والعلمانية أو الشرق والغرب، ليغوص في التمايزات داخل هذه الثنائيات نفسها؛ بين دين تقليدي وآخر مستنير، وبين غرب استعماري وآخر إنساني. والمثقف الحقيقي، في هذا التصوّر، هو من يمتلك القدرة على التمييز والنقد، وبلورة مشروع يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين الانتماء للهوية والانفتاح على الآخر.
الثورة والسياسة: دروب وعرة نحو التغيير
إذا كانت الثقافة تمثل في كتاب البردوني الحقل الأوسع للصراع، فإن السياسة تتجلى فيه بوصفها الساحة الأكثر توترًا وتعقيدًا؛ إذ يرصد الكتاب الحركات الثورية والحزبية في اليمن خلال القرن العشرين، مفككًا بنيتها الفكرية والتنظيمية، ومبرزًا ما شابها من تناقضات داخلية وارتهانات خارجية[14]. ويولي البردوني اهتمامًا خاصًا بثورة 1948، التي يتجاوز في رؤيته لها التوصيف الضيق بكونها "انقلابًا عسكريًا"، ليراها ثمرة حراك سياسي وثقافي سابق، تعثر بسبب غياب البرنامج النظري الواضح، واعتماد الفاعلين على الذكريات الشخصية عوضًا عن التحليل الموضوعي.[15]
ويمتد نقده إلى الثقافة الحزبية ذاتها، التي يراها انعكاسًا للبنية الاجتماعية العامة، حيث سهولة تشكيل الأحزاب تقابلها صعوبة الحفاظ على نقائها واستقلالها، كما يكشف عن التناقض بين ظاهر السلطة في محاربة الحزبية وباطنها في توظيفها. وفي تحليله للثورة اليمنية، يؤكد البردوني أنها لم تتفجر من فراغ، وإنما كانت تعبيرًا عن تراكم ثقافي واجتماعي سابق، وأن أهدافها الكبرى، من التحرر وبناء الجيش الوطني ورفع مستوى الشعب إلى الديمقراطية والوحدة، اصطدمت بواقع الحروب والانقسامات والصراعات الداخلية.[16]
ولا يقف تحليله عند اليمن وحده، بل يربط التجربة اليمنية بمسار الثورات العربية والعالمية، مبرزًا كيف تتشابه الثورات في لحظات اندفاعها، وتفترق في مصائرها، من الثورة الفرنسية إلى الثورة الروسية وثورات الخمسينيات والستينيات في العالم العربي[17]. وبناءً على هذه الرؤية الشمولية، يقدم البردوني قراءة سياسية لا تنشغل بالتمجيد أو الإدانة، بل تنصرف إلى تفكيك الشروط التاريخية والحدود الواقعية للفعل الثوري، واضعةً إياه ضمن سياق أوسع من صراع الإرادات؛ حيث يظل التغيير طريقاً وعراً تحفه التناقضات أكثر مما تقوده الشعارات.
[1]تعبّر وجهات النظر الواردة في هذا النص عن آراء كاتبها، ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر منصة "الصالون".
فوزي الغويدي باحث مختص في التاريخ الحديث والمعاصر للخليج العربي واليمن، يعمل حالياً زميل زائر في مجلس الشرق الأوسط.
[2] عبدالله البردوني، الثقافة والثورة في اليمن (دمشق: مطبعة الكاتب العربي، 1991).
[3] البردوني، الثقافة والثورة في اليمن، ص8
[4] المرجع نفسه.
[5] البردوني، الثقافة والثورة في اليمن، ص9
[6] المرجع نفسه.
[7]البردوني، الثقافة والثورة في اليمن، ص10
[8] البردوني، الثقافة والثورة في اليمن، ص11
[9] المرجع نفسه.
[10] البردوني، الثقافة والثورة في اليمن، ص13
[11] البردوني، الثقافة والثورة في اليمن، ص11
[12]البردوني، الثقافة والثورة في اليمن، ص15
[13] البردوني، الثقافة والثورة في اليمن، ص18
[14]البردوني، الثقافة والثورة في اليمن، ص38
[15]البردوني، الثقافة والثورة في اليمن، ص46
[16]البردوني، الثقافة والثورة في اليمن،ص 66
[17] البردوني، الثقافة والثورة في اليمن، ص128